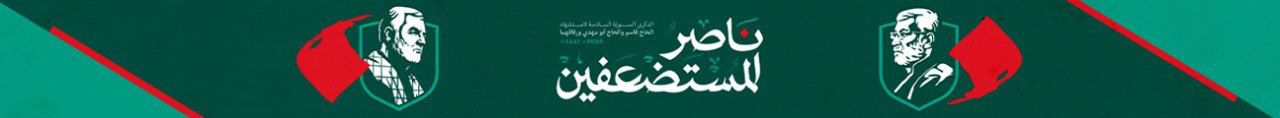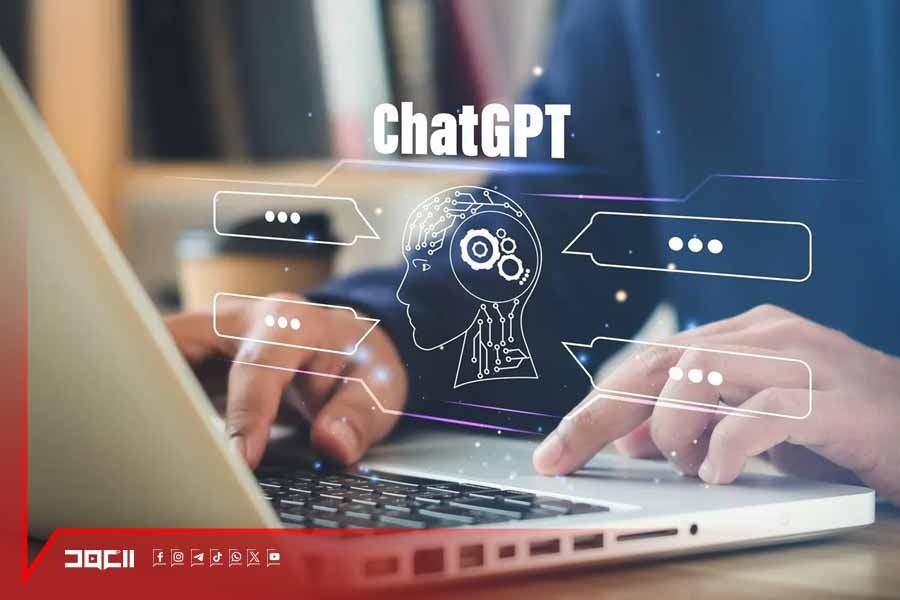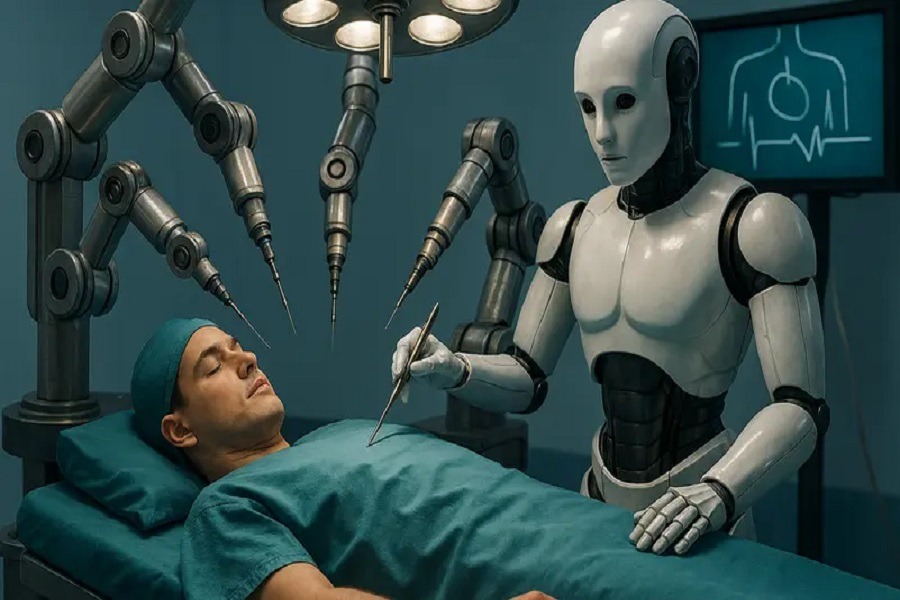تكنولوجيا
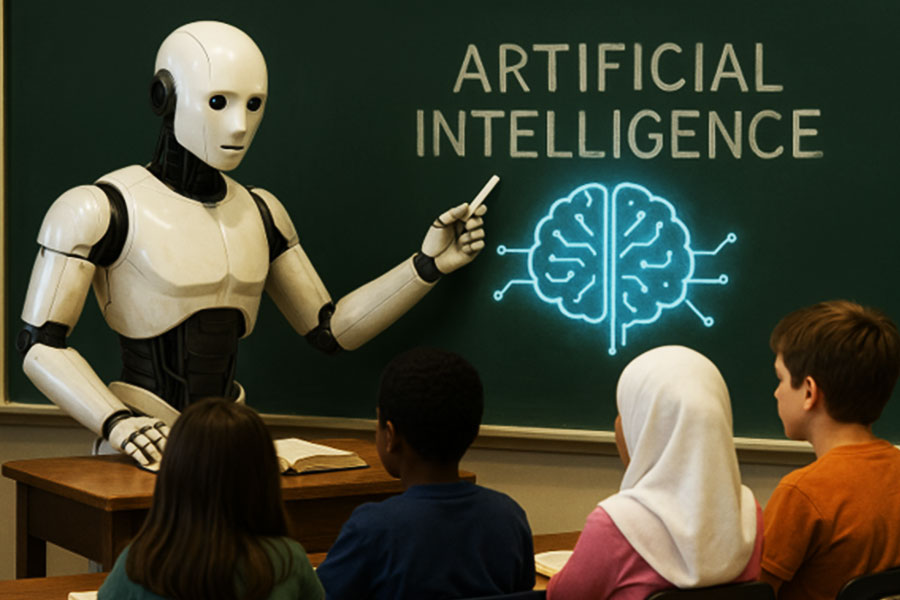
أستاذ جامعي وباحث في الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات، أُعنى بنشر المعرفة وتبسيط مفاهيم التكنولوجيا بلغةٍ سهلة تُناسب الجميع.
أكتب لأجعل التقنية مفهومة وآمنة في حياتنا اليومية، ولأساهم في بناء وعي رقمي مسؤول.
في عصر تتسارع فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي، لم يعد السؤال عن الوصول إلى الإنترنت أو امتلاك الأجهزة هو التحدي الأكبر. لقد تجاوزنا تلك المرحلة، وصرنا نواجه سؤالًا أكثر عمقًا: هل نحن فقط مستهلكون لهذه التقنية، أم قادرون على إنتاجها بما يتلاءم مع هويتنا الثقافية والدينية؟
ما يُعرف بالفجوة الرقمية لم يعد مقتصرًا على من يملك الإنترنت ومن لا يملكه. بل ظهرت فجوة جديدة أخطر: الفجوة في إنتاج المعرفة الرقمية. العالم اليوم لا يكتفي باستخدام الذكاء الاصطناعي، بل يصنعه، ويغرس فيه قيمه، وأولوياته، ومنظوره للحياة. ومن لا يشارك في هذا الإنتاج، يصبح تابعًا لمنظومات لا تعكس مجتمعه أو ثقافته أو حتى احتياجاته.
فالذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة تقنية، بل منظومة معرفية تحمل في طيَّاتها تصوُّرًا للعالم. وهذا ما يثير القلق، حين تُستورد تقنيات جاهزة من بيئات ثقافية مغايرة وتُطبَّق مباشرة في التعليم، والإعلام، والعدالة، دون فحص أو تكييف محلي.
يعتمد الذكاء الاصطناعي على البيانات. وإذا كانت البيانات التي يتغذى بها خالية من السياق الثقافي أو الديني المحلي، فإن النتائج تكون منحازة أو غير مناسبة. فمحركات البحث، على سبيل المثال، قد تُظهر محتويات لا تنسجم مع قيم المجتمع العربي أو الإسلامي، فقط لأن الخوارزمية صُممت بناءً على أولويات مجتمعات أخرى.
كما أظهرت التجارب، فإن نتائج البحث ليست محايدة، بل تحمل طابعًا ثقافيًّا يعكس الجهة التي طوَّرت النظام. وهذا يؤكد ضرورة امتلاك أدواتنا الرقمية الخاصة.
لكن، كيف نتحول من الاستهلاك إلى الإنتاج؟ الجواب يبدأ من المدارس والجامعات.
إن تطوير مناهج تعليمية تُدرّس مبادئ الذكاء الاصطناعي، وأخلاقياته، وأساليب استخدامه لحل مشكلات حقيقية في المجتمع، هو الخطوة الأولى نحو الردم الحقيقي للفجوة الرقمية.
لا يكفي أن نعلِّم الطلاب البرمجة كمهارة تقنية، بل يجب أن نربطها بالسياق المحلي: كيف نصمم تطبيقًا يحل مشكلة بيئية في الحي؟ كيف نبني أداة لمساعدة كبار السن؟ كيف ننتج مساعدًا ذكيًّا يتحدث العربية ويُراعي القيم الإسلامية؟
وتشير الأبحاث حول تعليم الذكاء الاصطناعي للأطفال، إلى أن "الدمج المبكر لمفاهيم الذكاء الاصطناعي في التعليم يساعد على بناء جيل يفهم التقنية بعمق، ويستطيع توجيهها أخلاقيًّا." وهو ما نفتقده اليوم في العديد من أنظمتنا التعليمية.
حين نُعلِّم طلابنا كيف يصنعون أدواتهم الرقمية، فإننا لا نمنحهم وظيفة مستقبلية فحسب، بل نمكِّنهم من حل مشاكل مجتمعهم بأنفسهم. الذكاء الاصطناعي يمكن أن يخدم التعليم، والزراعة، والصحة، والحفاظ على التراث، إذا صُمِّم من أبناء البيئة نفسها، لا من شركات بعيدة عنها.
التقنيات المحلية التي تراعي الهُوية الدينية والثقافية ليست رفاهية، بل ضرورة لبناء مجتمعات تتفاعل إيجابيًّا مع التكنولوجيا، وتُسخِّرها في تحقيق أهدافها، لا أن تُستخدم ضدها أو تُفقدها استقلالها المعرفي والثقافي.
لكي نردم الفجوة الرقمية في عصر الذكاء الاصطناعي، نحتاج إلى:
● دمج الذكاء الاصطناعي في المناهج التعليمية بشكل مبكر وتدريجي.
● تشجيع المشاريع الطلابية التي توظف الذكاء الاصطناعي لحل مشكلات محلية.
● تمويل الأبحاث والابتكارات التي تُنتج تقنيات عربية وإسلامية تراعي الهُوية.
● بناء تحالفات بين الجامعات، والمجتمع المدني، والقطاع التقني لتطوير محتوى رقمي نزيه ومتجذر ثقافيًّا.
● إنشاء حاضنات أعمال للذكاء الاصطناعي في الجامعات والمعاهد، مخصصة لدعم الحلول ذات الطابع المحلي.
الذكاء الاصطناعي ليس قدرًا محتومًا، بل فرصة يمكننا استثمارها لبناء واقع رقمي يعكس قيمنا ويخدم مجتمعاتنا. لكن هذه الفرصة لن تتحقق إلا إذا خرجنا من دائرة الاستهلاك، ودخلنا بقوة إلى ميدان الإنتاج. التعليم هو المفتاح، والهُوية هي البوصلة، والتكنولوجيا ليست هدفًا، بل وسيلة لنهضة الإنسان.