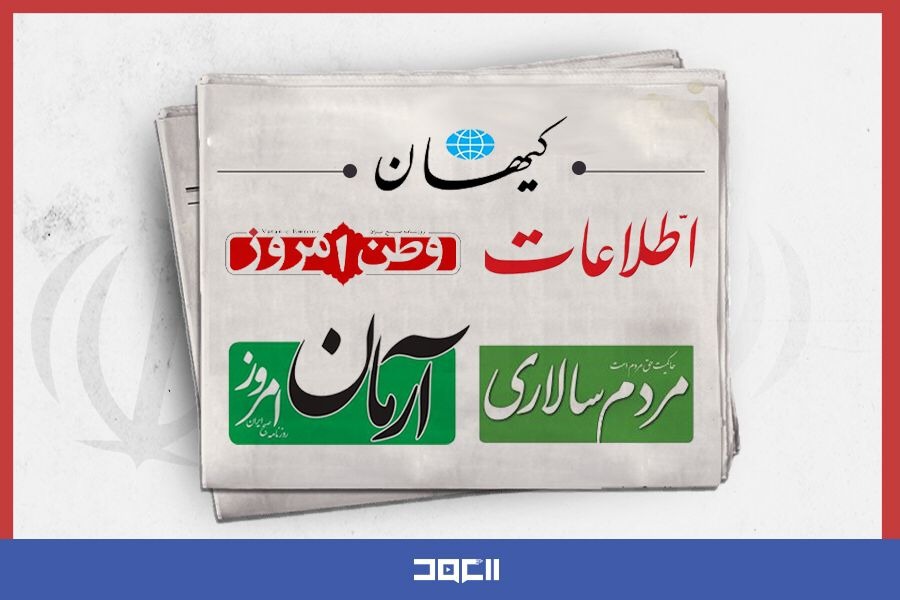إيران

اهتمّت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم السبت 12 تموز بأهمّ الأحداث الإقليمية والدولية ولاسيما قضية الحرب الأوكرانية، وتراجع مساعي ترامب لإنهاء الصراع فيها.
كما اهتمّت بقضية التماسك الإيراني الداخلي حول استراتيجية دعم المقاومة وآثارها.
جبهة المقاومة وفّرت القدرة على فرض تكاليف متصاعدة على العدو
بداية مع صحيفة "وطن أمروز" التي كتبت "في إطار أدبيات الواقعية السياسية، يعتمد الأمن القومي لكل دولة على بنية معقدة من القوة المادية والتماسك الاجتماعي وقدرات الردع العابرة للحدود الوطنية. تُدرك إيران، بصفتها لاعبًا مهمًا في المعادلات الجيوسياسية لغرب آسيا، جيدًا أن الأمن في بيئة إقليمية مضطربة هو وظيفة القوة الموضوعية والإرادة العملياتية على الساحة، بدلاً من أن يكون نتاجًا لاتفاقيات رسمية أو ترتيبات قانونية. ومع ذلك، بالإضافة إلى تعزيز القدرات الدفاعية، وخاصةً نجاح برنامج الدفاع الصاروخي، فإن ما برز كعلامة مميزة لسياسة الردع للجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه المرحلة التاريخية هو الاستراتيجية الكبرى لبناء وتعزيز جبهة المقاومة. ويستند هذا التحالف الإقليمي إلى مفهوم أمني شامل لا تُعتبر فيه الحدود الوطنية مجرد خطوط جغرافية مقيدة، بل امتدادات للطبقات الجيوسياسية والاستراتيجية للبلاد. جبهة المقاومة ثمرة مخطط شامل وتقارب أيديولوجي-أمني بين مختلف أطراف المنطقة، بما في ذلك إيران والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين واليمن وبعض الجماعات في الدول الإسلامية. هذا المخطط ليس إجراءً قصير المدى أو رد فعل قطاعي، بل هو نتيجة منطق استراتيجي بعيد المدى، يُضعف العمق الاستراتيجي للعدو، وفي الوقت نفسه، يُوسّع مساحة المناورة لإيران في المنطقة.
ورأت الصحيفة أنه "خلال الحرب الأخيرة، أدرك المجتمع الإيراني بموضوعية ووضوح اهمية وجود هذه الجبهة في تعزيز الردع الوطني. وقد وفّرت جبهة المقاومة، باعتبارها نظامًا أمنيًا إقليميًا، القدرة على فرض تكاليف متصاعدة على العدو بشكل غير مسبوق. وكما ورد مرارًا في تصريحات المسؤولين الصهاينة، بمن فيهم رئيس وزراء النظام، فإن التهديد الموجه لإيران، مركز ثقل المقاومة، لن يكون عمليًا إلا بعد احتواء حلفاءها الإقليميين. يُعد هذا الاعتراف أوضح دليل على فعالية استراتيجية طهران الشاملة في تعزيز جبهة المقاومة".
وتابعت "على مدار العقدين الماضيين، وفي جميع عمليات التفاوض، أصرت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون دائمًا على إعادة النظر في سياسات إيران الإقليمية ووقف دعم المقاومة كمطلب دائم. لم يكن هذا المطلب قاعدة أخلاقية أو قانونية، بل كان قائمًا على منطق الواقعية السياسية الغربية بهدف تدمير البنية التحتية للردع خارج حدود إيران. تؤكد الأدلة الميدانية من الحرب الأخيرة أنه في حالة وقوع هجوم واسع النطاق، لا تعتمد إيران فقط على قدراتها المحلية مثل القوة الصاروخية والأسطول البحري والروافع الجيوسياسية مثل التأثير على تدفق الطاقة في المنطقة، بل تستفيد أيضًا من شبكة المقاومة كدرع متعدد الأطراف. بعد هجوم إيران على القاعدة الأمريكية في العديد بقطر، وُجهت رسالة واضحة إلى جميع الجهات الفاعلة الإقليمية والخارجية: أي عدوان من طرف ثالث سيُفعّل جميع قدرات إيران والمقاومة، وسيجلب في الوقت نفسه الجهات الفاعلة غير الحكومية والحكومية المتحالفة إلى ساحة المعركة. إن توقف الحرب في تلك اللحظة بالذات، وبالتحديد في اللحظة التي كانت هناك فيها إمكانية للتصعيد إلى صراع إقليمي واسع النطاق، يوضح الوظيفة الحيوية لهذه القدرات، فضلاً عن الشبكة الأيديولوجية العسكرية".
وأضافت "لقد أصبحت هذه الحقيقة الجوهرية ملموسةً بوضوح للمجتمع الإيراني اليوم. بمعنى آخر، أدرك المجتمع الإيراني أن الأمن المستدام يتطلب دفاعًا استباقيًا عميقًا ومواجهة فعّالة للتهديدات من مصادرها. وأصبح استمرار جبهة المقاومة وتعزيزها ومأسستها مطلبًا اجتماعيًا نابعًا من عمق التجربة المعيشية والفهم الموضوعي للمواطنين. في غضون ذلك، فقدت مواقف بعض التيارات الداخلية التي اتخذت شعارات ديماغوجية مثل (لا غزة، لا لبنان) أو (اتركوا سوريا، فكروا فينا) مكانتها، وسعت إلى إضعاف استراتيجية إيران الإقليمية، مصداقيتها اليوم أكثر من أي وقت مضى".
معركة الـ12 يومًا: خريطة مستقبل العلاقات في غرب آسيا
بدورها، كتبت صحيفة "قدس": "للوهلة الأولى، قد يرى كثيرون أن جذور حرب الأيام الاثني عشر تكمن في التطورات السياسية والعسكرية خلال العامين الأخيرين بعد عملية طوفان الأقصى أو في المواجهة الوجودية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والنظام الصهيوني.
وقالت "من الجليّ أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، منذ البداية وحتى قبل انتصار الثورة، قد عرّفت معارضة النظام الصهيوني كجزء من هويتها السياسية في مواقف قادتها، بمن فيهم الإمام الخميني الراحل (قده). ومع ذلك، وبغض النظر عن الأبعاد السياسية والأيديولوجية، ولأسباب اقتصادية وجيوسياسية، فقد واجهنا في السنوات القليلة الماضية تنافسًا وصراعًا واضحين في المنطقة، حيث تقف إيران والكيان الصهيوني على طرفي نقيض. وكان التنافس على الممرات البحرية من أهم المحاور التي شكلت العلاقات الاقتصادية والسياسية العالمية في العقد الماضي.
يمر أكثر من 80% من التجارة العالمية عبر البحر، ولسنوات طويلة، كانت الطرق البحرية هي الطريق التجاري الرئيسي نظرًا لعموميتها وقلة التدخل العسكري فيها. ومع ذلك، ولأن بعض الدول، ومنها الصين، شعرت بأنها قد تواجه عقبات سياسية وعسكرية على الطرق البحرية أو تتعرض للتهديد بسبب اعتمادها المفرط على هذه الطرق البحرية، فقد اقترحت فكرة إحياء التجارة عبر الطرق البرية وإنشاء ممرات. وبناءً على ذلك، سعت إلى تطوير الطرق البرية من الصين إلى آسيا الوسطى وغرب آسيا وأوروبا وأفريقيا".
ووفقًا لبعض الخبراء، تنقل الصحيفة، فإن الممر ليس مجرد طريق، بل إنه، تحت ستار تصميم طرق نقل غير بحرية، يخلق منصة للاستثمار في البلدان المستهدفة والتعاون الاقتصادي والسياسي وتشكيل علاقات دولية جديدة.
ومن الطبيعي أن تسعى الولايات المتحدة، بصفتها المنافس الرئيسي للصين في العلاقات العالمية والمنافسة بين القوى العظمى الاقتصادية، إلى تشكيل مسارات موازية لإضعاف الممرات التي تساعد الصين".
وبحسب الصحيفة، تشير أدلة عديدة إلى غياب إرادة متماسكة لدى هيئة صنع القرار الإيرانية لتحديد علاقات طويلة الأمد واستراتيجية وغير انتهازية مع الصين. من ناحية أخرى، يُظهر سلوك الصين أنها تطبق تدريجيًا أدواتها في إطار القواعد الدولية ودون ضجة أو دعاية، قدر الإمكان، ولا تتدخل كثيرًا في الهياكل الدولية.
لذلك، ليس من المتوقع بالضرورة أن تتشكل روابط التعاون مع الصين بشكل صاخب وفي أكثر الحالات حساسية، ولكن على الأقل يمكن الحكم على أن إيران لم تتخذ الخطوات اللازمة لبناء علاقة طويلة الأمد قائمة على المصالح الجيوسياسية والتنموية المشتركة. إذا صحت الفرضية المقترحة، فإن هزيمة إيران تُمثل خسارة استراتيجية للصين، وبالتالي يبدو أن بقاء إيران ذو أهمية استراتيجية للصين.
وأردفت "على أي حال، وبناءً على هذه التفسيرات، يبدو أن احتواء هذا التطور مسألة استراتيجية للولايات المتحدة، لأنه يُلغي وسائل الحفاظ على هيمنتها، كما أن دولًا مثل الإمارات وتركيا والسعودية تفقد مزاياها الاستراتيجية،
من ناحية أخرى، تُنفَّذ خريطة الشرق الأوسط الجديدة بتدخل صارم من النظام الصهيوني. إضافةً إلى ذلك، أصبحت اعتبارات نتنياهو الشخصية سببًا إضافيًا لتسريع هذه الخطة. في هذه الخريطة الجديدة، القضية الرئيسية هي إيران، وليست الجمهورية الإسلامية. ويفترض النظام الصهيوني والولايات المتحدة أن تعاني إيران من دولة فاشلة وتابعة، أو على وشك التفكك، أو أجزاء مهمة منها لا تستطيع الحكومة المركزية السيطرة عليها. وبناءً على هذا الافتراض، يُطرح السؤال المهم: ما هي مساهمة إيران في التفاوض على صفقة واتفاق في المفاوضات القادمة المحتملة مع الولايات المتحدة؟ هل التخلي عن القدرات النووية والصاروخية، والانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم، وفتح سفارة، أمرٌ مهم مقارنةً بالقيمة الاستراتيجية للحفاظ على الهيمة على المنطقة بالنسبة للولايات المتحدة؟".
عودة ترامب إلى صيغة بايدن في أوكرانيا
من جهتها، كتبت صحيفة "رسالت": "داب ترامب على إصدار تهديدات صريحة وواضحة ضد روسيا من البيت الأبيض في الأيام الأخيرة. ويبدو أنه بعد قمة لاهاي الأخيرة، التي اتفق فيها أعضاء الناتو على تخصيص 5% من ناتجهم المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي المشترك، يتخذ الرئيس الأمريكي موقفًا أكثر صرامة تجاه موسكو. وخلال حملة الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024، أكد ترامب أنه لو كان على رأس المعادلتين السياسية والتنفيذية في واشنطن، لأنهى الحرب في أوكرانيا خلال 24 ساعة. بل أكد أنه سيستغل علاقاته الودية مع بوتين إلى أقصى حد في هذا الصدد. علاوة على ذلك، أكد ترامب أنه سيضع حدًا لنهج إدارة بايدن غير البناء تجاه التدخل في الحرب في أوكرانيا وتخصيص أموال دافعي الضرائب الأمريكيين للحرب بين روسيا وحلف الناتو. لكن ترامب يُعرب الآن رسميًا عن خيبة أمله من التوصل إلى وقف إطلاق النار بين موسكو وكييف".
وأضافت "عند هذا الحد! بعد أيام قليلة من إصداره أمرًا بوقف تسليم أسلحة حيوية إلى أوكرانيا، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة يجب أن ترسل المزيد من الأسلحة إلى هذا البلد. تُمثّل تصريحات ترامب تحوّلًا مفاجئًا في موقفه، حيث أعلن البنتاغون الأسبوع الماضي أنه لن يُسلّم بعض صواريخ الدفاع الجوي والذخائر المُوجّهة وأسلحة أخرى إلى أوكرانيا بسبب مخاوف من نفاد مخزونات الأسلحة الأمريكية.
قد تعكس مواقف ترامب الأخيرة خيبة أمله من وقف إطلاق النار في حرب أوكرانيا، ومن جهة أخرى، استجابة فورية لامتثال أعضاء الناتو لمطالب واشنطن الاقتصادية والأمنية".
الواضح، وفق الصحيفة نفسها، أن البيت الأبيض يعتمد نفس الصيغة التي يستخدمها الديمقراطيون ونموذجهم الاستراتيجي تجاه الحرب في أوكرانيا، وهذه القضية تُمثّل رمزًا لعجز ترامب عن حلّ إحدى أهم مشاكل واشنطن التي خلقتها بنفسها.
تشير بعض المصادر الأمريكية أيضًا، كما تتابع الصحيفة، إلى أن رحيل إيلون ماسك عن إدارة ترامب، بصفته حلقة الوصل الرئيسية بين البيت الأبيض والكرملين، لعب دورًا هامًا في تصعيد التوترات وتهديدات واشنطن لموسكو. ومع ذلك، لا يمكن أن يكون هذا الافتراض صحيحًا تمامًا! حتى قبل الخلافات الأخيرة بين إيلون ماسك وترامب، شهدنا عجز إدارة ترامب التام عن حل العقبات والجمود الذي نشأ في طريق وقف إطلاق النار في الحرب الأوكرانية.
وأشارت في الختام الى أن الكرملين يُشدد على ضرورة حصوله على ضمانات استراتيجية واسعة من الناتو لإنهاء الحرب الأوكرانية، بينما يحاول ترامب حصر الحرب الأوكرانية في روسيا وأوكرانيا (وليس روسيا والناتو). من المؤكد أن الضمانات الوطنية التي تقدمها كييف لا تضمن المخاوف الاستراتيجية لبوتين بشأن أمن روسيا في المناطق المحيطة."