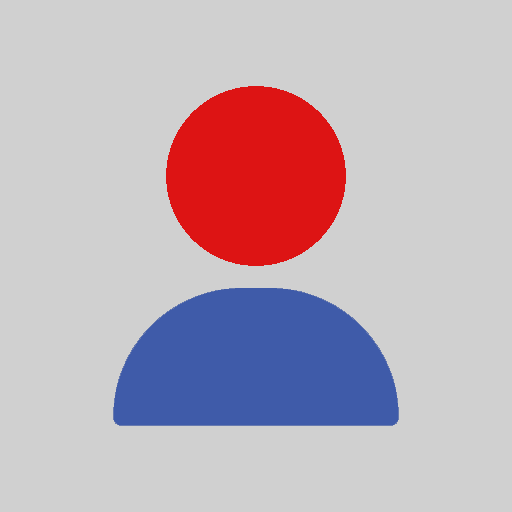مقالات

مع التأكيد على ضرورة التمييز بين الاحتجاجات الشرعية وبين من رأى فيها فرصة للدخول على خط المحتجين، في الداخل والخارج، لا تُقرأ الأحداث الأخيرة في إيران بمعزل عن شبكة الضغوط الخارجية التي أحاطت بالاقتصاد والسياسة معًا، ولا عن محاولات توظيفها ضمن مسارٍ أوسع لتعديل سلوك النظام أو استنزافه. بيد أنَّ الجديد في هذه الجولة ليس الاحتجاج بحد ذاته، بل الهندسة السياسية التي تسعى إلى مواكبة الاحتجاج وتغذيته وتوظيفه، وإلى إيهام الفاعلين الداخليين بوجود مظلّة خارجية قادرة — أو راغبة — في حمايتهم. في هذا المشهد، لا تكتفي واشنطن بالمراقبة، فيما تل أبيب تتابع بدقة اتجاهات المسار وحدوده، وتسأل السؤال الأهم: إلى أين يمكن أن يصل، وبأي كلفة، وعلى من؟
تتقدّم الاحتجاجات على خلفية أزمة مالية – اقتصادية خانقة تتحمّل الولايات المتحدة مسؤولية مباشرة في صناعتها عبر العقوبات وخنق الموارد. الرهان الأميركي أن يتحول الضيق المعيشي إلى رافعة احتجاج ذاتي تُنتج داخليًا ما عجزت الضغوط الخارجية وحدها عن فرضه. من هنا، تُقدَّم الاحتجاجات كخيار موازٍ للضغط الخارجي، يتفاعل معه ويُسرِّع نتائجه، بدل أن يكون بديلًا كاملًا عنه.
في هذا السياق، يندرج تهديد دونالد ترامب بالتدخل في حال سقوط قتلى بين المتظاهرين، ضمن إستراتيجية ردع هادف إلى محاولة:
ــ إرباك القيادة الإيرانية.
ــ إبقاء الاحتجاج مفتوحًا زمنيًّا.
ــ الإيحاء بوجود «خط أحمر دولي» يقيِّد يد السلطات في طهران.
الأثر الأعمق هنا نفسي–سياسي: إنتاج مظلّة تشجيع للمعادين للنظام، توحي بوجود معادلة خارجية حامية، حتى لو كانت بلا ضمانات عملية. هذه المظلّة — حقيقية كانت أم متخيّلة—تُخفض كلفة المخاطرة، وتُطيل عمر الاحتجاج، وتزيد منسوب تسييسه. من هنا فإن موقف ترامب يتجاوز كونه تغريدة إلى توجيه رسالة مدروسة في سياقها وتوقيتها ومضمونها وأهدافها.
العامل الإسرائيلي
في الخلفية، تراقب إسرائيل المسار الإيراني بعيون أمنية باردة. بالنسبة لتل أبيب، لا تُقاس الاحتجاجات بقيمتها الأخلاقية أو الإعلامية، بل بقدرتها الفعلية على تغيير ميزان القوة أو إضعاف الخصم إستراتيجيًا.
الإسرائيليون لا يتساءلون ما إذا كان النظام تحت الضغط؟ بل ما إذا كان هذا الضغط قابل للتحول إلى تراجع في القدرات، أم سيُفضي إلى تصلُّب أكبر؟
لذلك، لا يُستبعد أن تُدرَس — في غرف التقدير — خيارات تهدف إلى تعزيز صورة الضعف: تضخيم مؤشرات التصدّع، تسويق سرديات الإنهاك، أو الإيحاء بأن النظام فقد السيطرة. غير أن هذه الخيارات تبقى محفوفة بالمخاطر.
أضف إلى ذلك، أن الخطورة الحقيقية تكمن في أن الردّ الإيراني قد يحقق عكس الهدف تمامًا. فالتاريخ يُظهر أن طهران تميل، تحت الضغط المركّب، إلى إدارة الوضع كجزء من مواجهة التدخل الخارجي وإعادة تعبئة داخلية تُقدّم التحدي بوصفه دفاعًا عن السيادة. لذلك يوجد قراءة أخرى تقول، إن أي مواقف إسرائيلية أو تدخل قد يكون مضراً لجهة أنه سيُعيد تعميق التفاف الشعب الإيراني حول نظامه، كما حصل في الحرب الأخيرة.
في مثل هذا السيناريو، قد تتحول محاولات إظهار الضعف إلى عامل تماسك، وتُستثمر المظلّة الخارجية الموحى بها لإثبات «تدخل العدو»، بما يمنح السلطة ذريعة سياسية–أمنية لتعزيز الضبط وإعادة ترتيب الصفوف.
سوابق الخطأ في التقدير
تتقاطع هذه المخاطر مع سجل طويل من سوء التقدير الأميركي—والغربي عمومًا—لطبيعة المجتمع الإيراني: المبالغة في قابلية الاحتجاج للتحول إلى مشروع سياسي بديل، والاستخفاف بالحس السيادي، والخلط بين الغضب المعيشي والاستعداد للارتهان الخارجي. هذا السجل حاضر بقوة في الحسابات الإسرائيلية أيضًا، ما يفسّر الحذر من المراهنة على مسارات لم تُختبر نهاياتها.
في المحصلة، يتحرك المسار الإيراني اليوم بين ضغط خارجي، واحتجاج داخلي، ومراقبة إسرائيلية دقيقة. قد تبدو معادلة إظهار الضعف مغرية، لكنها تحمل خطرًا بنيويًّا من أن يدير النظام الأزمة بطريقة تُحوّل الاستنزاف إلى تماسك، والضغط إلى شرعنة أشد للضبط. هنا، لا تكمن المفارقة في فشل الرهان فحسب، بل في انقلابه على أصحابه—حين يُنتج الرد الإيراني ما يناقض تمامًا الصورة التي سعى الآخرون إلى رسمها. ما تقدَّم ينسحب أيضًا على أي متغيرات داخلية يعمل الأميركي من خلال الحرب الاقتصادية على التسبب بها، بعدما أدرك ثبات الموقف الإيراني والتفاف الشعب حوله.