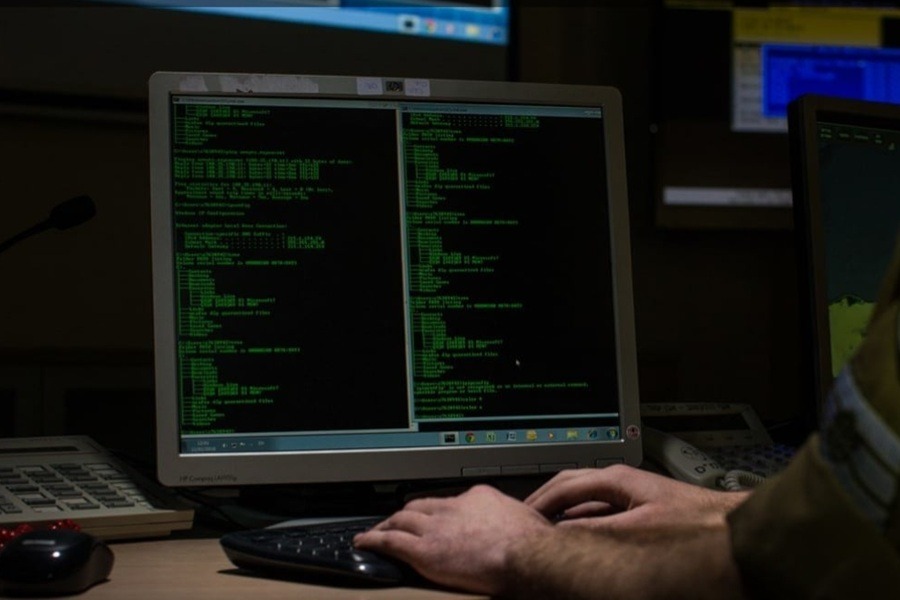مقالات مختارة

مروة جردي - صحيفة الأخبار
يهزم الإنسان الزمن عندما يتحول إلى حكاية شعبية، أو رمزاً لقيمة ما. ويحفر عميقاً في التاريخ إذا صار موضوعاً للدراسة والبحث. فلا يغادر بذلك مسرح الحياة أبداً. جمال عبد الناصر، تشي غيفارا، نيلسون مانديلا، وجواهر لال نهرو وغيرهم. لم يكونوا مجرد قادة سياسيين أو عسكريين، كانوا يجسّدون طموحات شعوبهم ويبددون مخاوفها.
الكاريزما، الخطابة، الشباب، ومناهضة الاستعمار كانت عوامل مشتركة شكّلت رموز التحرر حول العالم. كان آخرهم نصر الله (هل من داعي لذكر الاسم كاملاً بعد الآن؟). للرجل اسم غني عن التذكير، وحضور لم يخبُ مع الوقت، وتأثير لم يتراجع بعد. مرّ عام على لحظة رحيله التي شغلت العالم، ويبدو أنّ صورة «الثائر البطل» ما تزال تثير أسئلة كبرى، خصوصاً مع رحيل أحد أبرز رموز المقاومة العربية في السنوات الأخيرة. فهل انتهى هذا الزمن فعلاً، أم أننا أمام تحوّلات في طبيعة البطولة وأدواتها؟
«واحدٌ منّا»
في المخيلة البشرية القديمة، ارتبط مفهوم البطولة بالحكايات والأساطير. من الإلياذة والأوديسة إلى «سيرة عنترة» في التراث العربي، كان البطل شخصية استثنائية يتجاوز قدرات البشر العاديين. لكن مع تحوّلات القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، ولد نموذج جديد «الثائر البطل». لم يعد البطل مجرد شخصية روائية، بل صار قائداً حيّاً، يختزل آمال الجماهير في شخصه.
هذا النموذج من القائد الملهم لم يكن سائداً، ولكنه ظهر كنتاج مباشر للتحولات الكبرى التي شهدتها حركات التحرر في أميركا اللاتينية والهند وإفريقيا عقب الثورة الفرنسية. هكذا برزت أسماء مثل سيمون بوليفار، المهاتما غاندي، نيلسون مانديلا. لم يكونوا فقط سياسيين أو عسكريين، بل رموزاً جسّدوا فكرة الحرية، وأعطوا الجماهير شعوراً بقدرتهم على تغيير التاريخ.
في العالم العربي، صعد جمال عبد الناصر في لحظة عطش جماهيري إلى قائد يتكلم باسمها. لم يكن ضابطاً فحسب، بل رمزاً للكرامة الوطنية والقومية. بصوته الشعبي وهيبته العسكرية، أصبح «صوت مصر» و«صوت العرب»، ونجح في تحويل شخصيته إلى مرآة لآمال شعوب تمتد من المحيط إلى الخليج. وفي أميركا اللاتينية، قدّم كاسترو وغيفارا نسخة أخرى من البطل الثائر. غيفارا تحديداً تحوّل إلى صورة أيقونية عابرة للزمن والحدود، حتى صارت صورته على الجدران والقمصان رمزاً عالمياً للمقاومة. اللافت أنّ الصورة هنا لعبت دوراً مركزياً: لحيته الكثّة، السيجار، النظرة الحادة. هذه العلامات البصرية ساعدت في خلود رمزيته، رغم أن حياته انتهت مبكراً.
وفي لبنان، اتخذت البطولة منحًى مغايراً مع ولادة المقاومة في ثمانينيات القرن الماضي، حيث برز نموذج «البطل السري»؛ بطلٌ لا تصنعه المنابر ولا الأضواء، بل يكتسب كاريزمته من الغموض والعمل الميداني في الظل. وقد تجسد هذا النموذج في شخصية الشهيد عماد مغنية، الذي تحوّل إلى رمز أسطوري يثير قلق أجهزة المخابرات العالمية خلال حياته، ثم أصبح بعد استشهاده محور بحث الناس عن سيرته، وأحياء طفولته، والمعارك التي قادها.
ومع نصر الله، بلغت فكرة «الثائر البطل» ذروتها؛ فنجح القائد التاريخي للمقاومة في كسر الصورة النمطية التي حاول الغرب إلصاقها بالمجتمعات العربية والإسلامية. بل صار لغزه وحضوره محل اهتمام مثقفين عالميين مثل نعوم تشومسكي، وصحافيين أمثال جوليان أسانج ومحمد حسنين هيكل. كما تمكن من كسر لعنة المواجهات مع العدو، وما لم يستطع عبد الناصر تحقيقه قامت به المقاومة اللبنانية مع نصر الله، وما تمكنت إسرائيل من فرضه على ياسر عرفات لم تحصل عليه مع نصر الله. هكذا ارتبط اسمه بمشهد عالمي يذكّر بالحركات التحررية الكبرى في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، كاسراً كل الحواجز التي تفرضها الهيمنة الغربية على التنظيمات المقاومة.
والكاريزما التي أحاطت بنصر الله والمقاومين في لبنان تركزت في أنهم كانوا أشخاصاً «عاديين». أبناء جيران خرجوا من أحياء فقيرة ومتواضعة، ولكنها تثمّن التعليم وتسعى إليه، كما تسعى إلى تحرير الأرض، فكان من الطبيعي أن يجدوا أبجديتهم الخاصة للعمل المقاوم والتحرير.
ماذا يعني أن تفقد «الثائر البطل» اليوم؟
لكن إذا كان القرن العشرون هو زمن «السرديات الكبرى» التي صنعت أبطالاً يتكرسون عبر عقود، فإنّ القرن الحادي والعشرين أدخلنا في زمن مختلف «اقتصاد الانتباه». في الماضي، كانت صورة البطل تُبنى ببطء: عبر خطب تُدوَّن، أغنيات وطنية، قصائد حماسية، ثم لاحقاً عبر السينما والوثائقيات. كان التراكم يمنح البطل عمقاً ملحمياً تصعب زعزعته، فتتكون صورة البطل عبر تراكم سردي طويل، لتستقر في الذاكرة الجمعية بوصفها أيقونةً تتجاوز اللحظة إلى التاريخ. فيصبح عمليات تشويهها أو النيل منها أصعب.
أما اليوم، فالبطولة قد تُختصر في مشهد مدته عشر ثوانٍ على «تيك توك»، أو صورة تُتداول ملايين المرات. إنها بطولة أيقونية سريعة الزوال، تُستهلك وتُستبدل بأخرى، ترتبط بحجم التفاعل سواء أكان سلباً أم إيجاباً وليس بالشخص أو الفكرة نفسها، ما يخلق أزمة: كيف يمكن الحفاظ على عمق التجربة الثورية إذا كانت تُضغط في مقاطع قصيرة وتختفي وسط تدفق الخوارزميات؟ وهكذا، نواجه معضلة مزدوجة: من جهة، الحاجة إلى رموز جديدة قادرة على اختراق الفضاء الرقمي، ومن جهة أخرى، ضرورة الحفاظ على معنى عميق يتجاوز «الترند» السريع الزوال.
هذه المعضلة تزداد حدة في سياق المقاومة العربية. حيث فجّر اغتيال نصر الله بوصفه آخر الأبطال الكلاسيكيين سؤالاً جاداً هل يمكن صناعة مشروع وفكرة جديدة تحرض الأجيال على استمرار المقاومة في عصر تبتلع فيه الخوارزميات السرديات الكبرى وتسطحها. وإن كان ذلك ممكناً هل يمكنها الاستمرار والعيش في وجه «الإرهاب الفكري» الذي تمارسه الأنظمة العالمية وشبكات التكنولوجيا والإعلان عبر فرض ما المسموح وما الممنوع للجماهير بالتداول والتفاعل معه وحتى التعاطف أو التأييد.
أدرك العدو في حروبه الأخيرة أن التفوق العسكري لا يكفي أمام مقاومةٍ تتجاوز البندقية إلى قدرتها على إنتاج رموز بشرية تبعث فكرة القتال من جديد جيلاً بعد جيل، وتحيل الموت في سبيل التحرير إلى معنى يتخطى الأزمنة. لذلك لم يكن استهداف القادة الكبار مجرد إجراء عسكري، بل فعلاً سياسياً وثقافياً يرمي إلى تجفيف هذا النبع الرمزي وقطع الصلة بين اللحظة التاريخية والسردية المتجددة. فالاغتيال هنا محاولة لإجهاض ولادة البطل التاريخي، ودفع البطولة إلى أن تتحوّل إلى «ترند» عابر. وربما لهذا كتب تولستوي يوماً «لست أخشى الموت... بل خوفي من غياب المعنى».
أزمة البطل الواحد
من أخطر التحديات التي رافقت تجربة «البطل الثائر» هي هشاشة المشروع أمام غياب الفرد. تجربة عبد الناصر أبرز مثال: الهزيمة في 1967 لم تكن مجرد نكسة عسكرية، بل صفعة لمشروع قومي ارتبط باسمه شخصياً. بعد رحيله، تراجعت الموجة القومية، وقبلت جماهير واسعة بتسويات لم تكن لتقبلها سابقاً. هذا الدرس وعته حركات المقاومة الحديثة. لذلك رفعت شعار «قادتنا شهداء»، وأصرت على أن تكون البنية جماعية، شبكية، قادرة على الاستمرار رغم خسارة الأفراد. ومع ذلك، يبقى الرمز الفردي ضرورياً لاستنهاض الجماهير، وهو ما يجعل اغتيال القادة هدفاً سياسياً وثقافياً بقدر ما هو عسكري.
لكن العدو، بدوره أيضاً تطور ولم يعد يكرر أخطاء الماضي، فحرص في حربه الأخيرة على تنفيذ هجوم متقدم على قراءة المقاومة، فلم يستهدف الزعيم الرمزي أو الثائر البطل فقط، بل استهدف شبكات التواصل الداخلية للحركة عبر جريمة «البيجر»، في محاولة لتفكيك الرابط بين الشخص الرمزي والمؤسسة الشبكية. هذا الهجوم وضع الحزب أمام اختبار مزدوج تعويض الثائر البطل كرمز كاريزمي للجماعة، وضمان تماسك الشبكة الداخلية للمشروع، إذ يبقى قادراً على الاستمرار في مواجهة الأزمات. وبذلك، يصبح السؤال الأساسي للجماعة ليس فقط عن قوة الفرد، بل عن مرونة الشبكة وقدرتها على الاحتفاظ بالرمزية الجماعية.
رحيل القادة الكبار يطرح دائماً سؤالاً وجودياً: هل ينتهي المشروع برحيلهم؟ التجربة التاريخية تقول إنّ الشعوب قادرة على استدعاء رموز جديدة، وإن المعنى لا يموت بغياب الأشخاص. لكن الفرق اليوم أنّ ساحة المعركة لم تعد محصورة في الجغرافيا أو في ميادين القتال، بل امتدت إلى فضاء الإعلام والمنصات الرقمية، حيث تتنافس الصور والرموز كما تتنافس الجيوش.
هكذا نفهم أنّ استهداف القادة الكبار لم يكن عسكرياً فقط، بل محاولة لحرمان الجماهير من بناء سرديات جديدة. ومع ذلك، يبقى الدرس الأهم أن البطولة لا تختفي، بل تعيد تشكيل نفسها بأشكال مختلفة. قد لا نشهد بعد اليوم بطلاً بحجم عبد الناصر أو غيفارا أو نصر الله، لكننا بالتأكيد سنشهد أشكالاً جديدة من الرموز الثورية، تعكس روح عصرها، وتعيد للناس إحساسهم بالمعنى وسط التحولات الكبرى.