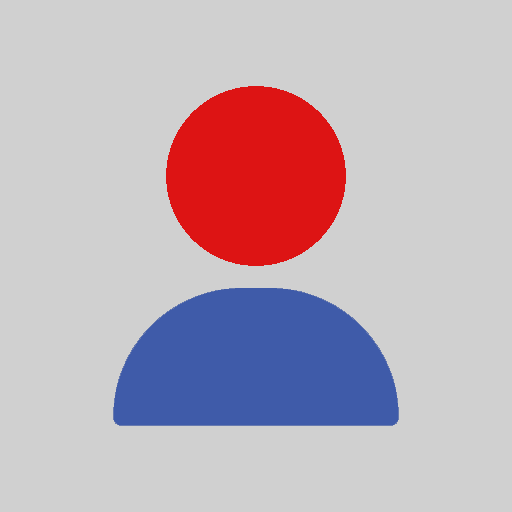تحقيقات ومقابلات

إنه التاسع والعشرون من تشرين الأول عام 2024. لم تكن تعرف الحاجة لينا حمامص أنه سيكون مختلفًا عن كل ما عرفته سابقًا. حسبته يومًا عاديًا من أيام الحرب، وهي التي كانت قد قررت أن تصمد في بلدتها كفرتبنيت طيلة حرب الإسناد لغزة ومعركة أولي البأس، يرافقها ابنها علي قاطبي. كان يومًا عاديًا -كما تخيلته- كانت تحضّر فيه ابنة الجنوب العشاء لولدها وأخيها.
الساعة كانت تشير إلى السادسة و17 دقيقة من بعد الظهر، عندما سمع من في المنزل صوت أول صاروخ، فشعروا كم كان قريبًا. سمعوا صوت الصاروخ الثاني. همّ علي نحو الشرفة ليشاهد أين وقع، وما إن وقف، حتى رأى الجميع لونًا أحمر يتوهج في المكان وسمعوا صفيرًا عاليًا، وجاءهم الصاروخ الثالث في قلب البيت، مزق الجدران التي احتضنت دفء الأيام الجنوبية، وخَلع النوافذ، وذرّ الذكريات فوق الركام. نادى الجميع "يا الله" "يا الله". شاهدت أم علي بأمّ عينها كيف طار ابنها نحوها، وتهاوى السقف عليها، ورأت أخاها يسقط في حفرة أعمق إلى الأسفل نتيجة الانهيار، حتى باغتهم صاروخ رابع، فاختطلت أنفاسهم بالدخان.
لم يمهلهم الصوت وقتًا للهروب، كان أسبق من الصرخة. امتلأت الأرض بأشيائهم. هنا أغراضهم، ويد تبحث عن يد أخرى تحت الركام.
تحت الأنقاض كانت محاصرة بين كتل الإسمنت والسقف المتهاوي. أرادت أم علي أن تصرخ ولكن شيئًا في صدرها منعها. كان ابنها، ساكنًا في حضنها كما اعتاد، قدماه على خديها. لم يكن يستطيع الكلام. وكانت كلما سألته عن حاله أجابها بتحريك قدميه.
أتى المسعفون أول مرّة، يتسلل صوتهم من بين الأنقاض: "هل من أحد هنا؟". لم يكن الصوت عاديًا، كان أشبه بيد تمتد وسط العتمة. صاحت أم علي بكل ما فيها من قوة: "أنا هنا تحت الأنقاض". بين صدى الركام لم يكن صوتها مسموعًا. وصوت مسيرّات العدو يطغى على المكان. غادر المسعفون وبقيت أم علي ترفض إعلان الرحيل، وهي تحتضن الدفء الأخير لجسد ابنها.
في لحظة؛ عمّ الظلام وغابت الأصوات. الهاتف بيد أم علي ولكن "لا إرسال أو إشارة" للتواصل. بات شاهدًا فقط على الدقائق التي تحولت إلى ساعات. كانت تسمع صوت نفس أخيها المتقطع، فتكافح ليبقى هادئًا، بينما هي محاصرة تحت جدار.
ساعتان وأم علي تحتضن جسد ولدها، بانتظار عودة المسعفين. شعرت أن أنفاسه تتباطأ، وبدأ جسمه يبرد تدريجيًا، كأن الروح انسحبت منه على استحياء. فجأة توقف عن الحركة. لا أنفاس ولا رجفة. حدثته، ونادته، ولكن هذه المرة كان الجواب ساكنًا. أدركت الحقيقة، وبدأ قلبها يقاوم الألم، تتمسك بالحياة، تحاول إخفاء الأمر عن أخيها كي يبقى متماسكًا. تحدث نفسها أنه نال ما تمنى.
الركام فوقها والحطام حولها، وجسد ابنها البارد في حضنها، فلا حضن مهما كان دافئًا يردُّ المغادر. لم تكن تدري أنها ستكون آخر وسادة يضع رأسه عليها وآخر حضن يعرفه.
عاد المسعفون عند الساعة الحادية عشرة، ولكن عبثًا، لم يكن صوت أم علي وأخيها مسموعًا. غادروا؛ وبقيت أم علي تصارع ظلمة الأنقاض.
وسط الغبار، كانت الأم تزحف ببطء وحذر، تحت الركام الثقيل، تحرك يديها، وتحاول أن تفتح فتحة صغيرة تسمح بدخول الهواء أو إخراج يديها منها.
أحست بالثقل، ولكنها لم تفقد الأمل رغم الوهن والتعب. أغلقت الفتحات التي تُطل على المطبخ بالوسادات، كي تمنع تسرب الغاز نحوهم.
ليل طويل وأنفاس ثقيلة، والساعة تمر ببطء شديد. لم تكن هناك أصوات سوى أصوات التنفس الخافتة. والذكريات تنهال على أم علي واحدة تلو الآخرى، وكأنها تخفف عنها وتمسح على قلبها بالسكينة. ابتسمت رغم الغبار، والحطام، والفقد.
وسط كل ذلك، لم تكن وحدها، كانت في حضرة اللطف، في كنف من لا يُغلق بابه. وها هو اللطف الإلهي كنسمة خفيفة يتسلل بين الخراب ليحييها من بين الصخور. فعندما شعرت كأنها تودع الحياة، نتيجة العطش الشديد، كان الماء قد بدأ يتسلل من الخزان، كأنه بارقة أمل وسط الدمار، وفي جانبها "كيس المحارم" الذي كانت تهم بفتحه قبل الغارة، وكأن الله رسم لها كل شيء.
بيدين متعبتين، كانت تمسك المحارم التي تبتل سريعًا، تجمع بها قطرات المياه المتساقطة ببطء من شق السقف المنهار، فتعصرها في فمها.
صوت المياه كان يهمس بألم المكان ولكن أم علي قوية كما عهدها الجميع دائمًا.
ظلت تحاول أن تشق طريقها وسط الأنقاض طوال الليل، حتى شعرت فجرًا، بالضوء الخافت الذي تسلل من الخراب، كأنه أمل صغير أصر أن يقاوم. نادت: "قليلًا يا أخي وسيصل المسعفون"، مردفًة: "الضو بلش يشقشق وشوي بيجو أكيد".
دقائق معدودة، وسمعت صوتًا، كان صوت حفر وأقدام، فحاولت أن تضرب بيدها على الركام، ونجحت محاولات الليل الطويل، فخرج صوتها من بين الأنقاض. سمع المسعفون أصوات استغاثة. أوقفوا الحفر، وبدأوا بإزالة الإسمنت والحديد وبقايا الجدران. كل حجر كان يُرفع يزيح عمرًا من الذكريات.
اقترب المسعف، عيناه تتفادى عينيها، وقال بلطف "علينا أن نسحب جثمان الشهيد". صرخت أم علي: "لا".
طلبت منهم التمهل: "دعوني أودعه كما يليق بالأم". تأملته، أحاطته بذراعيها، كما لو أنها تستطيع أن تقيه من كل شيء حتى الموت.
في كل ليلة عندما كانت أم علي تقبل جبين ابنها، كانت تشعر بدفء وجهه يتسلل إلى ناحية قلبها. كان قاسيًا عليها أن تضع يديها على خده فتشعر بالبرد. كانت تريد أن ترتشف من عينيه آخر نظرة، تكفيها لما تبقى من عمر، فما أصعب الصقيع الذي سرى من وجهه إلى قلبها.
عندما سحب المسعفون جثمان ابنها عنها، خرجت أم علي بمفردها، لم تحتج المساعدة، نظرت إلى الضوء وكأنه بداية جديدة من حياتها، واكتفت بقول: "الحمد الله". ثماني عشرة ساعة تحت الركام كانت كفيلة أن تعيد ترتيب كل شيء داخلها. كم هي قوية، جميلة، صابرة، محتسبة، وصامدة.