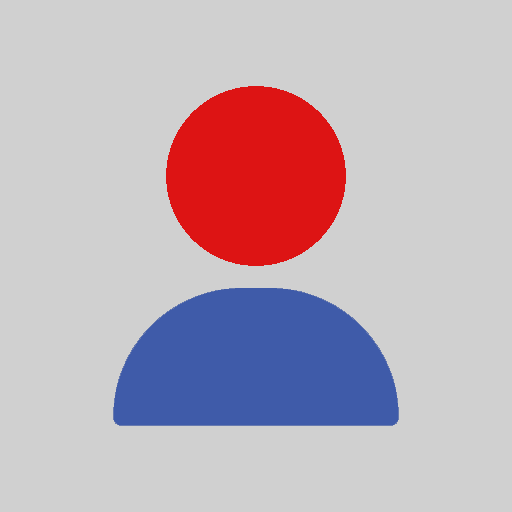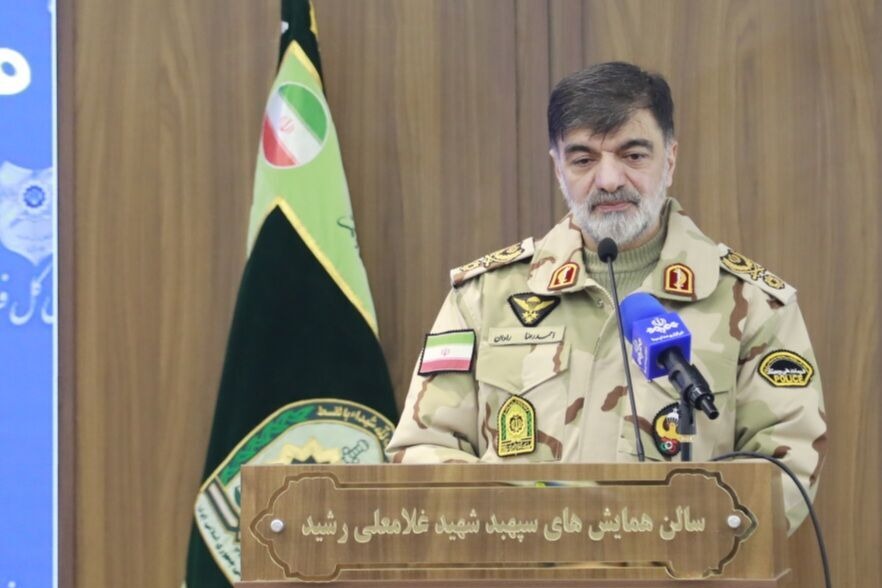مقالات

تتوالى في كيان العدوّ تقارير تتحدث عما يُسمّى "ضغوطًا" يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على بنيامين نتنياهو، في أكثر من ساحة، وفي مقدمتها الساحتان السورية واللبنانية. وبعيدًا عن التعابير المستخدمة في الخطاب "الإسرائيلي"، يمكن قراءة هذا المشهد انطلاقًا من فرضية أكثر عمقًا، مفادها أن ما يجري هو ضبط أميركي للأداء "الإسرائيلي" الميداني، بما يتوافق مع رؤية إدارة ترامب ومنطلقاتها وأهدافها الإقليمية.
انطلاقًا من هذا المفهوم، يصبح من الضروري التأكيد أن ما يبدو في الشمال "الإسرائيلي" - السوري - اللبناني تهدئة ظرفية أو ضبطًا للميدان، لا يصح تفسيره وفق معايير عسكرية مباشرة. نحن أمام لحظة سياسية مركّبة تُدار فيها الجبهات لا بوصفها ساحات حسم، بل باعتبارها أدوات إشارة ورسائل متبادلة بين فاعلين غير متكافئين. وهذا ما يفتح الباب أمام أسئلة جوهرية: من يملك القرار؟ من يُقيَّد؟ ولماذا الآن تحديدًا؟
في المستوى الأعمق، تتفرع عن هذه القراءة فرضية ثانية: لا أحد يريد حربًا جديدة، لكن الجميع يسعى إلى التحكم بما دون الحرب. تحت هذا السقف، تحاول الولايات المتحدة إعادة تشكيل الإقليم، وفي الوقت نفسه فرض ضبط ميداني يسمح بتسويق إنجازات سياسية، ويمنع انزلاقات قد تفرض كلفة غير محسوبة.
هذا الإطار يجعل من "الكبح" أداة سلطة، ويحوّل ضبط الإيقاع إلى أولوية تتقدّم على توسيع مساحة الفعل، لأن الفعل غير المنضبط لم يعد مضمون النتائج. هنا تُدار القوّة عبر التقييد لا عبر التفويض المفتوح.
ضمن هذا السياق، يظهر الدور الأميركي باعتباره المنسّق الأعلى. ويبدو أن ترامب، ومعه الدوائر المحيطة به إجمالًا، يرى أن التصعيد "الإسرائيلي" في الشمال يهدّد ترتيبًا سياسيًا أوسع يسعى إلى تسجيله كإنجاز: فتح أفق مصالحة محتملة مع سورية، وتعزيز فكرة السلطة المركزية في لبنان.
من هنا، فإن الرسائل الكابحة الموجّهة إلى تل أبيب -وفق ما تنقله التقارير "الإسرائيلية"- لا تعبّر عن خلاف تكتيكي، بل عن دفاع واضح عن أولوية أميركية: إبقاء الجبهات ضمن مستوى يمكن التحكم به سياسيًا، في عملية تهدف إلى رسم حدود الحركة. والنتيجة الأبرز أن "إسرائيل"، في هذا السياق، لا تبدو صاحبة المبادرة، بل عنصرًا داخل مخطّط أوسع.
وبغضّ النظر عن منسوب العامل الشخصي والسياسي الداخلي في القرارات الإستراتيجية، يتحرك نتنياهو من موقع مختلف تمامًا. فهو لا يدير مشهدًا إقليميًا، بل يحاول النجاة من مأزق داخلي وسياسي وشخصي. وبعد حرب غزّة التي لم تؤدِّ إلى الحسم، ومع تصاعد أزماته القضائية والسياسية، يصبح التصعيد في الساحات البديلة محاولة لإعادة إنتاج صورة "القائد الأمني".
غير أن هذا التصعيد، في سورية ولبنان، يتجاوز أحيانًا السقف الذي تريده واشنطن. وهنا يتكشّف التناقض الجوهري: نتنياهو يحتاج التصعيد ليبقى فاعلًا، فيما يحتاج ترامب التهدئة ليبقى متحكمًا. وحين يتعارض الاحتياج مع التحكم، تكون النتيجة تقييد الفاعل الأضعف. حتّى ورقة العفو المحتمل، التي تلوح في الخلفية، تزيد من هشاشة موقع نتنياهو، فهو شريك، لكن شريك تحت الاختبار، لا صاحب قرار مستقل.
في هذا السياق، تتحول الجبهات الشمالية من ساحات مواجهة عسكرية إلى مساحات إدارة سياسية. فالغارات "الإسرائيلية" المستمرة في لبنان، وفق الفرضية المشار إليها، تعنى أن الضغوط الميدانية -حتّى إن تصاعدت- ستبقى مضبوطة بما يخدم المخطّط الأميركي في الساحة اللبنانية، والذي يمر بالضرورة عبر إضعاف حزب الله، ولكن من دون دفع الأمور إلى انفجار شامل.
وهنا تبرز تساؤلات داخل كيان العدوّ حول ما إذا كانت الولايات المتحدة باتت ترى أن الضغط العسكري المفرط قد لا يخدم مشروعها، إذ قد يعيد إنتاج شرعية حزب الله لاستخدام قوته العسكرية، وقد ينعكس ذلك أيضًا على المعادلة الداخلية اللبنانية. ومن هذا المنطلق، تجري إدارة الصراع ضمن هامش ضيق: ضربات محسوبة، رسائل محدودة، ومنع الانفجار.
الضبط هنا ليس تجميدًا للميدان، بل توظيف له في خدمة مشروع سياسي. "إسرائيل"، رغم تفوقها العسكري، تعمل ضمن سقف سياسي أميركي صارم. ونتنياهو، رغم خطابه التصعيدي، محكوم بقيود تتجاوز قدرته على المناورة. أما الولايات المتحدة، فتمارس هيمنتها لا عبر إطلاق الأيدي، بل عبر شدّها حين يلزم.
في الخلاصة، الرسائل الكابحة ليست تفصيلًا تكتيكيًا ولا استثناءً ظرفيًا، بل تعبير عن لغة المرحلة، مرحلة تُدار فيها الصراعات بالحد الأدنى من النار والحد الأقصى من الضبط. الشمال لم يهدأ لأنه استقر، بل لأنه أُدرج ضمن معادلة أكبر لا تسمح له بالاشتعال. ومع ذلك، لا يتعارض كلّ ما سبق مع احتمال حصول تصعيد ميداني، شرط أن يكون في خدمة المسار السياسي الأميركي لا خروجًا عليه. غير أن الهامش الأخطر يبقى قائمًا: لا أحد يضمن أن لا تفلت التطورات يومًا وتسلك مسارات مغايرة لما يراهن عليه اللاعبون.