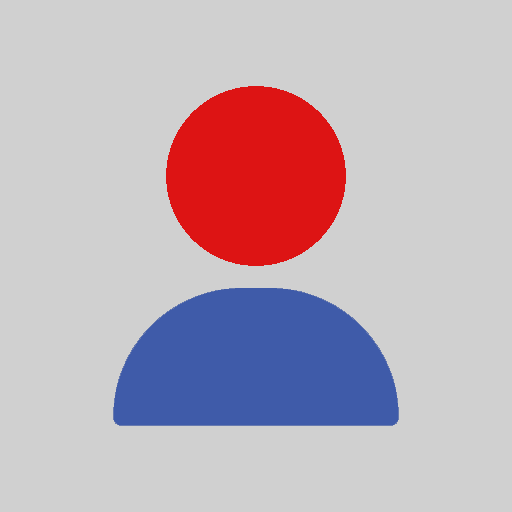مقالات

تُظهر التجارب التاريخية للصراعات الكبرى أن الفجوة بين التقديرات المسبقة ومجريات الأحداث الفعلية تكاد تكون القاعدة لا الاستثناء. فالحرب، بطبيعتها، ليست مسارًا خطيًا يمكن ضبطه بالكامل بالحسابات المسبقة، بل هي "مملكة اللايقين"، حيث تتقاطع الإرادات، وتتشابك ردود الفعل، وتفرض الوقائع الميدانية نفسها أحيانًا بعكس الرهانات الأولية. كثيرًا ما دخلت الدول حروبًا وهي تملك تفوقًا عسكريًا واضحًا، لكنّها فوجئت بتحولات لم تكن في الحسبان؛ وكثيرًا ما بُنيت إستراتيجيات على تقديرات عقلانية، ثمّ أعادت ميادين القتال صياغة تلك العقلانية تحت ضغط الواقع.
في هذا الإطار، تندرج القراءة "الإسرائيلية" للتطورات المتسارعة حول إيران. فهي قراءة مدركة لحدود التقدير المسبق، لكنّها في الوقت نفسه تحاول تقليص مساحة المفاجأة عبر الاستعداد الطويل، وتراكم الأدوات، وإدارة الوقت. غير أن إدراك الحرب بوصفها فضاءً مفتوحًا على اللايقين لا يلغي الحاجة إلى بناء تصورات، بل يجعلها أكثر حذرًا، وأقل اندفاعًا نحو حلول سريعة أو رهانات قاطعة.
تتعامل "إسرائيل" مع التطورات المتسارعة المحيطة بإيران بوصفها لحظة تقريرية في مسار صراع طويل الأمد، لا مجرد أزمة ظرفية يمكن احتواؤها بتسوية محدودة أو ضربة رمزية. في الوعي الأمني والسياسي "الإسرائيلي"، لا تُختزل إيران في برنامج نووي أو منظومة صاروخية، بل تُرى كمنظومة صراعية متكاملة يقودها نظام أيديولوجي يعتبر دعم قوى المقاومة ومواجهة الهيمنة الأميركية، وبناء شبكات الردع غير المباشر، وإعادة صياغة موازين القوّة في "الشرق الأوسط"، عناصر جوهرية في إستراتيجيته الإقليمية.
انطلاقًا من هذا الفهم، لا تقرأ "تل أبيب" الخطوات الأميركية الأخيرة، بما في ذلك فتح هامش للمفاوضات، باعتبارها تردّدًا أو تراجعًا عن خيار القوّة. على العكس، يسود تقدير بأن إدارة واشنطن، وتحديدًا الرئيس دونالد ترامب، تمارس سياسة إدارة وقت محسوبة، تهدف إلى اختبار حدود المرونة الإيرانية، واستكمال الجاهزية العسكرية، وبناء غطاء سياسي ودولي لأي خطوة لاحقة. في هذا السياق، لا يُنظر إلى الخيار العسكري بوصفه أُسقط من الطاولة، بل جرى تأجيله إلى لحظة يُعتقد أنها أكثر فاعلية وأقل كلفة من حيث التداعيات السياسية والإقليمية.
غير أن القلق "الإسرائيلي" الحقيقي لا يكمن في المسار التفاوضي بحد ذاته، بل في مآلاته المحتملة. فالتجربة السابقة، وفق القراءة "الإسرائيلية"، تُظهر أن أي اتفاق يركّز على الملف النووي وحده، ويتجاهل الصواريخ الباليستية وشبكة الحلفاء الإقليميين، لا يخفف التهديد بقدر ما يعيد تنظيمه. النووي، في هذا المنظور، خطر مؤجَّل يمكن إدارته زمنيًا، بينما تمثل الصواريخ تهديدًا فوريًا، وتُعد الشبكات الحليفة أداة استنزاف دائمة، وقادرة من منظور إستراتيجي على إعادة بناء وتطوير قدراتها. من هنا، يتشكّل اقتناع بأن "الاتفاق الناقص" قد يكون أكثر خطورة من عدم التوصل إلى اتفاق، لأنه يمنح إيران وقتًا وشرعية لإعادة التموضع تحت سقف سياسي جديد.
في ضوء ذلك، ترفض "إسرائيل" فكرة الضربة العسكرية المحدودة باعتبارها حلًا مقبولًا. فالتقدير السائد يفترض أن هجومًا قصيرًا، مهما بلغت دقته، لن يُسقط النظام الإيراني، ولن يدمر كامل قدراته، بل قد يمنحه فرصة لإعادة ترتيب أوراقه داخليًا، وتوحيد الجبهة الداخلية حول خطاب “الصمود في وجه العدوان”. الأخطر من ذلك، أن مثل هذه الضربة ستترك لدى إيران ما يكفي من القدرات للرد، سواء عبر استهداف القواعد الأميركية، أو الملاحة الدولية، أو "إسرائيل" نفسها، بما في ذلك مخزون الصواريخ والبنية التحتية القادرة على إعادة الإنتاج والتطوير.
تدرك "إسرائيل" أيضًا أن عنصر المفاجأة، الضروري لأي عملية عسكرية قصيرة وحاسمة، قد تآكل إلى حد كبير بفعل الحشود الأميركية العلنية والتحضيرات المكشوفة. لذلك، يترسخ في التقدير "الإسرائيلي" أن الخيار الواقعي الوحيد، في حال فشل الدبلوماسية، هو حملة عسكرية واسعة وطويلة نسبيًا، تُدار على مراحل، وتستند إلى بنك أهداف موسّع ومحدّث باستمرار. هذه الحملة، وفق التصور "الإسرائيلي"، لا تقتصر على استهداف القدرات العسكرية الصرفة، بل تمتد إلى بنى النظام، ورموزه، وأدوات السيطرة التي تتيح له الاستمرار في إدارة الصراع وتحمّل كلفته.
في هذا الإطار، يبرز العامل الدفاعي بوصفه عنق الزجاجة الحقيقي في أي مواجهة مقبلة. فتركيز واشنطن على نشر منظومات الدفاع الجوي والبحري يُقرأ في "تل أبيب" باعتباره إدراكًا بأن التحدّي الأكبر لا يكمن في القدرة على الضرب، بل في القدرة على الصمود تحت ضربات متبادلة. حماية الجبهة الداخلية "الإسرائيلية"، والقواعد الأميركية، ودول الخليج، ومنشآت الطاقة، وضمان بقاء الممرات البحرية مفتوحة، تُعد شروطًا مسبقة لا غنى عنها قبل الانتقال إلى أي عمل عسكري واسع، وليست مجرد إجراءات مرافقة له.
أما على المستوى الداخلي الإيراني، فلا تبني "إسرائيل" إستراتيجيتها العلنية على سيناريو انتفاضة فورية أو انهيار سريع للنظام. لكنّها ترى أن تراكم الضغط، الاقتصادي والعسكري والنفسي، قد يُنتج مع الوقت تصدعات داخل بنية النظام، حتّى لو لم تترجم فورًا إلى حراك واسع. من هنا، تظهر في "تل أبيب" آراء تُفضّل حملة استنزاف مدروسة وممتدة على ضربة واحدة قد تمنح النظام فرصة لالتقاط الأنفاس وإغلاق المجال أمام أي ديناميات داخلية محتملة.
ضمن هذه الصورة العامة، ترى "إسرائيل" نفسها طرفًا غير قابل للفصل عن أي سيناريو مقبل. قبل أي مواجهة، تواصل "تل أبيب" لعب دور مركزي في تزويد واشنطن بمعلومات استخبارية عالية الجودة، والمساهمة في صياغة بنك الأهداف، ونقل الدروس العملياتية المستخلصة من مواجهاتها الأخيرة مع إيران وحلفائها. وإذا اندلع الهجوم، فإن التقدير "الإسرائيلي" شبه محسوم: إيران ستسعى إلى ضرب "إسرائيل" سريعًا وبقوة، ما يعني أن "تل أبيب" لن تكون في موقع المتفرج، بل ستشارك مباشرة وسيكون لها مساحتها ودورها في الحرب، خاصة بعدما أثبتت إيران قدراتها الصاروخية حتّى في ظل مفاجآت عملياتية وتكتيكية.
في المحصلة، تعكس هذه القراءة "الإسرائيلية" تقديرًا عميقًا بأن الصراع مع إيران لم يعد سؤالًا نظريًا حول إمكان المواجهة، بل إشكالية مركّبة تتعلق بإدارة التوقيت، وضبط مسارات التصعيد، ومحاولة التحكم بنهايات حرب يُدرك صانعو القرار مسبقًا أنها لن تكون قابلة للضبط الكامل. فالدبلوماسية، في هذا التصور، ليست حلًا نهائيًا بل أداة اختبار وتأجيل؛ والضربة المحدودة رهان محفوف بالمخاطر؛ والحملة الواسعة، رغم كلفتها العالية، تُقدَّم كخيار اضطراري لا كخيار مثالي.
ومع ذلك، يبقى الإدراك حاضرًا بأن نتائج أي مواجهة لن تُحدَّد فقط بما خُطِّط لها في غرف التقدير، بل بما ستفرضه ميادين القتال وتفاعلاتها السياسية والإقليمية والدولية. فالحرب، مهما بلغت دقة حساباتها، تظل مجالًا مفتوحًا على المفاجأة، وعلى إعادة تعريف الانتصار والهزيمة. وعليه، فإن الصورة النهائية التي ستنتهي إليها أي مواجهة محتملة مع إيران لن ترسمها النيات ولا التقديرات وحدها، بل مجريات الأحداث نفسها، بما تحمله من تحولات غير متوقعة، ومن توازنات جديدة قد لا تشبه ما سبقها.