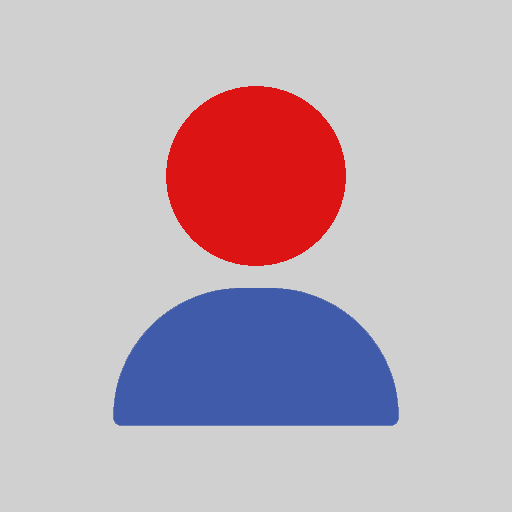مقالات

دكتوراه في العلاقات الدولية
تتجاوز إشكالية "مجلس السلام" الذي استحدثه الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقب حرب الإبادة في غزّة حدود المبادرات الدبلوماسية المألوفة؛ لتكشف عن رغبةٍ حقيقيةٍ في إعادة هندسة النظام الدولي وفق منظور يهدف لإحياء مشروع "أميركا أولًا" المتهالك. وقد أكد مسار الأحداث وتصريحات وخطوات ترامب هذه "التراجيديا" المفروضة، وأظهرت أن الأمر أخطر من كونه مجلسًا يسعى لتحقيق السلام، بل على ما يبدو نحن أمام لحظةٍ تاريخيةٍ تحاكي في مشهديتها ما عرفه العالم بعد الحرب العالمية الثانية. وهنا يبرز التساؤل الجوهري حول من يملك فعلًا صلاحية تعريف "السلام" وفرضه؛ إذ تتبدى فجوة سحيقة بين إرث الأمم المتحدة الذي نهض لمحاولة ترويض القوّة بإطار الشرعية، وبين "مجلس السلام" الذي يولد كذراعٍ لاستثمار فائض النفوذ الأميركي، محوّلًا بوصلة القرار العالمي من أروقة نيويورك الأممية صوب مكاتب واشنطن والبيت الأبيض تحديدًا.
وتجلّت هذه الإشكالية بوضوحٍ، بل وترسّخت جذورها عقب قرار واشنطن بالانسحاب من 66 منظمةً دوليةً، بينها 31 منظمةً تابعةً للأمم المتحدة؛ في خطوةٍ تؤكد أن توجهات ترامب لا تهدف للمشاركة في "العمل المتعدد الأطراف"، بل تسعى جهارًا لتفكيكه واستبداله بنظامٍ موازٍ يُخضع مفاهيم الشرعية والمساعدات الإنسانية لمعادلة النفوذ الأميركي المباشر. ولعل الدليل الأبرز على هذا النهج يكمن في المنطق الصريح الذي ساقه البيت الأبيض لتبرير هذه الانسحابات، حين أعلن بوضوحٍ أن تلك المنظمات لم تعد تخدم الرؤية الأميركية، بل باتت تتعارض كليًّا مع الأهداف "القومية" لواشنطن، ما يكشف عن نيةٍ مبيتةٍ لتجريد المؤسسات الدولية من دورها التاريخي وتحويلها إلى أدواتٍ معطلةٍ إذا لم تتماشَ بالكامل مع أجندة "أميركا أولًا".
لقد قامت الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة عقب الحرب العالمية الثانية كجزءٍ من هندسة "النظام الليبرالي"؛ بهدف إيجاد منصةٍ تجبر حتّى القوى المنتصرة على الانصياع لقواعد عامةٍ تضمن الحد الأدنى من الاستقرار العالمي، استنادًا إلى ما نصّت عليه المادّة الأولى من الميثاق حول صون السلم والأمن الدولي وتنمية العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق؛ إلا أن المشهد الراهن يعكس ارتدادًا عن تلك المبادئ.
ولا غرو من القول إن القوّة الأميركية استنفدت طاقتها في المدارات الأممية التقليدية بعد سلسلةٍ طويلةٍ من التدخلات العسكرية التي اجتاحت جغرافيا ممتدةً من فيتنام إلى العراق وسورية وأفغانستان وصولًا إلى خنق إيران واختطاف الرئيس الفنزويلي وسرقة موارد بلاده وتدمير غزّة. وعقب ذلك لم تعد واشنطن اليوم تقبل بحبس نفوذها داخل أروقةٍ دوليةٍ تحد من حركتها، بل اندفعت نحو صياغة هيكلٍ مؤسسيٍ موازٍ يضرب في الصميم جوهر المادّة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة؛ تلك المادّة التي لطالما ألزمت الدول بفض النزاعات سلميًّا وحظرت التلويح بلغة القوّة. ومن هذا المنظور، يطل "مجلس السلام" كخطوة أولية غير مشروعة ضمن مشروعٍ أضخم يهدف إلى تجريد الميثاق الأممي من قيمته القانونية، وتحويل المنظمة الدولية من مرجعيةٍ أخلاقيةٍ وقانونيةٍ تعبّر عن إرادة الشعوب، إلى مجرد هيئةٍ استشاريةٍ معطلةٍ تدور في فلك الإرادة المنفردة للبيت الأبيض.
ولعل الدليل القاطع الذي يحوّل هذا التحليل إلى واقعٍ ملموسٍ يكمن في بنود الميثاق التأسيسي لما يُسمّى "مجلس السلام"؛ إذ منح المرسوم الذي وقّعه ترامب مع دول أخرى في دافوس السويسرية صلاحياتٍ سياديةً مطلقةً لرئيسه مدى الحياة، تتجاوز حدود الإدارة لتصل إلى احتكار تفسير الميثاق، وتفعيل "فيتو شخصيٍ" يعطّل أي قرارٍ لا يتماشى مع هواه، إضافةً إلى سلطة التعيين والإقالة المزاجية للأعضاء.
وتتجلى المفارقة الهيكلية في هذا الكيان المستحدث من رحم الحروب والاعتداءات والتدخلات عبر إحلال "القدرة المالية" محل "الشرعية الدولية"؛ إذ يفرض الميثاق ضريبة عضويةٍ بقيمة مليار دولارٍ كشرطٍ لحيازة "مقعدٍ دائمٍ" لـ 35 دولةً؛ من بينها فواعل إقليمية عربية وإسلامية كقطر ومصر والسعودية وتركيا والأردن؛ ما يمثل استلابًا صريحًا لمبدأ "المساواة القانونية بين الدول" (Equal Sovereignty) وتحويل التمثيل الدبلوماسي إلى "سلعةٍ سياسيةٍ" خاضعةٍ لقوى السوق. هذا المسار يشكّل قطيعةً أبستمولوجية مع منطلقات ميثاق 1945 الذي كرس العضوية كحقٍ سياديٍ للدول المستقلة بغضّ النظر عن ملاءتها المالية؛ حيث ننتقل اليوم من نموذج "الأمن الجماعي" القائم على التزاماتٍ قانونيةٍ مشتركة، إلى نموذج "النادي المغلق" الذي يُدار بعقلية "المساهمة المالية" (Shareholding)؛ ما يعني تقويض البعد القيمي للمنظومة الدولية لصالح "تسييل السيادة" وخصخصة القرار العالمي.
وفي هذا الخصوص، رصدت بعض الأدبيات الصحفية والتحليلية في الولايات المتحدة، ومن بينها صحيفة "نيويورك تايمز"، هذا التحول بوصفه إحلالًا لنموذج "المؤسسات الموازية" (Parallel Institutions) محل الشرعية الدولية التقليدية؛ إذ لا يُعد هذا المجلس مجرد أداةٍ لإدارة الأزمات الإقليمية، بل هو محاولةٌ لمركزة الجيوسياسية العالمية حول "الأحادية القطبية الشخصانية" التي تجعل من واشنطن -وشخص الرئيس- المرجعية النهائية لإنتاج المعايير الدولية. فبينما ارتكز الدور الأميركي تاريخيًّا على مفهوم "الهيمنة الليبرالية" التي تعمل من خلال التحالفات والقواعد الإجرائية، يكرّس النهج الترامبي الانتقال إلى "السيادة المطلقة" التي تمنح واشنطن حق النقض الوجودي على القوانين الناظمة للمجتمع الدولي؛ ما يفضي في المحصلة إلى تحويل "السلام" من "عقدٍ اجتماعيٍ دوليٍ" ناتجٍ عن تعددية الأطراف، إلى "امتيازٍ سياسيٍّ" حصريٍّ ينبثق عن "المركزية الأميركية" ويخضع لمعاييرها البراغماتية الصرفة.
وفي نفس السياق، يتأكد لنا من خلال تتبع مسار طرح "مجلس السلام" المزعوم إلى حين توقيع ميثاقه التأسيسي أن الضبابية المتعمدة في خطاب البيت الأبيض حول النطاق الوظيفي لهذا المجلس تضمر إستراتيجيةً لتوسيع ولايته الموضوعية؛ لتشمل إدارة الملفات الجيوسياسية المتفجرة في أوكرانيا وإيران والسودان وسورية إلخ؛ مما يجعله "سلطةً موازيةً" لمجلس الأمن الدولي وليس هيكلًا تابعًا له، ما يستدعي الاستنتاج أن هذا التوجّه يمثل انقلابًا بنيويًّا على مفهوم التعددية الدولية؛ حيث تُنتزع الشرعية من سياق "المساواة السيادية" لتقوم على "الإرادية الفردية" التي تحتكر صياغة مفهوم السلام وتحديد مستحقيه؛ مستندةً في ذلك إلى تراكم "القوّة الصلبة" المنفلتة من الضوابط القانونية، وإلى منظومةٍ من "الأنظمة التابعة" التي جرى إدماجها في شبكة التبعية السياسية والاقتصادية خلال السنوات الأخيرة؛ ما يعني الانتقال من "دبلوماسية التوافق" إلى "دبلوماسية الإملاء" القائمة على تراتبية القوّة لا على توازن المصالح.
ويأتي الموقف الأوروبي ليؤكد عمق الإشكاليات البنيوية التي تحيط بهذا الكيان؛ ففي حين حاولت مسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس إيجاد مخرجٍ براغماتيٍّ عبر إبداء الاستعداد للانضمام شريطة تقييد صلاحيات المجلس بملف غزّة وحده، جاءت تصريحات رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا لتعمق الانقسام؛ إذ كشف عن مخاوف جادةٍ وتفصيليةٍ تمس صلب "الشرعية التأسيسية" للمجلس، مشككًا في مدى توافق نطاقه الوظيفي مع ميثاق الأمم المتحدة الذي يمثل المرجعية القانونية الكونية.
إذًا، هذا التحفّظ الأوروبي يعكس إشارة سياسية واضحة تؤكد ما ذهبنا إليه، أن توسيع نطاق المجلس نحو ملفات أخرى سيعني عمليًا القبول بتهميش الأمم المتحدة والانتقال إلى نظام "مجلس فوقي" تُدار عبره الأزمات الكبرى وفق شروط البيت الأبيض.
وتتلاقى هذه التحفظات السياسية مع موقف قانوني عبّر عنه المقرر الأممي الخاص بالنظام الدولي جورج كاترو غالوس من أن الميثاق لم يتضمن أي إشارة إلى حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وأن نصف أراضي غزّة ما يزال محتلًا، ما يجعل المجلس في تناقض مباشر مع مبادئ الشرعية الدولية.
حتّى في الدوائر السياسية والبحثية الأميركية، يؤكد الدبلوماسي الأميركي هادي عمرو (باحث في معهد بروكينغز أيضًا) أن المجلس ليس إطارًا للسلام بقدر ما هو أداة سيطرة سياسية طويلة الأمد؛ فالغياب المتعمّد لأي إشارة صريحة إلى فلسطين في لوائحه التأسيسية يُحوّل النزاع من قضية سياسية معترف بها إلى مجرّد حقل اختبار إداري لسلطة دولية جديدة تعمل خارج الشرعية التاريخية، كاشفًا عن الهوّة بين منطق "التسوية الدولية" -الذي يقوم على الاعتراف المتبادل والحقوق الجماعية- ومنطق "المجلس الترامبي" الذي يختزل الصراع في ملف تقني ضمن مشروع أوسع للهيمنة، حيث تُمْحَى هويّة الأطراف الضعيفة من النص المؤسّسي ذاته لتُجْرَدَ من أي مطالب قانونيّة مستقبليّة.
من منظور الاقتصاد السياسي الدولي، لا يكتفي "مجلس السلام" بإعادة توجيه التدفقات المالية نحو هياكل خاضعة لواشنطن، بل يمارس "عملية نزع شرعية" مزدوجة، سياسيًّا وماليًّا، ضدّ منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة؛ إذ يمثل تحويل الموارد المالية إلى هذا المجلس اقتطاعًا هيكليًّا من الميزانيات المخصصة لمنظماتٍ كـ"الأونروا" وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية التي انسحبت منها واشنطن؛ فيما يجري توظيف شعارات "الحوكمة الرشيدة" و"الكفاءة الإجرائية" كغطاءٍ لتبرير "خصخصة التمويل الدولي" وحصره في قنواتٍ يسيطر البيت الأبيض على مخرجاتها.
وبالتالي، إننا أمام "هندسةٍ ماليةٍ موازيةٍ" تهدف إلى "تسييس المساعدات الإنسانية" وتحويلها إلى أدواتٍ للاصطفاف والتبعية؛ وهو ما يؤدي في الجوهر إلى تبديل مفهوم "الالتزام الدولي"؛ فبدلًا من أن يكون سعيًا لتحقيق مصالح البشرية تحت مظلة الأمم المتحدة، يتحول إلى "صك تبعيةٍ" والتزامٍ كاملٍ بمشروعٍ تسيطر عليه واشنطن وتفرضه كمسارٍ وحيدٍ لا بديل عنه.
من هنا، تبرز إشكالياتٌ كبرى حول طبيعة الدور الذي تلعبه القوى الدولية الكبرى؛ فهل باتت هذه الدول رهينةً للواقع الجديد، وأين اختفت أصواتها في مواجهة مخطّطات ترامب العابرة للحدود، وهل من الممكن أنها لم تدرك بعدُ خطورة الخلفيات الكارثية لمشروع "مجلس السلام" على سيادة بلادها. إن رفع بعض العواصم الأوروبية لصوتها في هذا التوقيت يعكس إدراكًا متأخرًا أن هذا المجلس يعيد إلى الأذهان "مشروع مارشال" في صورته الجديدة؛ فبينما بدأ ذلك المشروع تاريخيًّا تحت شعار "إعادة إعمار أوروبا"، كان هدفه الحقيقي هو فرض الهيمنة الأميركية الكاملة وربط القارة العجوز بتبعيةٍ هيكليةٍ لا فكاك منها، وهذا ما أثبتته الوقائع والأحداث حتّى يومنا هذا. وسنفصّل في مقالة لاحقة أكثر حول هذا الموضوع. واليوم، يتكرّر المشهد ذاته تحت ستار "إعمار غزّة" وإدارة أزمات العالم، بينما الغاية الحقيقية هي إحكام القبضة على القرار السيادي لتلك الدول وتحويلها إلى مجرد تروسٍ في ماكينة النظام العالمي الجديد الذي يصممه البيت الأبيض بعيدًا عن أي توازنٍ للقوى.