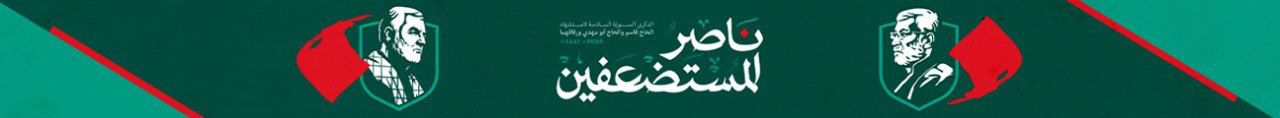مقالات مختارة

علي حيدر - صحيفة الأخبار
ترسّخ إيران معادلة ردع متراكمة في وجه التصعيد الأميركي و"الإسرائيلي"، وتفرض على خصومها توازنًا جديدًا يُقيّد خيارات الحرب المفتوحة.
تُمثّل الحرب الأخيرة التي شنّتها "إسرائيل"، بدعم مباشر من الولايات المتحدة، ضدّ إيران، محطة مفصلية في مشهد الصراع الإقليمي والدولي، ليس بسبب ضراوتها وأهدافها المعلنة فقط، بل لما كشفت عنه من حدود القوّة ومكامن الضعف لدى مختلف الأطراف أيضًا.
هكذا، بدت هذه الحرب وكأنها اختبار علني لإرادات ثلاث قوى متقابلة: "إسرائيل" الباحثة عن تحجيم خطر إيران، الولايات المتحدة المتردّدة بين التصعيد والاحتواء، وإيران المصمّمة على تثبيت معادلة الردع وعدم التفريط بثوابتها الإستراتيجية.
وإذ لم تفضِ مواجهة الـ12 يومًا إلى حسم عسكري واضح أو تغيّر جذري في موازين القوى، فإنها أفرزت معطيات بالغة الأهمية، ستشكّل أساسًا لإعادة رسم السياسات والتحالفات وخيارات المرحلة المقبلة.
حدود "الإنجاز" ومفاعيل الرد
رغم جسامة الضربات التي تلقّتها طهران، فإن المشهد العام للحرب يُظهِر فشلًا واضحًا في تحقيق الأهداف الإستراتيجية المعلَنة من جانب واشنطن وتل أبيب.
إذ لم تُفلح الحملة التي قادتها الأخيرتان في شلّ البرنامج النووي الإيراني - وفق ما تؤكّده مواقف القيادة الإيرانية وتعزّزه المؤشرات الآتية من الولايات المتحدة و"إسرائيل" -، ولا في تعطيل قدرات إيران الصاروخية وفق ما أثبتته مجريات المعركة وصولًا إلى وقف الحرب.
كما لم تُحدِث الحملة اختراقًا في البنية السياسية أو الشعبية للنظام، حيث بقيت الجمهورية الإسلامية متماسكة على المستوى الداخلي، واستطاعت أن تُعيد التموضع بسرعة عبر ردّ صاروخي كثيف لم يتأخر سوى ساعات بعد صدمة الضربة الأولى، وأثبتت بالممارسة أن مفاجأة الهجوم لا تعنى انهيار الإرادة أو الخضوع للمعادلات الجديدة.
وفي حين أحدثت الهجمات "الإسرائيلية" - الأميركية أضرارًا جسيمة في منشآت نووية واقتصادية في إيران، فإنها لم تُغيّر في جوهر الإستراتيجية الإيرانية؛ فلا طهران تنازلت عن برنامجها النووي، ولا هي رضخت لمعادلة الإخضاع التي سعت إلى فرضها "تل أبيب".
ولعلّ كلّ ذلك يجعل من نتائج المعركة مادةً أساسية في حسابات ما بعد الحرب داخل مراكز القرار الأميركية والإسرائيلية، ويفرض تساؤلات كبرى حول جدوى التصعيد والحدود الفعلية لما يمكن أن تُحققه القوّة العسكرية.
وتضاف إلى تلك التساؤلات، أخرى متصلة بالردّ الإيراني، الذي لم يأتِ ارتجاليًا ولا غرائزيًا، بل بدا نابعًا من إدراك دقيق لموازين القوى والمخاطر، وهو ما جعله مدروسًا في أهدافه وأدواته. ذلك أن إيران، وإن كانت حريصة على ضبط التصعيد – لأسباب مفهومة تتصل بحسابات الردع الكبرى –، فإنها في الوقت ذاته لم تكن مستعدّة لتصدير صورة ضعف أو تراجع؛ وهو ما تجلّى بوضوح في استهدافاتها الدقيقة للعمق "الإسرائيلي" - وتحديدًا لمنشآت حيوية -، والتي عكست تطوّرًا بارزًا في قدراتها الصاروخية وجرأتها الإستراتيجية.
وهكذا، جمعت المعادلة الإيرانية بين الردّ التصاعدي الهادف إلى إيقاف الحرب والحدّ من أضرارها ومنع انفلاشها.
الحسابات الأميركية المزدوجة
لم يتبلور قرار إدارة دونالد ترامب التدخل المباشر عبر استهداف منشآت نووية إيرانية – مثل "فوردو" و"نطنز" –، إلّا بعد الأخذ في الحسبان مجموعة اعتبارات داخلية متعارضة؛ فبينما رأى بعض صناع القرار في ذلك ضرورة لحماية أمن "إسرائيل" وتعزيز الهيبة الأميركية، عبّرت تيارات أخرى داخل المؤسسة عن قلق بالغ من احتمال التورط في حرب مفتوحة تُكرّر سيناريوات العراق وأفغانستان.
وهذا التباين هو الذي حَكَم سقف العملية، وأظهر أن خيار الحرب الشاملة لم يكن مطروحًا لدى واشنطن، بل جزءًا من معركة الرسائل السياسية بامتياز، خصوصًا أن اللجوء إليه كان سيترك تداعيات ضخمة على المصالح الأميركية في المنطقة، وصورة الولايات المتحدة في العالم الذي تخوض فيه صراعًا على الهيمنة مع الصين وروسيا.
في المقابل، أدركت طهران، منذ اللحظة الأولى، أن الانجرار إلى حرب شاملة مع واشنطن هو تحديدًا ما تسعى إليه تل أبيب، ولكن إظهار ارتداع أمام الضربات الأميركية لم يكن خيارًا بالنسبة إليها، كونه سيغري أعداءها بالمزيد من الضغط، ويعزّز سردية بنيامين نتنياهو عن أن التهديد بالحرب قادر على كبح إيران ودفعها إلى التراجع.
ومن هنا، بدا الردّ الإيراني على الانخراط الأميركي في المعركة ذا هدف مزدوج: أولًا، تفادي الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة مع الولايات المتحدة، وثانيًا، توجيه رسالة واضحة لا لبس فيها مفادها بأن استمرار الضربات الأميركية لن يمر دون ردّ، وأن قواعد واشنطن في المنطقة – مهما كانت مواقعها – لن تكون بمنأى عن الاستهداف، وأن علاقاتها بالدول العربية والإسلامية التي تتموضع فيها تلك القواعد، لن تكون حاجزًا أمام ممارسة حقها في الرد والدفاع.
بين أوهام الحسم وواقعية الردع
بالنسبة إلى "إسرائيل"، شكّل التدخل الأميركي إنجازًا سياسيًا وعسكريًا، ولكنه لم يرتقِ إلى طموح "تل أبيب" إلى أن تنخرط واشنطن في حرب مفتوحة تهدف إلى إسقاط النظام الإيراني.
كما إن الكيان الذي دائمًا ما بنى عقيدته الأمنية على فكرة "الضربة الاستباقية" و"الحسم الخاطف"، وجد نفسه أمام خصم يمتلك نفَسًا طويلًا، ويملك من أدوات الصمود والتصميم والتصعيد المحسوب ما يجعل من الحرب المفتوحة معه مغامرة محفوفة بالمخاطر.
بتعبير آخر، أسقط الرد الإيراني صورة "المهاجِم الآمن" التي اعتادت "إسرائيل" أن تتدثّر بها، وفرض عليها إعادة تقييم خياراتها، بعدما تبيّن أن معادلة الردع لم تعد حكرًا على طرف واحد. كما ظهرت "تل أبيب" عاجزة عن حسم مواجهة بهذا الحجم من دون غطاء أميركي شامل، في حين أن ما تصوّرته ضربة قاضية، تَحوّل إلى عامل تأزيم إستراتيجي، استدعى منها مراجعة عميقة لتقديراتها حول "قدرة الحسم" و"فاعلية الردع الأحادي".
باختصار، تحوّل ما بدا إنجازًا أوليًا إلى سقف جديد للردع المتبادل؛ وبدل أن تُفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من الهيمنة، وجدت "إسرائيل" نفسها إزاء توازن جديد تُدرك أنه لن يكون من السهل كسره من دون أثمان باهظة وتداعيات يصعب احتواؤها.
وهكذا، رست على الأرض معادلة "ردع بالتراكم"، الأرجح أن يكون مؤقتًا، بينما يتمّ استحداث جبهة مفتوحة غير تقليدية بين الأطراف، لن تُقفل في المدى القريب، بل يُتوقع أن تشهد تطوّرات متتالية تفرض على الجميع إعادة حساباتهم.
ذلك أن المواجهة لم تنتهِ، بل تبدّلت أدواتها، وقد تتطوّر في أي لحظة من ضربة موضعية إلى مواجهة شاملة، ما لم تقرّ واشنطن بحقوق طهران وقيود القوّة في الصراع معها.