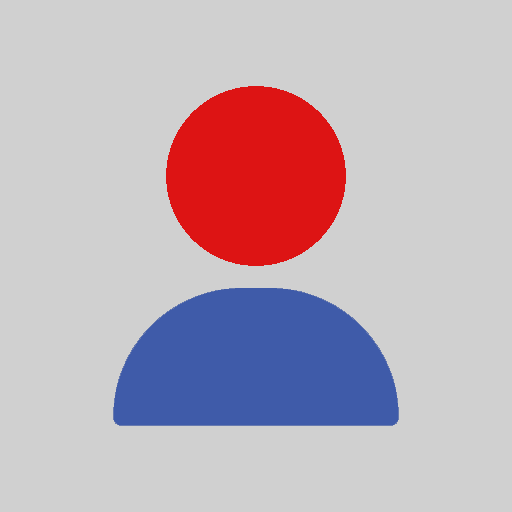مقالات
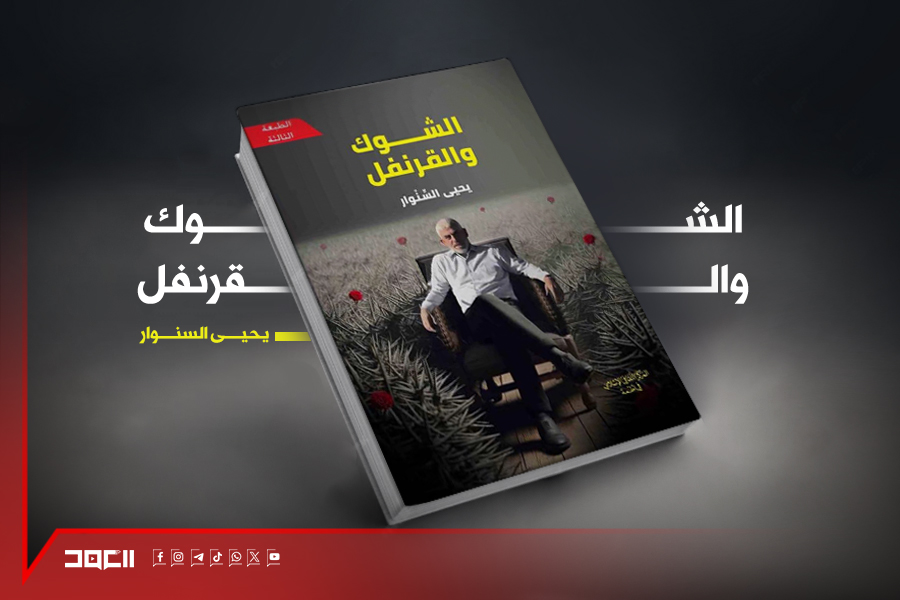
المؤلف: الأسير يحيى السنوار (أبو ابراهيم)
مراجعة: شوكت اشتي
كُتبت هذه المراجعة قبل استشهاد يحيى السنوار 16 تشرين الأول 2024
----------------
مراجعة هذا الكتاب لها طابعها الخاص والمميز. أولًا، لخصوصية المؤلف، الذي غدا رمزًا وطنيًا، ومنارة في الجهاد والكفاح والنضال على درب التحرير والعودة. ثانيًا، لخصوصية النص، بحد ذاته، كونه كُتب في السجن، بكل ما تتضمنه هذه العملية من معاناة وجهد. ثالثًا، لأن مضمون الكتاب، امتزج فيه الخاص بالعام، والذاتي بالمجموع، والأنا بالآخر، والمعاناة بالتحدي، والألم بالفرح، والفكرة بالواقع، فجّسد تجربة حية في صمود "شعب الجبارين"، في مواجهته الاحتلال وأعوانه. رابعًا، لأنه يؤكد عمق الالتزام بفلسطين، قضية وشعبًا وهوية، وأن سنوات الاحتلال لا تستطيع، ولن تستطيع، أن تمحو فلسطين من الذاكرة والذهن والفكر والقلب والعقل، الأمر الذي يجعل الأجيال الطالعة أكثر تمسكًا بالقضية، وأكثر انغراسًا في الأرض، وأكثر مقدرة على التصدي والإبداع. ولعل ما يجري، في هذه اللحظة السياسية، في قطاع عزة، والضفة الغربية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة جماعية من قوات الاحتلال الصهيونية وحلفائها، دليل على عظمة هذا الشعب، وثبات أجياله، جيلاً بعد جيل، خامسًا، لأنه من الصعوبة الفصل في هذه المراجعة، بين الحاضر الذي يعيشه المؤلف، وأهالي قطاع غزة، بآلامه المُطلقة من جهة، وبين الماضي الذي عاشه المؤلف وأهالي القطاع من جهة ثانية. فإذا كانت هذه الرواية/السيرة، بأحداثها ووقائعها ومعطياتها، لمحة خاطفة عن ماضٍ مضى، فمن غير الممكن فصل هذا الماضي عن مآسي اللحظة وويلاتها. لذلك فإن متابعة هذا التداخل ليس بالأمر السهل، لغزارة معطياته وتعددها.
من هنا سنتابع مضمون الكتاب، بالدرجة الأولى، الذي يمتد على ثلاثين فصلًا، دون الإشارة إلى الملاحظات الشكلية، أو إلى أي مدى يُراعي الكتاب مُستلزمات العمل الروائي، محاولين الولوج إلى تفاصيله، وأحداثه، والمعطيات التي يُقدمها، لإلقاء الضوء على مرحلة تاريخية، اختزنت العديد من الكوارث بدءًا من النكبة عام 1948، وأسست لمسار نضالي يتصاعد يومًا بعد يوم، باتجاه التحرير والعودة.
التعريف بالمؤلف
استنادًا إلى ما ورد في الصفحة الأولى من الكتاب، فالمؤلف فلسطيني من عائلة هُجّرت من مدينة عسقلان عام 1948، إلى قطاع غزة. ولد عام 1962 في مخيم خان يونس، حائز على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها من الجامعة الإسلامية في غزة، وهو من الذين رفعوا لواء المقاومة الإسلامية في فلسطين.
سُجن مطلع عام 1988، وحُكم عليه بالسجن أربعة مؤبدات، و25 سنة، أي ما يزيد عن (430) سنة، لقتله أربعة عملاء للاحتلال، ما يمكن إضافته أن يحيى السنوار قضى في السجن حوالي ثلاثة وعشرين عامًا، وأفرج عنه في عملية تبادل الأسرى عام 2011، المعروفة بصفقة "جلعاد شاليط"، الجندي الصهيوني الذي أسرته حركة حماس لمبادلته بالمعتقلين في السجون الصهيونية.
التعريف بالكتاب
يرد في بداية الكتاب، أن هذه الرواية كُتبت "في ظلمة الأسر في سجن الاحتلال في فلسطين"، حيث عمل العشرات، كخلية نحل، لنسخها، ومحاولة إخفائها عن عيون الجلادين، وأيديهم الملوثة، "لإخراجها إلى النور"، " صهر" فيها المؤلف ذكرياته، و"قصة شعبه"، وما عاناه من آلام وأمال.
إنها قصة " كل فلسطيني وقصة كل الفلسطينيين"، في عمل درامي أحداثه حقيقية، وشخصياته في غالبيتها خيالية، وبعضها حقيقي. تتضمن معظم "المحطات الأساسية في تاريخ الشعب الفلسطيني منذ نكسة 1967، وحتى بدايات انتفاضة الأقصى المباركة". وتُشير المقدمة المختصرة جدًا، والموقعة باسم يحيى ابراهيم السنوار، سجن بئر السبع 2004، إلى أن هذه الرواية "ليست قصتي الشخصية وليست قصة شخص بعينه". أحداثها حقيقية، " تخص هذا الفلسطيني أو ذاك"، عاشها المؤلف، أو سمعها من "أفواه من عاشوا هذه الأحداث على مدار عشرات السنوات على أرض فلسطين الحبيبة".
من هنا يُهدي المؤلف هذه الرواية إلى "من تعلقت أفئدتهم بأرض الإسراء والمعراج من المحيط إلى الخليج، بل من المحيط إلى المحيط".
لذلك فإن هذه التعريف "المُختصر"، يبدو كافيًا، وواضحًا، ودقيقًا، ممّا يجعل القارئ على دراية بما سيطّلع عليه، دون إغراقه بالتعابير الفضفاضة، أو الإفاضة في الشرح والتطويل. لذلك سيلاحظ قارئ الكتاب الدقة في التعابير، والاختصار في التوضيح، والتكثيف في السرد، والغنى في الأحداث، وتنوع المواقع، وغزارة المعطيات، والسلاسة في العرض، الأمر الذي يجعل المُتابع مشدُودًا للنص، وأحداثه، بآلامها وانفراجاتها، بأحزانها وأفراحها، بأثقالها وابتساماتها، "مصدومًا"، بهذا الكم من المواقف والأحداث والأماكن، والأفكار ومسارات التعامل معها، في تلك المرحلة التي أعقبت هزيمة الخامس من حزيران، حيث يُبيّن متن الكتاب مستوى القهر والقمع والعنف الذي مارسته قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين. ورغم كل العذابات والحصارات، والتنكيل بقي شعب الجبارين عصيًا على القهر والإذلال. فما هي المسارات التي عاشها السنوار؟ وما طبيعة البيئة التي نشأ فيها؟ وكيف ترعرع وتشكل؟
عنوان الكتاب
قد يكون العنوان الرئيس للكتاب، موضوع المراجعة، أولى مميزاته. فعلاقة الشوك بالقرنفل مُثيرة للتساؤل، والدهشة. لأن زهرة القرنفل، من حيث المبدأ، دلالة على المحبة والتميز، ولها عدة ألوان، ولكل لون دلالته، فاللون الأبيض يدل على الوفاء، والأحمر الفاتح على الإعجاب والحب الشديد، والأحمر الوردي دلالة على حب الأم. لذلك يُقدم القرنفل في المناسبات، كما يُستعمل للزينة.
بينما الشوك على النقيض من كل هذا الدلالات والمعاني، ويرتبط بالألم، والمعاناة، والقسوة، ولا يرتبط بأي شكل من الأشكال بالمحبة، ممّا يجعل من الشخص الذي يتحمل وخز الشوك، وألمه، وعذاباته، نموذجًا يُحتذى بالتضحية، والصمود، والصبر. من هنا، يمكن القول: إن جمع هاذين المتناقضين، الشوك والقرنفل، له دلالاته، ومعانيه، فالطريق الذي سلكه الفلسطينيون، كشعب وأشخاص، كان ولا زال، مزروعًا بالشوك، ومُعّبدًا بالمعاناة، ومجبولًا بالألم، إنه الطريق الصعب باتجاه زهرة القرنفل، حيث المحبة والسعادة، خاصة وأن لون زهرة القرنفل على غلاف الكتاب هو الأحمر.
من مُميزات الكتاب
ينساق القارئ، بسهولة ودون أي عناء، لمتابعة الكتاب، موضوع المراجعة، وتقليب صفحاته بشيء من الحماسة لمعرفة ما يتضمنه، وما سيعرضه المؤلف، أو يخفيه في ثنايا النص. فالعبارات مُعبرة، والصياغة مترابطة، والأفكار واضحة، والعرض متسلسل، والموضوع حاضر بقوة، ومتوهج بتألق، وساطع بعزة وشموخ، ممّا يجعل الانجذاب للنص ومتابعته يبدو أمرًا بديهيًا. انطلاقًا من هذا التوصيف يمكن، وباختصار شديد، الإشارة إلى بعض مميزات الكتاب، موضوع المراجعة، على النحو الاتي:
- المؤلف ومكان الكتابة: إن اسم المؤلف يجعل للكتاب طابعه الخاص والمميز. لأن الرغبة شديدة، ومبررة، في الوقت ذاته، للاطلاع على تجربة هذا القائد المميز، ودوره الرائد، وتفاصيل حياته، ومساراتها. إضافة إلى أن تأليف الكتاب كان في السجن (سجن بئر السبع )، ممّا يُعطى هذا الكتاب ميزته الخاصة، كونه كُتب في ظروف غير طبيعة بالكامل، وتم تهريبه من السجن ليصل إلى الناس، قبل أن تعرف به قوات الاحتلال وتصادره.
- تلخيص مكثّف: إن السيرة الذاتية التي يعرضها المؤلف، تكاد تُلخص حياة شعب بأسره، عاشها في مخيمات اللجوء، بكل ما تتضمنه هذه الحياة من ألم، وقسوة، ومعاناة، فمن جهة يوضّح العادات والتقاليد، ومن جهة ثانية يُبيّن نمط الحياة، وطبيعتها في المخيمات، وأوضاع العائلات المعيشية، وعمق معاناتهم، وإصرارهم على تعليم أبنائهم، والعلاقات الحميمية التي تربط الجيران في المخيم، وعادات الزواج، والعلاقة بين الشباب، والشابات، وأوضاع المدارس، وظروف العمل
ومن جهة ثالثة يكشف النقاش السياسي بين التيار الإسلامي (حماس والجهاد)، والقوى الوطنية (فتح والشعبية،) ومواضيعه، ومن جهة رابعة يُفصّل في مسار العمليات الفدائية ضد قوات الاحتلال ورموزها، ومن جهة خامسة يستعرض أحداث الانتفاضة في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، وعنف قوات الاحتلال، ومن جهة سادسة يُوصّف عمل أجهزة مخابرات العدو، وتجنيد العملاء، ومسار الاعتقالات المتكررة لأبناء المخيم، والزيارات الدورية للمعتقلين، وأحوال المساجين داخل السجن، وعُنف التحقيق معهم، وطعامهم، وفترات تنشق الهواء، ومن جهة سابعة يُعرّفنا على التنشئة السياسية، والالتفاف الشعبي حول المقاومة، وما زرعته في أبنائها، والأجيال الطالعة، من إيمان بالقضية، والتزام بالمقاومة، والعمل الحثيث لإحقاق الحق واسترجاع الأرض السليبة، رغم كل الظروف المعاندة، والأوضاع المُعاكسة، والقوى المُعادية، إضافة إلى العديد من المسائل التي يمكن متابعتها في سياق هذه المرجعة، الأمر الذي يدفع إلى القول: إن الكتاب، أقرب لأن يكون وثيقة عن مرحلة، وإطلالة على مرحلة أخرى، نستعيد من خلال هاتين المرحلتين تأكيد المؤكد، بأن إيمان الشعب الفلسطيني، لا زال مُشعًا، وكفاحه لا زال مستمرًا دون كلل، أو ملل.
- تداخل الماضي بالحاضر: إن أحداث اللحظة، غير الإنسانية، التي يعيشها قطاع غزة اليوم، تحضر بقوة عند متابعة أحداث الماضي التي تطرق إليها الكتاب. وهذا لا يعني، مُطلقًا، أن التاريخ يُعيد نفسه، بل يعني أن المعركة لا تزال مستمرة، فالعدو، وحلفاؤه، لا زالوا في السياسة ذاتها، لكن بوحشية أشرس، تخطت كل المعاير الانسانية، والالتزامات الدولية، وكشفت زيف شعارات الدول "المتحضرة" في الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان. لكن بالمقابل، فإن التصدي لا زال صلبًا. بل إن ما نتابعه في قطاع غزة صمود أسطوري، وغير مسبوق، من حيث المبدأ، تاريخيًا، بوجه الحرب العالمية التي يشنها العدو الصهيوني، وحلفائه "المتحضرين"، ضد قطاع غزة والضفة الغربية. لذلك سيُلاحظ القارئ أن متابعته هذا الكتاب، تجعل صورة اللحظة المؤلمة ساطعة في أحداث الماضي، وهذه ميزة خاصة في الكتاب.
- علاقة الديني بالسياسي: ما يمكن الإشارة إليه، في سياق مميزات الكتاب، موضوع المراجعة، فكرة لا زالت موضوعًا للنقاش والجدل، تتلخص في العلاقة بين الديني والسياسي. فقد طرحها المؤلف، بشكل عابر ومباشر في سياق المتن، غير أنها تكشف بعض أسرار صمود اللحظة وجذورها من جهة، وتُلخص، بدقة، الخلفية الفكرية للمؤلف من جهة ثانية.
تتجسد الفكرة، كما وردت في النص، في أن "الربط بين الدين والوطني "مزيج غريب لم نسمع به من قبل، فالساحة الفلسطينية اعتادت أن ترى في الآونة الأخيرة، إما "الشيخ أو المتدين الذي لا علاقة له بالواقع والهم الوطني، وإما الوطني أو الفدائي الذي لا علاقة له بالدين ولا بالتدين". هذه العلاقة قد تكون مقطوعة بين "الشيخ والسياسي"، لكنها في الواقع قائمة وموضعًا خلافيًا. بل إن هذه الفكرة، كانت، ولا زالت، مولدة للتوترات والأزمات بين القوى والتيارات السياسية والفكرية. لذلك مناقشتها، رغم أهميتها، تبدو خارج هذه المراجعة. لكن الإشارة إليها، في متن الكتاب من جهة، ومتابعة الإطار التنظيمي والعقائدي للمؤلف من جهة أخرى، تُبيّن إن حركة "حماس" تلتزم، عمليًا، وتسعى في سياساتها لإقامة التوازن بين طرفي هذه الفكرة/العلاقة.
- غياب الأنا: من النادر، إذا لم نقل من المستحيل، أن يغيب الكاتب عن سيرته الذاتية. فهل يمكن أن لا تتضمن السيرة الذاتية، أو تُبيّن موقع الكاتب، وأهمية دوره، والمواقع التي تصدرها، والأدوار التي قام بها.؟ هذه الميزة قد تنحصر في الكتاب، موضوع المراجعة، بحيث لا يُقدم يحيى السنوار في متن الكتاب أي شيء يُميزه، أو يؤشر إلى دوره، ولا يُظهر أن وجوده هو الأساس، أو كان المفصل في الأحداث وهذا مُعاكس، مبدئيًا، لكل السير الذاتية. من هنا فالكاتب، يحيى السنوار، غير مُدّعٍ، أو مُتبجح، أو مغرور، ولا يُعيد الأحداث إليه، ويُعطي للآخرين دورهم، ويكشف فضلهم، ويُعلن بطولاتهم، ويعتز بمعرفتهم دون أي ادعاء، أو تضخيم للذات، أو مصادرة الأحداث، أو تطاول على الكرامات، أو تهميش أحد من هنا يمكن القول: إن هذه ميزة مميزة، ونادرة في كتابة السير الذاتية.
إن هذه المميزات، وغيرها العديد، لها دلالاتها، على أكثر من صعيد، خاصة على صعيد العلاقة "المتوترة" بين الفصائل الفلسطينية، في تلك المرحلة، والتي لا تزال تتمظهر بأشكال متعددة في هذه الايام، الأمر الذي يترك تداعياته السلبية على مسار العمل باتجاه التحرير والعودة.
انطلاقا مما تقدم، ماذا يتضمن الكتاب؟ وما هي أبرز القضايا التي يمكن الإشارة إليها؟ وما هي الظروف التي عاشها الطفل يحيى السنوار، وأهالي المخيم؟
الطفولة والمعاناة
الأوضاع الحياتية التي يعيشها اللاجئون في المخيمات هي خارج المنطق الإنساني، الأمر الذي يجعل الأطفال محرومين من طفولتهم، ويجعل الأهل في مأزق كبير. لا يستطيع الطفل أن يعي بالضرورة ما يجري حوله، غير أنه قادر على مشاهدته والتعايش معه، دون مقدرة على فهمه واستيعابه. لكن عقله الباطني، واللاوعي لديه، يختزن ما يشاهده ويُعايشه، ليكون له نتائج، مباشرة وغير مباشرة، في المراحل العمرية اللاحقة. هذه الوضعية عاشها يحيى السنوار الطفل، كغيره من أبناء المخيمات.
من هنا يستعرض الكتاب، موضوع المراجعة، العديد من تفاصيل الحياة في المخيم، وقساوتها وعمق معاناتها فقساوة الشتاء، وغزارة الأمطار، مثلًا، كانت تُغرق أزقة مخيم الشاطئ في غزة، وتحوّل غالبية "البيوت" إلى "بُرك"، في الليل والنهار فيجتهد الأهل لتجميع المياه المتسربة من شقوق الأسقف، بما تيسر من الأدوات المتوفرة (طناجر، أوعية، أباريق...) لحماية الأطفال وكبار السن... كما يُعايش مُداهمات قوات الاحتلال للبيوت، وحملات الاعتقالات، وشظف العيش.
الطفل هنا يُعاني، ويسمع، ويختزن في ذاكرته قسوة الحياة وآلامها. لكن الطفولة هنا لا تساعده على الاستيعاب والإدراك والوعي. هذه الوضعية، بتفاصيلها، استقرت في الذاكرة وشمًا، وكانت من العوامل التي شكلت الشخصية وبلورتها.
عندما كان يحيى في الخامسة من عمره، وقعت هزيمة الخامس من حزيران العام1967. غير أنه لم يكن يعي ما يجري حوله، لكنه شعر أن الجميع في وضع أسواء بكثير من أيام الليالي الماطرة وقساوتها، أو المداهمات وعنفها. فقد عمد الوالد إلى حفر حفرة عميقة، في ساحة الدار، وقام بتغطيتها بقطع من الخشب، وألواح "الصاج والزنكو"، فتحولت إلى ما يُشبه الغرفة المُظلمة تحت الأرض، حُشر فيها الجميع، ومُنع عنهم الخروج، والحركة، والوالدة، أو زوجة عمه "تصرُخان، يا أولاد الدنيا حرب ألا تعرفون معنى الحرب". غير أن يحيى لم يكن يعرف معنى الحرب، لكنه أدرك باكرًا، أنها "شيء مُخيف غير عادي ومظلم وخانق".
شدّت انتباهه البندقية التي كان عمه ابراهيم يقوم بـ"إصلاحها"، كان نظر يحيى "يتركز عليها طيلة الوقت"، فعمد عمه إلى وضعها على يديه، والتحدث معه بكلام لم يفهمه. حتى الجنود المصريون المتواجدون في معسكرهم على أطراف المخيم، والذين كانوا يرحبون به وبابن عمه، صرخوا عليهما طالبين منهما الابتعاد والعودة إلى بيوتهما. ماذا يجري؟ ولماذا هذا التغيير المفاجئ؟ ولماذا هذا الاضطراب في المحيط كله؟.
جارتهم المعلمة عائشة، المتحصنة بالراديو، تنقل الأخبار، فيزداد الجو حزنًا واكتئابًا، وتصريحات "أحمد سعيد" النارية في صوت العرب من القاهرة عن "إلقاء اليهود في البحر" والتهديدات ضد دولة الكيان تضعف وتتلاشى، وأحلام الأهل بالعودة إلى الديار تنهار كقصور الرمل التي اعتاد يحيى ورفاقه بناءها أثناء اللعب.
النكسة وانهيار الأحلام
استمرت هذه الأجواء عدة أيام، لم يُعّكرها إلا اندفاع الناس في مطاردة جاسوس، له علاقة باليهود. لكن سرعان ما انهارت المعلمة عائشة، بعد سماعها نشرة الأخبار، وبدأت تغمغم "اليهود احتلوا البلاد"، فساد الصمت، وبدأ الخروج من الخنادق، و"تنشق الهواء الطبيعي"، المُعبّق برائحة البارود، وغبار البيوت التي تهدمت.
جده، والد والده، الذي رفض النزول إلى الحفرة/الخندق، كان يأمل في بداية الحرب، بالعودة إلى الفلوجة، لكن مع انفراج الأوضاع على النكسة، أعلن أنه لم يعد "هناك طعم أو قيمة للحياة" . وفي اليوم التالي، بدأت تدب الحركة في أزقة المخيم، والكل يسعى للاطمئنان عن عائلته ومسكنه، وأوضاع الآخرين.
غير أن والده الذي خرج ضمن "المقاومة الشعبية"، وعمه ابراهيم المُجند في "جيش تحرير فلسطين"، لم يعودا سالمين إلى عائلتهما، فهما كالعديد من أهالي المخيم المفقودين، والذين لا يُعرف عنهم أي شيء، ممّا زاد الألم والقلق. لكن في غروب أحد الأيام عاد الجد متعبًا، مرهقًا، دموعه تغمر وجهه، ساعَدوه لإدخاله البيت، نظراته إلى زوجة ابنه، جعلها تنفجر بالبكاء، فصرخت هل مات زوجي؟ فرد الجد "لم يمت يا أم حسن بل استشهد".
أما بالنسبة للوالد، فلا يوجد أي خبر شافٍ عن مصيره، والأسئلة حول مصيره بقيت دون إجابات مُقنعة وواضحة. هناك من يؤكد أنه ما زال على قيد الحياة، حيث انسحب مع مجموعة من المقاومة الشعبية باتجاه الجنوب. غير أن الجد لم يمل من السؤال، وقرّر الانتظار، بل كان على الجميع الانتظار، والتكيف مع الحياة، لتأخذ مساراتها. يحيى يراقب ما يحدث، وغير قادر على معرفة حقيقة ما يجري بالضبط، فيتسمر في مكانه، لا يدري ماذا يحدث. هذه المحطات الفاقعة بآلامها، وعمق قسوتها، ستنغرس في ذهن الطفل، وذاكرته، ولا وعيه، وعقله، مثل شجر الزيتون في أرض فلسطين، التي تزداد مع الأيام شموخًا، وعطاءً، ورسوخًا، وثباتًا، وهذا ما يجري اليوم بالنسبة لأطفال غزة، وإن كانت التجربة أكثر هولًا، وفظاعة، وإجرامًا، ودموية، وقتلًا، وتدميرًا.
خداع المقاومين
خلال المواجهات، انسحبت قوات الاحتلال بعد أن واجهت مقاومة عنيفة في إحدى المناطق، وسرعان ما أطلت مجموعة من الدبابات وسيارات الجيب العسكرية، ترفرف عليها الأعلام المصرية. فخرج المقاومون من خنادقهم، احتفالًا بالقادمين. لكن سرعان ما فُتحت نيران كثيفة باتجاه المقاومين، أردتهم قتلى، وعمدت هذه الآليات وبسرعة إلى رفع "العلم الإسرائيلي"، بدلًا من الأعلام المصرية، فوقع المقاومون في الخدعة وأصابتهم بمقتل. من هنا بدأ الاحتلال، وأشكال جديدة من المعاناة والقمع من جهة، وآفاق جديدة للتحدي ومواجهة الاحتلال من جهة أخرى.
من الواضح أن مجريات الأحداث، تركت أثرها في الطفل، عندما أصبح مجاهدًا، وقائدًا مميزًا في صفوف المقاومة الفلسطينية. وما نُلاحظه في حرب الإبادة الجماعية العالمية التي يشنها جيش الاحتلال الصهيوني، وداعموه، ضد قطاع غزة، أن جنود قوات الاحتلال هم الذين يقعون اليوم في الكمائن التي ينصبها المقاومون، ولم تعد تنطلي على المقاومين الخِدع الصهيونية، من حيث المبدأ.
الشيخ يتوقع
كان يحيى في كثير من الأوقات يستيقظ على صوت جده مع بزوغ الفجر وهو يدعو أثناء الوضوء، ويتمتع بصوته وهو يقرأ الفاتحة، ثم شيئًا من القرآن الكريم. وبدأ مع تكرار الأيام يكاد يحفظ ما يردده الجد، الذي لا يستطيع أداء صلاة الفجر في المسجد، لأن منع التجول يكون لا يزال ساريًا (من السابعة مساءً حتى الخامسة صباحًا)، ومن يخرج يُعرّض نفسه للموت، من دوريات الاحتلال التي كانت تجوب المخيم.
كان جده في الكثير من الأوقات يصطحبه إلى المسجد، فيجلس يحيى إلى جواره، ويقلده في الوضوء والصلاة، والشيخ حامد يبتسم، ويقول للجد: إن شاء الله سيكون هذا الولد متدينًا، فيتمتم جده قائلا: "إن شاء الله".
بدايات المقاومة
مع بدايات الاحتلال فُرض منع التجول اليومي في الليل، "لضبط" الوضع الأمني، والحؤول دون القيام بعمليات فدائية. وقد بدأ بعض رجال المقاومة من مرحلة ما قبل الخامس من حزيران (قوات جيش تحرير فلسطين، قوات التحرير الشعبية)، بتجميع أنفسهم، وتنظيم قدراتهم لمواجهة الاحتلال، فاجتمع سبعة رجال ليلًا في دار خال يحيى، لأنه سيكون مع عائلته خارج الدار كونه سيرافق أخته التي ستتزوج إلى منطقة الخليل، وسيترك لهم مفتاح البيت تحت العتبة. وبعد انتهاء الاجتماع، والاتفاق على الخطوات التالية، تسللّوا من الدار واحدًا تلو الآخر، وهم يرددّون: (جعلنا من بين أيديهم سدًا ومن خلفهم سدًا فأغشيناهم فهم لا يُبصرون).
كما كان بعض المجاهدين يعيشون في المغاور في الجبال، يخرجون بين الحين والآخر لمهاجمة دوريات المحتل، ثم يلجؤون إلى الجبال مرة أخرى، حيث لا تجرؤ قوات الاحتلال على التوغل في تلك المناطق الوعرة. وكان المجاهد "أبو شرار" أشهرهم، فهو "الذي أطار النوم من جنود المحتلين في تلك المناطق."
من هنا فإن حركة المقاومة لم تهدأ في المخيم، وبدأت تأخذ إطارًا أكثر تنظيمًا، وفاعلية، الأمر الذي وسّع فترات منع التجول، لتأخذ في بعض الأوقات عدة أيام، فتتعطل المدارس، وتتوقف الحركة في المخيم، بشكل كامل، الأمر الذي يجعل قوات الاحتلال تقوم بإطلاق النار عشوائيًا على الأهالي، بما تُلحقه هذه الإجراءات من جرحى وشهداء، كما تعمد إلى تجميع الرجال في ساحة المدرسة، بشكل مُهين، وتتخذ ضدهم كل أنواع القمع والبطش والتنكيل.
بدأ الطفل أكثر قدرة على إدراك ما يدور حوله، ورغم تشابه الأيام فإن الجديد كان انطلاق المقاومة. ففي كل يوم عملية، إطلاق نار على دوريات الاحتلال، أو إلقاء قنابل يدوية، أو تفجير عبوات... وفي كل مرة يرد جنود الاحتلال بمنتهى القوة والعنف ضد الأهالي المدنيين العُزّل، ويُطلقون النار عشوائيًا، فيُقتل ويُصاب عدد من الأهالي، وتأتي التعزيزات، ويُفرض منع التجول مُجددًّا لدرجة أن حظر التجول أصبح "مجرد أكذوبة" لا تنطلي على الصغار.
أصبحت المقاومة تزداد قوة، ويشتد عودها، وتغدو أكثر جراءة وإقدامًا. ورجال المقاومة هم الذين كانوا "يحتلون" المخيم ليلًا، ودوريات الاحتلال لا تستطيع دخوله، ومع طلوع النهار يختفي رجال المقاومة. لدرجة أصبح الأهالي يشاهدون بعض الرجال الملثمين بالكوفيات، يحملون الأسلحة، أو القنابل اليدوية، ويتجولون في أزقة المخيم، مع بدايات الليل. فرغم قسوة منع التجول، الذي قد يمتد بعد إحدى عمليات المقاومة أسبوعًا كاملًا، كان الأهالي يعيشون في أوضاع صعبة، وأكلهم في "أحسن الأحوال"، البيصارة، والفول، والعدس، والزيتون، ممزوجًا بالخوف. غير أنه كان "ألذ ما أكلنا من طعام منذ بدء الاحتلال، فقد شعر الجميع بالعزة تحت حماية بنادق المقاومة".
كان الأهالي يشعرون مع المقاومة بالعزة والكرامة، غير أنهم متخوفون من الآتي المجهول: هل سيبقى الوضع على ما هو عليه؟ أم ستقتحم قوات الاحتلال المخيم بقوات كبيرة؟ أم يقصفونه بالمدافع؟ أم يحرقونه على رؤوس من فيه؟ تباينت الآراء. لكن الرأي الذي يُجمعون عليه هو ضرورة الصمود. فليس لديهم ما يخسرونه إلا القيد، ودار الوكالة. فعلام الخوف؟ هكذا كانت تنتهي الأحاديث بين سكان المخيم، وكافة المخيمات في قطاع غزة، وفي المدن والقرى، والضفة الغربية، فالإجماع يتمثل في القول: يا راجل أي والله حياة بعزة وكرامة ولا ألف سنة زي الزفت تحت بساطير جنود الاحتلال، فتسري أخبار المقاومة سريان النار في الهشيم.
كان مخيم الشاطئ، كما غيره، مكانًا ممنوعًا على جيش الاحتلال، رغم نظام منع التجول، خشية تواجد الفدائيين. هذه المعضلة الدائمة، والمُكلفة للاحتلال، دفعته إلى تقسيم المخيم الواحد إلى عدة مربعات، من خلال شق الطرقات الواسعة، ممّا يُسّهل حركة قواته، الأمر الذي أثقل حركة المقاومة والفدائيين، وإن لم يُلغِ تواجدهم في بعض الأزقة. لذلك عَمد الأهالي، صغيرهم، وكبيرهم لحماية رجال المقاومة، بأن يقوم من يشاهد قوات الاحتلال قريبة، أو في أحد الأزقة، بالهتاف بصوت عالٍ "بيعوا"، وكل من يسمع الكلمة يردّد بصوت عالٍ أيضًا: (بيعوا، بيعوا، بيعوا وارتح منو)، وذلك للفت انتباه الفدائيين. ومع الوقت تحول هذا الهتاف إلى نوع من نشيد شعبي، يردده الطلاب، والطالبات وهم في طريقهم إلى المدارس، مع إضافة، (بيعوا، بيعوا، بيعوا، وإرتح منو، الصندل أحسن منو)، والمقصود السلاح الذي يحمله جنود الاحتلال.
المقاومة مناطقيًا
امتدت أعمال المقاومة إلى مختلف المناطق، وإن بنسب مختلفة، وكان حضورها في قطاع غزة أكثر تأثيرًا وفاعلية.
عمدت حركة "فتح" إلى بدء عملها التنظيمي في المدن ومحيطها، وكانت منطقة الخليل نموذجًا حيًا، غير أن النجاحات في الخليل كانت محدودة، لأن المحتلين كانوا يقومون بعمليات اعتقال دائمة ومستمرة من جهة، كما إن انشغال الناس بأمور حياتهم اليومية، والانتاج الاقتصادي، لعله حال دون تحقيق النجاح المطلوب، أو المرتجى من جهة ثانية. غير أن هذا لم يمنع حركة الاحتجاجات السياسية التي كان ينظمها المؤيدون لحركة "فتح”، خاصة في الأوساط الطلابية. كما كانت هناك محاولات لبدء العمل من قبل "الجبهة الشعبية". غير أن التركيز انصب أكثر على العمل السياسي والشعبي، وبعض الأنشطة الاجتماعية.
أما في قطاع غزة، فقد كانت الأمور مختلفة لأن "قوات التحرير الشعبية"، كان لها جذورها الأصيلة، وكانت، من حيث المبدأ، "التجمع المقاوم الأكبر"، ثم بدأت مجموعات لحركة "فتح" و"الجبهة الشعبية" بالتواجد. ومع ازدياد عمليات المقاومة، توسعت دائرة اعتقال الرجال والشباب، حيث كان المعتقلون يخضعون لشتى أنواع التعذيب، والإذلال، والقهر، والمعاملة غير الإنسانية من قوات الاحتلال، للحصول على المعلومات، أو لإغراء البعض بالتعامل مع الاحتلال.
إن حضور المقاومة في قطاع غزة، بشكل أقوى مما هي عليه في الضفة الغربية، سببه الرئيسي يعود إلى أن كتيبة من "جيش تحرير فلسطين" كانت متواجدة في القطاع قبل النكسة. هذا الجيش نشأ بدعم من الأنظمة العربية، ليكون قوة عسكرية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية"، فيُخفّف عن كاهل هذه الأنظمة عبء المسؤولية تجاه فلسطين. غير أنه تفكك مع حرب 1967، حيث استشهد بعض عناصره، والغالبية غادرت إلى مصر، ومن بقي أنشأ "قوات التحرير الشعبية"، التي بدأت المقاومة باكرًا، ولحقتها بعض المجموعات من حركة "فتح" و"الجبهة الشعبية". وقد فتحت معركة الكرامة، في الاردن، المجال واسعًا لتتقدم حركة "فتح"، لاحقًا، وتتبوأ الصدارة في قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية، ومقاومة الاحتلال.
المقاومة موضوعًا خلافيًا
فكرة المقاومة كانت حاضرة، ومُتجسدة سلوكًا حيًا. غير أن الفكرة وممارستها لم تكن موضع إجماع بين الأهالي، والمناطق.
في الخليل، مثلًا، لم يكن هناك إيمان كبير بجدوى المقاومة وإمكانية تحقيق أية فائدة عملية من ورائها. ويوم يجتمع، بعض الوجهاء والميسورين في المقهى لارتشاف الشاي، والحديث، يتوافقون، من حيث المبدأ، على أن المقاومة ظاهرة تضر أكثر مما تنفع. لأن الاهتمام الأكبر بالنسبة لهم هو رفع مستوى الحياة، والارتقاء بها، وتحقيق الكسب الاقتصادي، وتنمية الثروات...، هذا "المنطق" يستند إلى مقولة، أن "جيوش الدول العربية كلها، بقضها وقضيضها لم تفلح في الوقوف في وجه الجيش "الإسرائيلي"، فكيف يمكن أن يقف بوجهها مجموعات من الفدائيين بأسلحتهم البسيطة ومكاناتهم المحدودة؟". زوج خالته، وصديقه (أبو علي) لم يكونا، من هذا الرأي، لأنه من الضرورة القيام بالواجب الوطني، ومقاومة الاحتلال، ورفض التسليم بالأمر الواقع، ولا يجب الانشغال بكسب المال، وتنمية الثروات، وبناء المنازل، فقط.
هذا الموقف، من المقاومة، لم يكن ساريًا في قطاع غزة، من حيث المبدأ، لأن العمليات ضد الاحتلال بدأت مُبكرًا.
نتيجة الثقة بين الرجلين، سافر أبوعلي إلى الاردن، وعرض الفكرة على حركة "فتح"، مُموّهًا سفره بأعماله التجارية. من هنا بدأت عملية تنظيم الصفوف، وتشكيل الخلايا، في الضفة الغربية وحتى الخليل، وبعض القرى. وتكلف عبد الفتاح، زوج خالته، بجمع السلاح، مُموهًا نشاطه بطبيعة عمله التجاري.
بدأت عمليات المقاومة البسيطة (إلقاء قنابل يدوية، إطلاق النار)، لكن ككل عمل مقاوم، تقع إحدى الخلايا في خلل، ممّا يؤدي لاعتقال أفرادها، وتحت شتى أنواع التعذيب الرهيبة، تبدأ الاعترافات، وتتسع دائرة الاعتقالات، إلى أن وصلت إلى أبو علي (حُكم بالسجن خمس سنوات) أولًا، ومن ثم عبد الفتاح (حُكم إداريًا ستة أشهر، دون توجيه أي تهمة).
وعليه، زاد عدد الخلايا على امتداد مدن وقرى وخِرب الضفة الغربية، وغدت بطون الأودية، والجبال الشاهقة أماكن للتدريب على استخدام السلاح. بالمقابل، بقي التجار الذين يلتقون في المقهى، لارتشاف الشاي، والحديث، عن المقاومة والمقاومين، على حالهم. فقد اعتبروا أن سجن أبو علي وعبد الفتاح دليل على عدم جدوى عملهما في مقاومة الاحتلال، لأنهما، كما غيرهما، أضاعا فترة ليست بسيطة من عمرهما، وسوف يخسر عبد الفتاح مئات الليرات "الإسرائيلية" بسبب حبسه، إضافة إلى البهدلة، وقلة القيمة، له وللأهل. هذه النظرة السلبية، غير مقتصرة على مرحلة دون أخرى، ممّا يجعل التحديات التي تواجه المقاومة، غير محصورة في قوات الاحتلال، بل في زبانيته، تحت حجج، وذرائع شتى.
من الملاحظ أنه رغم كل المواقف التي كانت سائدة في مدينة الخليل، فإن الاعتقالات بدأت منذ اليوم الأول للاحتلال، رغم مراوغة كبار القادة ”الإسرائيليين" وزيارتهم رئيس البلدية، وكبير وجهائها الشيخ محمد الجعبري. لكن بعد وقت قصير، تمت مصادرة مساحات واسعة من الأراضي، غالبيتها لعائلة الجعبري، لبناء مستوطنة كريات أربع، ثم تم الاستيلاء على مدرسة أسامة بن منقذ، وكراج السيارات القديم وسط المدينة، حيث حوّلها الاحتلال إلى تجمعات عسكرية، ومراكز استيطان لانطلاق حركة المستوطنين إلى الحرم الإبراهيمي الشريف، الذي يعتبره اليهود مقدسًا، وتابعًا لهم، ويطمحون للسيطرة عليه، وطرد المسلمين منه.
وعمدت قوات الاحتلال إلى تجنب الاصطدام مع الأهالي، والحفاظ على علاقات وطيدة معهم، ما أمكن، أو في الحد الأدنى أن تبقى العلاقات غير عدائية. وعند أي توتر يعمد كبار المستوطنين إلى زيارة وجهاء المنطقة، لعقد الصلح، وفقًا للعادات العربية. غير أن بعض المناطق، مثل مخيما الدهيشة والعروب، على الطريق الرئيس بين القدس وبيت لحم، بقيت مناطق احتكاك، حيث تقوم المقاومة ببعض العمليات، انطلاقًا من المخيمين، مما يجعل الأهالي عرضة لشتى أنواع القمع. لكن هذه السياسات المخادعة للاحتلال، لم تنطلِ على الناس، أو تحل دون تواجد المقاومة.
العمل في أراضي 1948
اعتقد قادة الكيان "الإسرائيلي"، أن سوء الوضع الاقتصادي يدفع العديد للمقاومة (والعمل التخريبي)، وهم بحاجة إلى أيدٍ عاملة "لبناء الدولة الوليدة"، ممّا دفعهم لدراسة إمكانية فتح باب العمل أمام الفلسطينيين، بصورة تدريجية، مع تدقيق شديد في الجوانب الأمنية.
من هنا بدأت دوائر جوازات السفر باستقبال من يريد أن يتقدم للحصول على تصريح عمل داخل الأراضي المحتلة عام 1948، وهذا ما أثار جدلًا عنيفًا في أوساط الشعب الفلسطيني في المناطق المحتلة.
في مخيم الشاطئ في غزة، عارض البعض هذه الفكرة، كونها مساهمة في بناء "دولة" الأعداء، واعتبرها البعض الآخر، خيانة، ونظر إليها بعض الواقعيين، بأنها نتيجة الظروف المعيشية والحياتية، وبالتالي فإن عدم عمل بعض المئات أو الآلاف من الفلسطينيين، لن يُهدد، أو يؤثر على وجود الدولة القائمة، أي إنها قائمة بوجودهم، أو بدونهم.
من هنا ضرورة مناقشة المسألة من زاوية الحاجة للقمة العيش، وحليب الأطفال، لهذا عمد بعض الرافضين، في القطاع، للعمل داخل أراضي 1948، إلى جمع معلومات عمن يحصل على تصريح للعمل، وقام بإتلاف التصاريح، وقد يتعرض صاحب التصريح للأذى والإهانة من الرافضين، ولا تجدي توسلات صاحب التصريح، وإشارته إلى ظروف معيشته القاسية.
في المقابل، فإن زبائن المقهى في الخليل، كانت مُقاربتهم لفكرة العمل في أراضي العام 1948، أكثر قبولًا، واستحسانًا، لما يوفره العمل من ازدهار البلد اقتصاديًا، ورفع المستوى المعيشي، وتعزيز الصمود، والتمسك بالأرض.
في الأحوال كافة، يمكن القول إن هذه المسألة، لا زالت قائمة، وإن اتخذت اليوم أشكالًا مختلفة، سواء في فلسطين، أو خارجها، وهي من التحديات التي تواجه المقاومة، ومن المداخل الأساسية التي يحاول البعض النفاذ منها للتحريض، والتعبئة ضد المقاومة. وقد تكون الظروف غير الإنسانية التي يعيشها أهالي غزة نموذجًا لهذا التحدي، سواء في هذه اللحظات غير الطبيعية، أو في المرحلة القادمة بعد وقف إطلاق النار. لأن الحصار المُتعمد والمقصود، على القطاع اليوم، هو جزء من هذا التوجه الصهيوني. كما أن أوضاع النازحين من جنوب لنبان، نموذج آخر، يمكن أن يُحركه بعض الناقمين على المقاومة، والولوج من خلاله للتعبئة والتحريض.
العمل غطاء للمقاومة
إن مستلزمات الحياة جعلت فكرة العمل في أراضي 1948 تتدفق رويدًا رويدًا، حتى صارت أمرًا طبيعيًا، ولم يعد بإمكان الفدائيين منعه، أو وقفه، لأن مردوده المادي ساهم في تحسين مستوى معيشة العائلات التي يعمل أفرادها في الداخل المحتل، بشكل ملحوظ.
ازدياد أعداد العمال في الداخل الفلسطيني، سهل مسارات الوصول إلى أراضي 1948. كما بدأ التجار اليهود بالتواجد في مدينة الخليل، والمدن الأخرى، مثل طولكرم، قلقيلية، لشراء حاجاتهم، الأمر الذي ساهم، أيضًا في تحسين الوضع المادي العام للناس.
بالمقابل ظلت المقاومة ضد الاحتلال على شكل موجات، تعلو وتهبط. غير أن تدفق العمال، فتح المجال أمام المقاومين للتفكير في تنفيذ عمليات واسعة داخل أراضي 1948، وفي قلب التجمعات السكانية والصناعية، في المدن والمستوطنات. كان جارهم عبد الحفيظ، على سبيل المثال، قد أقنع والدته بضرورة التوقف عن الدراسة، ليتمكن إخوته من العيش ومتابعة دراستهم، فانخرط في صفوف العاملين، وتمكن من تحسين الوضع المعيشي للعائلة، وحسّن الدار التي يسكنها. غير أن هدفه كان أبعد من العمل ومردوده المادي، كونه كان قد انضم إلى صفوف ”الجبهة الشعبية”، وبدأ الإعداد، والتخطيط لتنفيذ عمليات فدائية داخل الأراضي المحتلة، من خلال زرع القنابل، في حافلة، أو ملهى، أو مقهى.
من هنا كان عبد الحفيظ يُهّرب القنابل بطرق مختلفة لزرعها في الأماكن المُحدّدة، واستمر عمله سنتين، إلى أن اعتقله جهاز المخابرات (الشين بيت)، الذي لم يستطع، رغم كل أنواع التعذيب أن يحصل منه على أي اعتراف. غير أنه اعترف بأنه منظم في “الجبهة الشعبية” فقط، نتيجة لاعتراف زميل له، ممّا جعل العمل الذي كان "مرذولًا"، مجالًا لمواجهة المحتل.
أوهام حرب تشرين
العمل داخل الأراضي المحتلة عام 1948 سمح للعمال بالتعرف أكثر، على تفاصيل المجتمع اليهودي، وعاداته، وتقاليده، ودينه. فبعد ظهر كل يوم جمعة، يدخل السبت عند اليهود، فتقفل المؤسسات الرسمية، وإن كان العديد من اليهود في بيوتهم لا يلتزمون بالضرورة بالفرائض المرافقة ليوم السبت. لهذا يعود العمال الفلسطينيون إلى بيوتهم، للراحة.
المفاجئ كان في عيد يوم الغفران الموافق في السادس من تشرين الأول/اكتوبر العام 1973، وهو يوم عطلة. إذ سمع العمال والأهالي بنشوب الحرب بين العرب و”إسرائيل”. كان يحيى السنوار في هذه الحرب أكثر وعيًا، وإدراكًا، من حرب النكسة في 5 حزيران 1967، والتي كان فيها طفلًا بعمر 5 سنوات. لذلك كان تأثرها أوضح، ومتابعتها أدق.
استحضرت حرب 1973، مُجددًا، الأحلام الجميلة عند الأهالي، ودغدغت خيال كل واحد من أبناء المخيم، خيالات العودة إلى ما قبل حرب 1967. غير أن سلطات الاحتلال أصدرت قرارًا بمنع التجول، والتزام البيوت حتى إشعار آخر، فتسمر كل من يملك راديو حول نشرات الأخبار، وتابع الباقون ما يصل إليهم من أخبار بفرح كبير، وهم حالمون بأن هذه آخر مرة يُمنع عليهم التجول، لأنهم قريبًا سيعودون إلى المناطق التي تهجروا منها.
من الملاحظ، أنه رغم نتائج حرب تشرين، وسقوط الأحلام، مرة أخرى، لكن ساد بين غالبية الفلسطينيين مشاعر إيجابية، باعتبار الحرب تحولًا إستراتيجيًا. عمليًا، لم تحقق شيئًا من أحلامهم، ولم تؤمن العودة، ولم تحرر المناطق التي احتلت عام 1967، لكن العبور كان مهمًا، وأسطورة ”إسرائيل ” وجيشها الذي لا يُقهر قد انهارت.
هذه المشاعر "الإيجابية"، سرعان ما تلاشت، وانقلبت رأسًا على عقب، أمام إعلان الرئيس المصري أنور السادات الرغبة بإقامة السلام مع ”إسرائيل”، وزيارته” الكنيست الإسرائيلي"، وكان من نتائج سياسة السادات، توتر علاقته مع منظمة التحرير الفلسطينية، الأمر الذي أدى إلى أن تغلق الجامعات المصرية أبوابها بوجه الطلبة الفلسطينيين.
مفاعيل الحرب اللبنانية
عاش يحيى السنوار، وأهالي المخيم في غزة، وغيرهم في الوطن والشتات، حربًا أخرى، هي الحرب الأهلية اللبنانية، حيث كان لها التأثير الكبير على الفلسطينيين، سواء الذين في لبنان، أو خارجه. لأن مسارات النزوح، منذ 1948، أدت إلى انقسام العائلات في أكثر من منطقة، سواء في مخيمات الضفة، أو لبنان، أو قطاع غزة، أو الأردن، أو في أماكن أخرى... حيث كان لبعض العائلات في المخيم، أقارب في لبنان. لذلك كانت أخبار هذه الحرب تفعل فعلها في الأراضي المحتلة.
كانت لهذه الحرب البعيدة مكانيًا، تأثيراتها القريبة، والمباشرة على سكان المخيمات في غزة، ممّا جعل أهالي المخيم يتابعون الأخبار، ويعيشون على أعصابهم. خاصة وأن مجالات التواصل صعبة، إذا لم نقل مستحيلة، سواء لجهة الاطمئنان عبر الهاتف، أو عبر السفر إلى لبنان. وفي الحالات كافة، عاش الفلسطينيون في غزة، والشتات توترًا عميقًا.
أصبحت المقاومة الفلسطينية جزءًا أساسيًا في الحرب الأهلية في لبنان، ووجودها القوي شكل قلقًا على" إسرائيل"، وهذا من العوامل التي أدت إلى اجتياح لبنان العام 1982، وخروج المقاومة من لبنان، وما أعقبه من مجزرة صبرا وشاتيلا (ترد في النص شتيلا)، ممّا أدى إلى تفجير الوضع في الأراضي المحتلة في فلسطين، لأن كل بيت في المخيمات، له من يخصه في المخيمات اللبنانية، الأمر الذي زاد الألم وعمق المعاناة.
بدايات الإخوان المسلمين
أما لجهة العلاقة بين الفصائل الفلسطينية، فلم تكن، من حيث المبدأ، سليمة. وقد تجسدت من خلال الحوارات بين عناصرها، ومناصريها، التي تمظهرت بشكل حاد جدًا، خاصة بين التيار الماركسي/الاشتراكي، المُمثل بـ"الجبهة الشعبية " (جارهم عبد الحفيظ) من جهة، ومنطلقات حركة ”فتح” (محمود شقيق يحيى)، الحركة التي تتسع للجميع، المتدين، العلماني، الشيوعي، المسيحي، المسلم من جهة أخرى. وكثيرًا ما يحتدم النقاش، في البيوت، أو على زوايا الشارع في المخيم، ويتحول إلى "طوشة"، لا تصل إلى نتيجة. لكن رغم حدة النقاشات، فإنها لم تترك، من حيث المبدأ، أية ضغائن، أو عداوات.
بالمقابل، بدأت مجموعة من الشباب، تُلبي دعوة الشيخ أحمد، الذي كان يعرفه يحيى عندما كان طفلًا، في تردده على المسجد مع جده، للصلاة. حيث كان الشيخ بعد الصلاة، يقوم بعقد حلقات للحديث عن الدين، والرسول، وشرح بعض الكتب الدينية، في الفقه، أو السيرة، أو الحديث وهؤلاء الشباب يستقبلون ما يقوله بنهم، وإقبال.
أخوه حسن، الأطيب في العائلة، والذي ضّحى ليتعلم الإخوة، تعرّف على الشيخ، من خلال بسطة الخضراوات التي كان يعمل عليها لزيادة دخل العائلة، ولبى دعوة الشيخ للصلاة، وبدأ التردد على المسجد، باستمرار، وأصبح متدينًا، يواظب على حلقات الشيخ بقوة.
هذه الوضعية زادت النقاشات في البيت بين الأخوين، حسن ومحمود، وكانت تشتد أكثر مع وجود جارهم "الماركسي" عبد الحفيظ. ردود أخيه حسن كانت ضعيفة، ومتواضعة، مقارنة بعبد الحفيظ المثقف، والذي زاده السجن قدرات أكبر. فهو يعتبر الدين أفيون الشعوب، كونه عامل تخدير. أما أخوه محمود، فهو غير معترض على الدين، لكنه يعتبر "أننا في مرحلة تحرير وطني"، ممّا يوجب عدم الانشغال بأي خلاف فكري وديني، معتبرًا أن النصارى من أبناء شعبنا لهم دورهم في النضال الوطني. عمد حسن إلى الاستعانة بالكتب، التي يحملها من المسجد، للرد، فبعضها يسفه الفكر الماركسي، ونظريات الاشتراكية، والآخر يناقش النظام الاقتصادي في الإسلام، والثالث يتطرق إلى العقيدة.
لم تنفع محاولات محمود إبعاد حسن عن الجماعة التي يلتقيها في المسجد، والأم حاولت هي أيضًا. وبدأت تتردد في البيت كلمة "إخونجية". أي أن هذه الجماعة من الإخوان المسلمين. فيُنكر حسن هذه التهم. يحيى، كان أكثر اقتناعًا بأحاديث محمود. غير أن طيبة أخيه حسن كانت تدعوه ليرافقه إلى المسجد، ويحضر معه الجلسة/الحلقة التي يُديرها الشيخ أحمد بعد الصلاة، حيث يتناول تفسير بعض السور القرآنية، وكان يتأثر بكلام الشيخ.
هذه الجماعة الإسلامية، برأي محمود، الأخ الأكبر، تستميل الشباب بالحديث عن الدين، والإسلام، والرسول، والصلاة،... ليدخلوا لاحقًا بالموضوعات الساخنة. غير أن حسن، ومن تأثر به في البيت مثل أخيه محمد، وابن عمه ابراهيم، اللذين واكباه في تدينه، وزيارة المسجد، وحضور الحلقات لم يتراجعوا، أو يبتعدوا عن جو "الإخونجية". بحجة أن هذا الاتهام غير صحيح، ويُنكر حسن اتهام عبد الحفيظ بأن الإخوان عملاء، لأنهم يقبضون رواتبهم من السعودية، ويتهم الآخرين بالإلحاد وعدم الإيمان بالله، ويُهاجم الاتحاد السوفياتي، الذي كان من أوائل من اعترف بـ"إسرائيل".
يبدو أن حسن، ومحمد وابن عمه ابراهيم، سألوا الشيخ أحمد عن هذه المسائل، فوعدهم بالحديث لاحقًا، لذلك أصروا على أن يرافقهم يحيى إلى المسجد، وبعد الصلاة تحدث الشيخ، بأمور اعتبرها يحيى عادية جدًا، لا تطال جوهر المسائل المطروحة، بينما إخوته كانوا مُعجبين بما سمعوا. ويبدو أن الشيخ كان يتجنب الحديث عن الاحتلال، بشكل صريح خشية مطاردته، وملاحقته، ومنعه من نشر فكرته، لذلك كان كتومًا جدًا، ولا يُفصح عن مكنونات النفس، والمشاريع القادمة.
يمكن الإشارة إلى أن توجه الإخوان المسلمين، وسياستهم في تلك المرحلة، كان موضوعًا سجاليًا، بامتياز. وعليه، فإن هذه الأجواء التي نقلها المؤلف من مخيم الشاطئ في غزة، عن الاخوان المسلمين، كانت، من حيث المبدأ، متماثلة مع السائد في مختلف أرجاء الوطن العربي، ولم تكن محصورة، عمليًا، في المخيمات الفلسطينية. وقد ازداد النقاش حدة، مع انطلاق الثورة الفلسطينية، حيث تنوعت الأفكار، وتوسعت النقاشات، وتعمقت الاصطفافات السياسية، وتجاذباتها الحادة، وحيث كان كل طرف سياسي، يسعى لإثبات مقولاته، واعتبار هذه المقولات الطريق الوحيد للخلاص، والمدخل الرئيس للتحرير. غير أن مختلف الأطراف، تقاطعت، بشكل أو بآخر، حول أهمية الكفاح المسلح، وضرورته.
هذه المسألة بالتحديد، كانت المأخذ على الاخوان، باعتبارهم غير مشاركين في مواجهة الاحتلال، أو منخرطين في الكفاح المسلح باتجاه فلسطين. لكن من خلال متابعة الكتاب، موضوع المراجعة، والمعطيات التفصيلية التي يُقدمها، يمكن الاستنتاج، أن الاخوان المسلمين في قطاع غزة، يبدو أنهم كانوا باتجاه "مُعاكس" لمسار حركة الاخوان "العالمية"، لجهة الالتزام بالكفاح المسلح، ومقاومة الاحتلال. وهذه خصيصة على قدر كبير من الأهمية، كونها ستكون منعطفًا جذريًا في مسار حركة الإخوان المسلمين في قطاع غزة خاصة، وفلسطين عامة.
مسوغات رفض الإخوان
كان رفض الأهالي لحركة الاخوان المسلمين، تستند إلى جملة من المسوغات. ويمكن الإشارة إلى أن عائلة يحيى السنوار، "مثلت"، من حيث المبدأ، نموذجًا للأجواء السياسية التي كانت سائدة في حينه. ويأتي الموقف السلبي من الاخوان أحد مظاهره لأن الفضاء العام كان مُعارضًا للجماعة، كما يُوضّح الكتاب في اكثر من موقع. حيث يُشير المؤلف إلى أن والدته، وأخاه الأكبر محمود، يُعارضان تعلق أخيه حسن بالجماعة، ويسعيان لمنعه من الاحتكاك بها، مُستندين إلى جملة من المسوغات السياسية، المتعارف عليها في المخيمات، إضافة إلى ما استجد بعد انطلاق المقاومة الفلسطينية.
في المسوغات السياسية، يُعتبر الإخوان المسلمون ضد جمال عبد الناصر، وقد حاولوا قتله، وهم لا يؤمنون بالقومية العربية، ولا بالوحدة العربية، والأنظمة والحكومات ضدهم، وتطاردهم، وأن الحلقات الدراسية في المسجد هذه وسيلة لجذب الشباب إليهم. ويُلاحظ أن جمال عبد الناصر كان له حضور خاص ومميز في الذاكرة الفلسطينية. بمعنى آخر كأن أهل حسن يقولون: كيف يمكنك أن تنضوي في جماعة تُعادي عبد الناصر؟ أنه إثم كبير؟. ولتوضيح موقع عبد الناصر، يُشير المؤلف، إلى أن إذاعة خبر موته، مثلًا، نزل نزول الصاعقة على رؤوس الجماهير الفلسطينية، لأن الغالبية رأت فيه زعيم الأمة العربية، فانطلقت التظاهرات العارمة في كل أنحاء الوطن، في مُخيماته، ومُدنه، وقُراه، وفي مخيم الشاطئ تعطلت الدراسة لعدة أيام، وأُعلن الإضراب عن الطعام، وأُقفلت المحال التجارية، وطافت المظاهرات تهتف للوحدة العربية، وتُردّد مناقب الرئيس الراحل، ومآثره، ويرفعون صوره، واللافتات، وخرجت المظاهرة إلى الطُرق الرئيسية، خارج المخيم، وواجهتها قوات الاحتلال في شارع عمر المختار، الشارع الرئيسي، بإطلاق النار، فرد المتظاهرون برشقهم بالحجارة، فتطور إطلاق النار، وسقط عدد من الجرحى، نقلوا إلى دار الشفاء وعيادة الوكالة.
أما في الموضوع الفلسطيني، فيشتد النقاش حول موقف الإخوان المسلمين من المقاومة الفلسطينية، فهم لا يعترفون بمنظمة التحرير الفلسطينية، ويقولون عن شهداء الثورة "فطايس"، وليسوا بشهداء، ولا يُشاركون في المقاومة، لجهة العمل المسلح ضد الاحتلال.
وعليه، يمكن القول، إن النقاشات لم تستطع تغيير القناعات، إذ بقيت كل الأمور على ما هي عليه، لكن توسعت مساحات الالتفاف الشعبي حول المقاومة الفلسطينية، مقارنة بالتيار الإسلامي، الذي كان محدودًا جدًا وشبه مُحاصر. لكن هنا يمكن التساؤل: هل كانت هذه النظرة للتيار الإسلامي، محصورة في غزة ؟ وماذا عن المناطق الأخرى من فلسطين؟ وهل بقي حضور التيار الإسلامي في قطاع غزة خافتًا، ومرفوضًا؟
التيار الإسلامي وامتداداته
إن المعطيات التي يُقدمها الكتاب، موضوع المراجعة، تُبين أن توسع الإخوان المسلمين في غزة كان ضعيفًا جدًا. غير أن الوضع في مدينة الخليل لم يكن كذلك. وهذا ما يمكن توضيحه، باختصار على النحو الآتي:
بدأت تتبلور في مدينة الخليل، وفي مدرسة طارق بن زياد الثانوية بالتحديد، مجموعة من الشباب المتدين، والمحسوبين على التيار الإسلامي. يعود هذا الأمر إلى بعض المُدرّسين الذين كانوا قد تخرجوا من الجامعة الأردنية، وانتظموا أثناء دراستهم في صفوف الإخوان المسلمين، وساهموا في نشر الفكر الإسلامي في الخليل، ووجدوا في صفوف طلاب الثانوية التُربة الخصبة.
ترافق هذا مع افتتاح كلية الشريعة في المدينة، حيث كان تيار الإخوان المسلمين أبرز التيارات السياسية والفكرية حضورًا، ويعود السبب إلى تأثير المُدرسين المنخرطين ضمنه. من هنا تلاقت جهود هؤلاء الشباب، بجهود المدرسين في مدرسة طارق بن زياد الثانوية.
وعليه، فإن اسم الإخوان المسلمين في مدينة الخليل لم يُثر الصخب، أو الشتيمة، وهذا عكس ما كان عليه الوضع في قطاع غزة، وشمال الضفة الغربية. خاصة وأن فكرة الإخوان في الخليل كانت قد تم تبنيها من العائلات الغنية والميسورة، التي كانت مُشرفة على المدينة. لذلك يظهر اسم الإخوان، دون أي حرج. أي إن تشارك الرأسمال مع الفئة المتعلمة، أو لعل الرأسمال سّهل امتداد التيار الإسلامي، وعزّزه.
إن مزاج هؤلاء الشباب، الذي امتد في الخليل، جمعهم سوية فأصبحوا يجتمعون، ويتشاركون في تجمعات، ويُشاركون في نشاطات اجتماعية، وشبابية. غير أن خصيصة هذا التيار، بداية، أنه لم يكن مقتنعًا بعمل المقاومة، بالقدر الكافي، وغير راضٍ بالمقابل، عن فكرة التساهل مع اليهود، وغاضبًا من التقاعس في مواجهتهم، وانتهاكاتهم للمسجد الأقصى. أي أن هؤلاء الشباب كانوا يعيشون حوارًا ذاتيًا، مكتومًا، إذا جاز التعبير، وفي مأزق فكري وعملي.
هذه المعطيات على قدر كبير من الأهمية من جهة، وتُثير تساؤلات أساسية، قد تكون موضعًا للبحث والدراسة من جهة أخرى. تكمن الأهمية هنا في كونها تُبيّن طبيعة حضور التيار الإسلامي، المتمثل حينه في الإخوان المسلمين، واختلاف النظرة إليهم بين غزة، والخليل. أما من التساؤلات الممكن إثارتها في هذه المسألة، فتتركز حول توسع التيار الإسلامي، وتحول نظرته تجاه المقاومة، والمشاركة الفاعلة فيها. حيث كان التيار الإسلامي (كتائب عز الدين القسام، وكتائب الأقصى)، الركن الأساس في المواجهة، ولعب التيار دورًا أساسيًا في الانتفاضة الفلسطينية، كما سياتي في سياق المراجعة. وعليه، لماذا تحولت نظرة قطاع غزة إلى التيار الإسلامي، من سلبية إلى إيجابية ؟ ما هي العوامل التي ساهمت في هذا التحول؟ وكيف أصبح التيار الإسلامي الفاعل الرئيس في مواجهة الاحتلال في الخليل؟ إذًا نحن أمام مسألة "جديدة"، قد لا تدخل مباشرة في صميم المراجعة، لكنها تنبثق من الكتاب، موضوع المراجعة.
هذه الوضعية الصعبة جدًا، فكريًا، واكبها ضعف الإمكانات، اللوجستية، والتسلحية، للانخراط في مواجهة الاحتلال، ممّا دفع للتساؤل عن مدى الجهد الاستثنائي، الذي قام به المقاومون، والمجاهدون في قطاع غزة، وعلى رأسهم كتاب "القسام"، لتنمية قدراتهم في التنظيم، والإدارة، والتخطيط، والتدريب، والإعداد، والتسليح، والذي نشهد مظاهره الباهرة في مواجهة المجاهدين والمناضلين لحرب التدمير والإبادة التي يشُنها العدو الصهيوني، وحلفائه "المتحضرين"، منذ عملية طوفان الأقصى؟.
فكرة الإسكان وأبعادها
إن مخطط قادة الاحتلال ينصب على إزالة الهوية الفلسطينية، وطرد الفلسطينيين من أرضهم، لذلك حاولوا، إضافة إلى الحروب المستمرة، تغيير معالم المدينة، والمخيمات فيها. من هنا بدأ الحديث عن مشاريع إسكانية، تعدها دائرة الإسكان في الحاكمية العسكرية للاحتلال. وعليه، يمكن للشخص تسجيل اسمه، ودفع بعض الرسوم الرمزية، شريطة هدم داره في المخيم، لاستلام كل متزوج غرفة سكنية خارج المخيم.
أثار هذا الموضوع جدلًا عنيفًا بين سكان المخيم. فكيف يمكن معالجة هذه المعضلة؟ هناك زيادة في النسل، وعدم المقدرة على بناء بيوت جديدة، بالمقابل، حل القضية الفلسطينية ليس في الأفق المنظور. المعارضون اعتبروا الفكرة تهدف إلى تذويب اللاجئين من خلال تفريغ المخيمات، وتوطينهم في الأحياء الجديدة، والموافقون يرزحون تحت وطأة أوضاعهم غير الإنسانية. استمر الجدل حول مشاريع الإسكان، وجاء الحل من خلال بقاء الفكرة نظرية. أي أنها لم تخرج إلى حيز التنفيذ. وبقي الأهالي على أوضاعهم المعيشية غير الطبيعية.
السنوار ونقطة التحول
إن ظروف الحياة التي عاشها يحيى السنوار، طفلًا، ثم شابًا، في مخيم الشاطئ في غزة، ساهمت في بلورة شخصيته. غير أن نهاية المرحلة الثانوية كانت عاملًا مهمًا في إحداث تحول أساسي في تشكله ورسم معالم تصوراته المستقبلية، من حيث المبدأ. خاصة وأنه أصبح على أعتاب الدخول إلى الجامعة. ففي هذه المرحلة، بدأ يسمع عن الحياة الجامعية أكثر، والمعاناة المادية للمحيطين به لمتابعة تحصيلهم الجامعي، وأوضاعهم الدراسية، وصعوبات السكن، والنشاطات الطلابية، وخلفياتها السياسية، والمعارك الانتخابية في الجامعات، والتنافس في النقابات... الأمر الذي ترك دون أدنى شك أثره في النفس، وتداعياته على الذات والشخصية.
لكن، في خضم هذه الأحداث المتداخلة، كانت الرحلة التي شارك فيها إلى القدس مفصلًا في حياته، وساهمت في ترسيخ منطلقاته الإيمانية، والتزاماته الدينية، وتوجهاته السياسية. من هنا يتحدث المؤلف، بشيء من الإسهاب والتفصيل عن أثر زيارته الأولى للقدس، والتداعيات التي تركتها في ذاته، فكيف جرت هذه الزيارة، وماذا حدث خلالها.
- فكرة الرحلة: نظم طلاب الكتلة الإسلامية في مدرسته، مدرسة الكرمل الثانوية، التي يُشرف عليها ابراهيم، ابن عمه، رحلة إلى القدس، وبعض المناطق الأخرى في فلسطين. فعرض عليه أحد الناشطين الإسلاميين التسجيل في الرحلة، غير أنه تردّد. في البيت حدثه ابن عمه ابراهيم عن ضرورة المشاركة في الرحلة، وعدم التخلف، أو التردد، لأنه يُضيّع عليه فرصة الخروج من القطاع إلى الضفة الغربية والقدس، وأبدى استعداده لتسديد مبلغ التسجيل، وضغط عليه للمشاركة، فوعده يحيى خيرًا، وهكذا دفع يحيى من مصروفه الرسوم لمسؤول الكتلة الإسلامية في المدرسة.
- الانطلاق والمشاهدات: تجمع المشاركون منذ ساعات الصباح الباكر من يوم الجمعة، عند باب المدرسة، وكل يحمل كيسًا فيه طعامه، وبعد دعاء السفر، انطلقت الحافلة التي تقلهم. وكلما مروا على موقع، أو آثار لإحدى القرى، أو البلدات التي دمرها اليهود، لإزالة آثار عروبة المكان، يبدأ ابراهيم بالشرح والتعريف، هنا آثار مدينة عسقلان، هذه الجميزة، هنا آثار مسجد حديقة أسدود، ومدرستها، وبعض بيوتها... وخلال وقفتهم الأولى فوق هضبة جميلة عليها أحد الأديرة النصرانية، والذي يُسمى اليوم باسم "دير اللطرون"، شرح ابراهيم بصوت كاد أن يوقفه البكاء، وإحساس مرهف، وخشوع واضح، وتعابير مؤثرة عن المعركة التي خاضها في هذا الموقع، "أبو عبيدة عامر بن الجراح" لفتح فلسطين، ليختم بالقول: "هذا التراب ترابنا، وهذه الأرض أرضنا جبلها صحابة رسول الله، صلعم، بدمائهم الزكية ولا بُد أن تُجبل بدم زكي طاهر من أتباع الرسول حتى تتحرر من جديد".
صُعِق يحيى من معلومات ابراهيم، وثقافته، فازداد عظمة واحتراما لشخصه، وهو الصامت، والأخرس، والأبكم في الدار، وخاصة أمام الوالدة.
- القدس مفصلًا: كانت كل المحطات والمواقع والآثار التي مروا فيها مهمة، وحتى زيارتهم إلى الخليل لزيارة الحرم الإبراهيمي الشريف، تركت أثرًا في النفس. غير أن القدس كانت المفصل الفاصل، واللحظة الحاسمة في إحداث التحول. عند الوصول إلى القدس، وأسوار المسجد الأقصى، والبلدة القديمة، وقبة الصخرة المُشرقة بألوانها الزاهية، والمُتربعة فوق تلك التلة المرتفعة تحركت المشاعر. بالمقابل كان هناك منظر مستفِز جدًا، تمثل بوجود جنود الاحتلال في كل زاوية، يحملون البنادق، ويراقبون، ويدققون بالهويات، حتى أنهم سجلوا أرقام هوياتهم عند الدخول من أحد أبواب المسجد.
شعور من الخشوع والرهبة انتاب يحيى في خطواته الأولى داخل المسجد، لم تستوقفه خطبة يوم الجمعة في المسجد، فقد اعتبرها عادية، ليس فيها أي جديد، أو مُميز عمّا يسمعه من المشايخ في غزة. في مسجد قبة الصخرة، بدأ ابراهيم بشرح عن المسجد، ورحلة الإسراء والمعراج، مُكررًا أن للقدس أهمية. فمن القدس ارتقى رسول الله إلى السماء... عندها شعر يحيى برعشة في جسده، وغطته قشعريرة لم يستطع أن يخفيها عمّن وقفوا بجانبه، والذين سادهم الشعور نفسه.
في غزة كانت القدس مجرد اسم يُذكر، وله بعض التأثير البسيط. لكن في هذا المكان المُقدس الذي يُحيط به جنود الاحتلال، الذين يسمحون، ويمنعون، "وأمة المسلمين والعرب، بملايينها، وأموالها، وجيوشها تقف عاجزة عن تحريره، وتخليصه من هذه العصابات النكدة اللعينة"، أصبح للقدس معنى آخر، ومضمون مختلف.
من تلك اللحظة، فهم يحيى الشاب بُعدًا آخر للصراع، ووجهًا آخر غير ما "كنا نعي ونُدرك من قبل". إذًا المسألة "ليست مسألة أرض وشعب، طُرد من هذه الأرض"، إنما هي "معركة عقيدة ودين، معركة حضارة وتاريخ ووجود". فقد حققت الرحلة غرس هذا المعنى عميقًا في نفسه، وذهنه، ولا وعيه. لذلك كان الانتقال إلى المكان الآخر في مسار الرحلة، الحرم الإبراهيمي، صعبًا جدًا بالنسبة إلى يحيى. لأن الأقدام كانت مغروسة في الأرض، والخطوات باتجاه المغادرة من هذا الموقع المقدس، كانت "تُنتزع انتزاعًا "، لما أثاره المكان في النفس من مشاعر، يجعل من الصعوبة مُفارقته طائعًا راضيًا، لأنك تود أن تبقى فيه. هذه الأحاسيس والمشاعر التي شعر بها يحيى بقيت راسخة، وفعلت فعلها. فبعد الرحلة أصبح للكلمات في الأماكن المقدسة، بالنسبة له، معنى ووقع مختلف تمامًا، ومنذ تلك اللحظة، قرر المواظبة على الصلاة.
تهديد المسجد الأقصى
تقاطعت هذه الأفكار، مع اتساع حركة استيطان اليهود المتدينين في الجليل، واعتداءاتهم على الأهالي، التي غدت ظاهرة دائمة، بحماية جيش الاحتلال ودعمه، الأمر الذي دفع مجموعة من ثلاثة شبان من حركة "فتح" إلى القيام بعملية فدائية ضدهم، أوقعت عددًا من القتلى والجرحى. لهذا تم منع التجول لعدة أيام، وقام الاحتلال بعملية تمشيط، وتفتيش، وتحقيق، مع ما يرافق هذه العملية من تخريب، وتدمير مبرمج.
وعليه عمد المستوطنون إلى تشكيل تنظيم سري، وبدأوا بمهاجمة العرب في مدينة الخليل، منها مثلًا، عملية إطلاق النار على طلبة وطالبات جامعة الخليل، فأوقعوا عددًا من الشهداء والجرحى، دون أن تقوم قوات الاحتلال بأي إجراء جدي لمنع هذه الاعتداءات. كما أُعلن عن تشكيل تنظيم حركة "أمناء الهيكل"، اليهودية نيته تفجير المسجد الأقصى، ممّا أثار موجعة عارمة من الغضب الشعبي.
وصلت الأخبار إلى الجامعة الإسلامية في غزة، بأن اليهود سيُفجرون المسجد الأقصى، وقد أصبح يحيى طالبًا فيها فعُقد مهرجان خطابي، تقرر فيه السفر إلى القدس للدفاع عن المسجد، فتطوع حوالي خمسين طالبًا، ورافقهم الشيخ يوسف، الذي ردّد عليهم ما يمكن من توجيهات للدفاع عن المسجد. وعند وصولهم كانت الأعداد كبيرة جدًا، لكن دون تنظيم. فعمد طلاب غزة إلى توزيع أنفسهم مجموعات، على أبواب المسجد، ثم تناوبوا للحراسة ليلًا، وساعدهم الأهالي بتأمين البطانيات الصوفية لاتقاء البرد.
في اليوم التالي وصلت مجموعة أخرى من طلاب الجامعة الإسلامية، من غزة، فأصبح عددهم أكثر من مئة شخص، متسلحين بالإيمان، وما تيسر من حجارة، وعصي، ومواسير الحديد. وقد انضم إليهم مجموعة من أهالي الأرض المحتلة عام 1948، وخاصة من بلدة "أم الفحم". وعندما اطمأن الجميع إلى عجز الحركة اليهودية عن تفجير المسجد الأقصى، عادوا جميعًا إلى غزة.
كان طموح المشاركين نيل الشهادة في الدفاع عن الأقصى، وقد عاش الطلبة لحظات من المشاعر والأحاسيس الوجدانية، خلال تواجدهم للصلاة في باحات الأقصى، أو حُراسًا على أبوابه. كما كانت المرة الأولى بالنسبة ليحيى التعرف على الأهل من عرب الداخل، والاحتكاك بهم، فتربعوا على قلبه، لجميل خصائصهم، وطيبة قلوبهم، وخفة روحهم، والأهم صمودهم طيلة سنوات الاحتلال.
الإخوان تربيًة وإعدادًا
ازدادت موجة الهجوم على الإسلاميين، لعدم مشاركتهم في المقاومة ضد الاحتلال. ففي الخليل توسعت هذه الموجة، غير أن ردهم، كما عبر عنه جمال الملتزم مثلًا، أن على "شعبنا" أن يتسلح بسلاح الدين والإيمان، فيعود لدينه، لتأخذ المعركة بُعدها الحقيقي. لذلك على الشعب أن يُقاسوا في الدنيا، لينالوا في الآخرة.
أما في غزة، فإن التيار الإسلامي كان الأكثر تنظيمًا وحركة بين الطلبة، مقارنة بتيار الكتلة الوطنية، من حركة "فتح"، الذين يحاولون تطوير قدراتهم، أو من طلاب اليسار الذين لم يكن لهم صوت يُذكر. وهذا ما عكسته الانتخابات الطلابية، وكان يحيى قد أعطى صوته للإسلاميين، لعلاقته بإبراهيم، رغم "ميوله" الفتحاوية.
كان جو البيت مُنقسمًا، بين الأخ الأكبر محمود المؤيد لفتح، والآخرين، حسن، محمد، ابراهيم، المنخرطين في التيار الإسلامي. لذلك كان محمود يهاجم التيار الإسلامي، في إطار الحجج ذاتها التي اصبحت معروفة، وتتردد في مدينة الخليل أيضّا. ويُركز على مهاجمة قياداتهم، لأنها تُعطل طاقات كبيرة من الشباب، باسم الدين. بالمقابل كان حسن الذي اكسبته الجامعة خبرة في النقاش السياسي، يرد بقوة.
هذه الأجواء التي سادت في القطاع، أحدثت اضطرابًا في أوساط طلاب التيار الإسلامي، ممّا دفع حسن في الحلقة المعتادة في المسجد، لسؤال الشيخ عن دورهم كتيار في المقاومة، فكان رده مُقتضبًا جدًا، "إننا في مرحلة التربية والإعداد"، الأمر الذي جعل هاتين الكلمتين، مفتاح رد طلاب التيار الإسلامي، على الاتجاهات السياسية الأخرى. لدرجة أن "أبو وديع"، مسؤول مخابرات الاحتلال في المنطقة، عندما تم استدعاء ابراهيم للتحقيق معه، اشار إلى هاتين الكلمتين التي كان ابراهيم يرددهما في المهرجانات، والنقاشات الجامعية، للرد على أسئلة طلاب الكتلة الوطنية، فتوجه "أبو وديع" إلى ابراهيم مُتسائلًا بتهكم تُحضرون، "دوركم في العمل التخريبي ضد دولة إسرائيل". مُحذرًا بعُنف: "ليكن في علمك إننا نراقبكم، وإننا نعرف كل نفس بما تتفوه، وأول ما تفكر في عمل شيء غير الحكي سنعرف كيف نضعكم في السجون". ويبدو أن ابراهيم بصمته، وصلابته، استفز مسؤول المخابرات، لذلك عندما سلمه "أبو وديع" بطاقة الهوية قال له: "كل هذا الحقد الذي يملأ عيونك مثل عيون البغل لا تُحضره معك حين أطلبك مرة ثانية، واتركه في البيت" . عندها تناول ابراهيم بطاقته وخرج من الغرفة وهو "يبتسم ابتسامة لم يكن من السهل إخفاؤها".
من الواضح أن مقولة "التربية والإعداد" كان يستخدمها طلاب الكتلة الوطنية، كنوعٍ من التهكم على التيار الإسلامي. كما أن مخابرات الاحتلال لم تكن تُدرك، رغم بثها العيون والمُخبرين، حقيقة ما يقوم به التيار الاسلامي من إعداد وتنشئة. وفي الحالات كافة، هذه المسالة ليست سطحية، أو ثانوية. لأن التيار الإسلامي سرعان ما أصبح قوة فاعلة ضد الاحتلال. من هنا يمكن التساؤل: ألم تكن هذه التجربة، التي يُعتبر ابراهيم ابن عم يحيى، من أركانها (إلى جانب غيرها)، قد أسست، عند يحيى لنمط في التفكير والعمل والمواجهة؟ ألم تُساهم في تكوينه، وإعداده، وبلورة شخصيته؟ ألم تفتح أمامه آفاقًا جديدة؟.
الوعي السياسي وارتداداته
في هذه الأجواء، تطور الوعي السياسي في الأراضي المحتلة بصورة واضحة، خاصة في مراكز التجمعات الشبابية، وتحديدًا في الجامعات، والمعاهد، والمدارس الثانوية، وفي إطار التنافس السياسي بين القوى السياسية والاتجاهات الفكرية، مع ما يتضمنه هذا المسار من صِدامات صغيرة، يتم حلها بسرعة، ويُسر. غير أن تنافس التيار الإسلامي مع التيار الوطني، وعلى رأسه حركة" فتح"، الممثل لمنظمة التحرير الفلسطينية، بفصائلها كافة، كان أكثر حساسية، و أكبر حضورًا، وأشد قوة. لماذا؟
لأن تنامي التيار الإسلامي في الأراضي المحتلة، وحصوله على المواقع، أقلق فصائل منظمة التحرير الفلسطينية. والأزمة أن هذا التيار المتنامي بشكل كبير، لا يعترف بـ"منظمة التحرير الفلسطينية" أولًا، وليس له أي دور في مسيرة الكفاح المسلح ضد الاحتلال ثانيًا. ورغم ذلك، فإن مسار نموه في قطاع غزة ازداد بوضوح تام، كما سيطر طلابه على الهيئات النقابية في الجامعة، ممّا أدى إلى المزيد من الاحتكاك، والصِدام فيما بين هذه الأطراف، والطامة الكبرى أن الاحتكاك سرعان ما ينتقل للشوارع، وأزقة المدينة. كما كان هذا النمو يُقلق الاحتلال، ممّا دفع قواته لاقتحام الجامعة، أكثر من مرة، بالدبابات، والعربات العسكرية لكن تكاتف كل القوى، على اختلافها، كان يحول دون نجاح الاحتلال، الأمر الذي جعل الجامعة رمزًا وطنيًا مهما.
كان هذا الانقسام السياسي الحاد، يتبلور في دار يحيى، لأن طرفيه يعيشان معًا. لهذا كان يرتفع مستوى النقاش، ويتحول إلى صراخ، فتتدخل الأم بمساندة يحيى للحؤول دون أن يؤدي إلى عراك، وتضارب بالأيدي. فشباب التيار الإسلامي، أصبحوا أكثر وعيًا، وهم قادرون على الدخول في المناقشات دون ارتباك، ولديهم الإجابات، وعندهم الإمكانات للرد دون خشية من أحد، ولعل هذا ما زاد الأمر تعقيدًا.
ابراهيم الصالح صالحًا
ليس من الصعوبة، عند متابعة الكتاب، موضوع المراجعة، اكتشاف موقع ابراهيم، ابن عم يحيى، وتأثيره على يحيى بشكل أو بآخر. فيحيى كان مُعجبًا جدًا بابن عمه، ويومًا بعد يوم، يزداد في نظره سموًا واحترامًا. عاش ابراهيم يتيمًا، حيث استشهد والده وهو في الرابعة من عمره، وتركته أمه، وأخاه حسن، وهما لا يزالان صغيرين، وعاش مع عائلة عمه، كفرد منهم، ويُقدر زوجة عمه، أم يحيى، بشكل غير طبيعي. وقد أصبح رجلًا عِصاميًا، وقائدًا حقيقيًا، بالرغم من صِغر سنه.
في الجامعة، لا يهدأ، يتحدث، يناقش، يوجه، يصدر الأوامر والتعليمات، يُفكر، يناظر، يُشارك، يخطب، يُنظم، ورغم ذلك "فهو في حياته، كالبكر في خِدرها سرعان ما يتدفق الدم إلى وجهه، ويكاد ينفجر في وجنتيه". كان يحيى يخاف عليه، ويخشى أن يعتدي عليه أحد، فيحاول أن يبقى قريبًا منه، ما استطاع، وما سمحت ظروف المحاضرات، وطبيعة حركة ابراهيم، التي لا تهدأ، واتصالاته التي لا تتوقف، ونشاطه الذي لا يخبو، إذ كان يختفي أحيانًا، أو يجلس مع مجموعة من ناشطي الكتلة الإسلامية، ولا يحبون أن يسمع أحد حديثهم.
وعندما استطاعت الجامعة الإسلامية أن توسع بناءها، تحول ابراهيم إلى "مقاول"، بما لديه من خبرة، يبني، وحوله مئات الطلاب، فموقعه القيادي، ونشاطه الدائم، واستمراره في مزاولة أعمال البناء التي كان يكسب من ورائها المال، لتأمين مصروفه، كل هذا لم يمنعه من أن يكون متفوقًا في دراسته.
عندما حاول المشاركة في مصروف البيت، رفضت أم يحيى بشدة، وشجعته على أن ما يفيض عن مصروفه، يمكن أن "تدخره" له، لأنه "يلزمنا لزواجك بعد تخرجك من الجامعة". لكن في أغلب الأوقات، لا يدخل الدار، إلا وفي يده كيس مملوء بالمواد الغذائية، أو الفواكه، وأم يحيى تنظر إليه بإكبار وإعجاب.
هذه الشخص كان كتومًا، صارمًا، قليل الحديث، كثير النشاط، مُبادرًا، مؤمنًا، مُلتزمًا، لا يهدأ، غير مدّعٍ، متواضعًا، صبورًا، سريع البديهة، يعرف ما يُريد، ويُخطط، ممّا جعل يحيى مُعجبًا بشخصه، لا يُخفي عنه سرًا، ومُطيعًا لتوجيهاته، مُنفذًا لتعليماته. من هنا يمكن القول دون أدنى شك، إن ابراهيم الصالح كان نموذجًا صالحًا لتقليده، والتماثل معه. وعليه يذكر الكتاب، موضوع المراجعة، العديد، من الأخبار، والأحداث، والمواقف، المرتبطة بإبراهيم. لدرجة يمكن القول، دون مبالغة، إن هذا الكتاب يتحدث عن ابراهيم، أكثر ممّا يتحدث عن يحيى. بل إن حركة يحيى كانت مرتبطة بإبراهيم، لدرجة التلازم.
كما إن مخابرات الاحتلال كانت تتابع حركته، دون أن تستطيع إدانته، لحسه الأمني المرهف. بعض ما قام به إبراهيم أنه قتل أخاه حسن، لأنه عميل، وقتل صديقه "فايز" الناشط معهم، كونه خائنًا فرزته أجهزة المخابرات الصهيونية لمراقبته، وهذان العملان قام بهما مباشرة، ودون أي تردّد، وقصة تصفيتهما، ومجرياتها تستحق التأمل، لأهمية مثل هذه الخطوة وخطورتها. فالانتماء الوطني أهم من "رابطة" الدم، ومصلحة الوطن أغلى من الانتماءات الأولية. ومن الملاحظ أن ابراهيم لم يكن يأخذ بالوشاية، بل يعمد إلى التحقق من الخبر أكثر من مرة، ويسعى جاهدًا للحصول على الدلائل والمعطيات الحسية، وهذا ما حصل عند قتل أخيه، ثم صديقه.
إن ابراهيم شخص خاص، ومُميز، جدير بكل التقدير، والاحترام، كان مُجاهدًا، وحياته اليومية تُجسد جهاديته سلوكًا حيًا في علاقاته الاجتماعية، دون تمثيل أو ادعاء، لا تُغريه الماديات، ولا تُبهره المواقع، على سبيل المثال لا الحصر، في إحدى العمليات ضد قوات الاحتلال، اضطر مع المجموعة، خلال هروبهم من المطاردة، للدخول إلى باحة بيت فخم جدًا، وطلب من صاحبه تسليمهم مفتاح السيارة الفخمة للهروب، وبعد الانطلاق وجدوا حقيبة تحتوي على مليون دولار، فأمر أخوته في اليوم التالي بإعادة السيارة والحقيبة إلى صاحبها، الذي لم يصدق ما يراه، داعيًا لهم بالنصر، والتوفيق.
زواجه لم يُلغِ حب فلسطين، حبه الأكبر والأول، بل كان لخدمته. جاء زواجه من مريم (شقيقة يحيى)، بعد إلحاح أم يحيى عليه بضرورة الزواج. لكنه فاجأها عندما طلب يد ابنتها مريم، فوافق الجميع بفرح. في حواره مع يحيى قال ابراهيم إنه لم يُفكر بموضوع الزواج، بعد انخراطه في الهم الوطني، ومقدسات البلد، وقرر التوقف عن التفكير، مجرد التفكير في الحب. مُشيرًا إلى "اننا سنبقى محرومين من هذا الشعور" لأن قدرنا أن نعيش حبًا واحدًا فقط، حب هذه الأرض، ومقدساتها، وهوائها، وبرتقالها. هذه الأرض ترفض أن ينافسها أي مُنافس. فرد يحيى: لقد اجتمعت فيك الثلاث: ثائر، وعاشق، وشاعر. لكن هذا لا يتنافى مع حب واحدة من الصبايا الجميلات، فعشقهن من عشق الوطن. وموقفك فيه مبالغة، وخلط بين المفاهيم. فرد ابراهيم بابتسامة، "نحن لسنا كغيرنا يا أحمد...لسنا كغيرنا".
وعندما رزقه الله بابنة سماها إسراء، فسأله يحيى عن السبب، فقال: كلما أراها أتذكر واجبي تجاه أرض الإسراء. مُضيفًا إذا كان الأولاد من أسباب تقاعس الناس عن الجهاد، فإسراء ستكون سببًا للاستمرار في القيام بالواجب المطلوب.
كان عصاميًا، ومن مؤسسي التيار الإسلامي، سُجن أكثر من مرة، ولم يُثبَت عليه أي دليل، وجنّد المجاهدين، وشاركهم في تنفيذ العمليات الفدائية، وحاول، أكثر من مرة، خطف جنود لمبادلتهم وإطلاق سراح المسجونين في سجون العدو، وعلى رأسهم الشيخ أحمد ياسين، وبادر لتصنيع المدافع. ورغم تخرجه من الجامعة الإسلامية، وحصوله على شهادة البكالوريوس، تخصص علم الأحياء، رفض ترك الوطن ولو للحظة واحدة.. وتفرغ لمقاومة الاحتلال دون كلل أو ملل، حتى استشهد بعد أن استهدفته طائرة حربية "إسرائيلية"، بشكل مباشر.
لقد اعطى يحيى السنوار، لإبراهيم حقه في هذا الكتاب. لكن ما قدمه هو دليل على عظمة شباب الأرض المحتلة، ومستوى قدراتهم، وعمق إيمانهم، ومقدرتهم على مواكبة روح العصر، وإنتاج شيء من "اللاشيء" لمواجهة الاحتلال وهزيمته.
شرعنة العمالة وتعميم الرذيلة
قبل الانتفاضة تراجع دور المقاومة، ممّا سّهل حركة ضباط المخابرات دون أية احتياطات. إذ أصبحوا يتجولون بحرية، ويعترضون أي شخص، ويطاردون في الأزقة، ويستجوبون في الشارع دون حراسة، أو تحسب، أو خشية. بالمقابل حركة العمال في أراضي 1948 اتسعت دون أية ضوابط، ولم يقتصر الأمر على العمل، بل امتدت لإقامة علاقات اجتماعية، وصداقات مع أصحاب العمل اليهود وعائلاتهم.
وبدأت مخابرات الاحتلال تتغلغل في المخيم، شيئًا فشيئًا، وبشكل مُمنهج ومدروس. لدرجة أن عددًا من العملاء أصبح مشهورًا، ومعروفًا، ويحمل مسدسًا، ويدخل مكتب المخابرات وقتما يشاء، ويُعربد على الناس، ويعتدي عليهم. ويمكن للعميل المشهور منهم أن يتوسط للبعض لقاء عمولة، ومن يعترض من الأهالي على مبلغ العمولة، يرد العميل: "أنا عميل لليهود، لو استطعتم فستقتلونني، لذا يجب أن أمص دماءكم قبل ذلك". وبعض العملاء قد يفتح مكتبًا لإصدار التصاريح، وتسهيل إنجاز المعاملات.
وعمدت المخابرات، عبر العملاء إلى ترويج، واستخدام تجارة المخدرات والحشيش، والخمور، وتعميم الفساد والرذيلة على أنواعها. كما عمدت المخابرات إلى توريط بعض النساء من خلال تصويرهن بأوضاع مخلة بالآداب في محلات الكوافير، أو الاستديوهات، من خلال تنويمهن، والاعتداء عليهن، وتهديدهن بنشر صورهن. والبعض منهن فضل الانتحار، بعد ترك رسالة للأهل توضّح ما جرى لهن. كل ذلك لتدمير الشعب، وقتل روح المقاومة فيه. بالمقابل، فإن الناشطين من التنظيمات الفلسطينية كانوا عاجزين، وزادت الرقابة عليهم.
في هذا السياق، أَطلع ابراهيم يحيى على تقرير مُترجم، نشرته صحيفة "يديعوت احرنوت" تعتبر أن قطاع غزة تحول إلى مستنقع من العملاء والجواسيس، المتعاملين مع "جهاز المخابرات الإسرائيلية الشاباك". وبالتالي فإن غزة التي كانت في بداية الاحتلال "بؤرة القلائل ووجع الرأس للإسرائيليين"، لا يمكنها أن تعود مُطلقًا، إلى ما كانت عليه. وهنا يُشير المؤلف إلى ردة كل منهما حول التقرير، ففي حين كان يحيى قلقًا، فإن ابراهيم كان هادئًا جدًا. حيث اعتبر أن التقرير فارغ، فرغم نجاح الاحتلال في ضرب المقاومة، والتغلغل في الأوساط الشعبية، لكن هذه الأرض برأيه مُباركة، وعندما تزف الساعة، سينطلق المارد من جديد، ممّا دفع يحيى لاعتبار هذا الكلام رومنسيًا، وخياليًا، فرد ابراهيم سنرى.
لم تكتفِ المخابرات بهذه الأساليب لضرب الشعب، وتدميره، والقضاء على روح الثورة فيه، بل لجأت إلى تجنيد أشخاص غير معروفين للتعامل معهم، وبطرق مختلفة جدًّا، بحيث تلتقي بهم خارج السرايا، حفاظًا على السرية، وحماية لمواقعهم المؤثرة في المجتمع. لذلك كان من الصعوبة كشفهم.
غير أن للصِدف فوائد غير محسوبة، ومنها أن يحيى وهو عائد ليلًا إلى البيت، لاحظ أن "أبو وديع"، مسؤول المخابرات في غزة، يكتب شيئًا على الحائط، فأخبر ابراهيم. وفي اليوم التالي، مرا بالقرب من الحائط، بحذر، وكان ابراهيم يعتقد أنها إشارات من البلدية لأعمال الكهرباء، أو المجاري... لكنه بعد تجواله في الشوارع، مع يحيى، وتسجيل المكتوب على الحيطان، وتحليله، تبين لإبراهيم، أنها إشارات لتحديد مواعيد المقابلات مع العملاء السريين والخطرين جدًا، وغير المعروفين، حتى لا يتم الشك فيهم. أي أن المكتوب، يُحدد اليوم، التاريخ، الساعة، والدقائق. وفي هذه الطريقة، وبالصدفة التامة، تابعوا إحدى هذه الإشارات ليتبين أن العميل، هو صديق ابراهيم العزيز "فايز" الناشط في الشأن العام معهم، من هنا تمت مراقبته، وإيقاعه، ثم تصفيته، دون إثارة هواجس المخابرات، وظنونهم.
هذه الخطة التي اعتمدتها قوات الاحتلال لضرب المقاومة، في عقر دارها، لم تكن عملية عابرة، لأن الاحتلال اعتبرها المدخل لتفكيك الشعب، وضرب مقومات صموده، وقتل مستقبله من خلال قتل شبابه. وبالتالي نسيان القضية كمقدمة لتصفية الهوية. لكن إلى أي مدى نجح الاحتلال؟
من هنا يمكن الإشارة، مبدئياً، إلى أمرين، على الأقل: الأول، إن الثقة بالشعب، والإيمان بقدراته لا تزال حقيقة راسخ في مسار العمل الثوري. الثاني، إن طبيعة عمل حركة حماس، وكتائب عز الدين القسام، تستحق المزيد من الدراسة والبحث. لأنها تجربة قد تكون فريدة من نوعها، بين حركات التحرر الوطني. ومهما كان الموقف السياسي، من هذه التجربة، فإن ما قدمته في ظل موازين القوى السائد حينها، أو في اللحظة السياسية الراهنة، يستحق كل التقدير والاحترام، ممّا يجعل مراهنات الاحتلال تفشل، في اختراق الاهالي، وفي تيئيسهم، وفي ضرب علاقاتهم بالمقاومة، أو مُحاصرتها، بعيدًا عن محيطها. إذ إن كل محاولات الاحتلال لضرب المجتمع الفلسطيني في غزة باء بالفشل. فقد سقط ضعفاء النفوس، كأوراق الشجر، وبقيت الشجرة راسخة في الأرض، عميقة الجذور، وبقيت غزة مقبرة الاحتلال، عنوان الغزة والكرامة.
تصاعد المواجهة
لم تستمر طويلًا، مرحلة ضعف المقاومة. إذ تفجرت الانتفاضة الشعبية، وعمّت الوطن، ممّا أقلق قوات الاحتلال وأربكها. فقد اتخذت مواجهة الاحتلال اشكالًا مختلفة، بعضها مُخطط له من فصائل المقاومة الفلسطينية، وبعضها الآخر مبادرة من الشباب الفلسطيني، ممّا زاد أعداد الشهداء والجرحى، والمعتقلين،... والاحتلال يزداد عُنفًا دون أي رادع له، والعالم كله لا يتحرك ضد انتهاكات قوات الاحتلال وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني.
من هنا عمد العديد من الشباب، تخطيطًا، أو نتيجة مبادرات لأفراد، أو مجموعات، إلى القيام بعمليات فدائية، في القدس، وأراضي 1948، عمليات لا تحتاج إلى أدوات، وتقنيات، وأسلحة متطورة، مثل: الطعن بالسكين، إطلاق نار على مجموعات لليهود، أو للجنود، دهس بالسيارة، قنص... فبدأت قوات الاحتلال تتحدث عن "حرب السكاكين"، وبدأ الرعب والهلع يدب بين اليهود. وهنا كان التيار الإسلامي، مُبادرًا، ورائدًا، وكان ابراهيم موجهًا، ومشرفًا، فتطايرت أخبار المقاومة في أنحاء الوطن الجريح، تهتف تحية لكتائب عز الدين القسام، فاتسعت موجة الاعتقالات بشكل عشوائي، مترافقة مع تصاعد العمليات ضد الاحتلال، الأمر الذي حوّل غزة إلى "ثقب اسود في رأس إسرائيل"، ودفع بعض الساسة الصهاينة إلى المطالبة بالانسحاب من غزة، وتفكيك ما فيها من مستوطنات، وإنشاء جدار حولها.
ويُشير المؤلف إلى العديد من العمليات التي كان يقوم بها شباب المقاومة، وخاصة عمليات كتائب عز الدين، والجهاد، منها عملية خطف الجندي "نيسم طوليدانو"، والمطالبة بإطلاق سراح الشيخ أحمد ياسين، وسجناء آخرين، وعندما رفضت حكومة إسحق رابين، تم قتل الجندي، الأمر الذي أدى لإبعاد أربعمائة وخمسة عشر شخصًا من حركة المقاومة الإسلامية (حماس، والجهاد الإسلامي)، إلى جنوب لبنان، منطقة (مرج الزهور)، بمساعدة جيش لبنان الجنوبي، ومن بينهم أخوه حسن، أما ابراهيم فنجا من الاعتقال والإبعاد لوجوده خارج الدار وقت المداهمة.
من هنا يمكن الإشارة، إلى أن تصاعد موجة المقاومة ضد الاحتلال، التي قادها التيار الإسلامي عامة، وكتائب القسام خاصة، أسقطت المآخذ الموجهة ضدهم، لجهة عدم المشاركة في مقاومة الاحتلال. غير أنها أصبحت "تُهمة" ضدهم، كونها تُعرقل مسار المفاوضات مع الاحتلال. فكيف واجهت الانتفاضة هذه الوضعية المُستجدة؟ هل ولّدت ازمة؟ أم كانت عابرة؟ وكيف رد الاحتلال على تصاعد عمليات المقاومة؟
الانتفاضة وأزمتها
يستعرض الكتاب، موضوع المراجعة، مسارات الانتفاضة الفلسطينية، ويُشير إلى أحداث مثيرة في مسيرتها، وإلى التعارض بين الفصائل حول آفاقها. فمن الملاحظ أن التيار الإسلامي كان مُقتنعًا بضرورة مواكبة الانتفاضة الشعبية، بالعمليات الفدائية على أنواعها. من هنا كان التركيز بالنسبة إليهم، ينصب على تأمين السلاح والذخيرة، حيث لا يستطيع هؤلاء الشبان توفير الحد المطلوب لتصعيد العمليات، وإذا تم الحصول على بندقية، فإنها تحتاج إلى ترميم وإصلاح، وإلى ذخيرة. وعليه، يسرد المؤلف العديد من الأخبار حول مسألة السلاح، وكيفية تأمينه، حتى لو اضطر البعض لبيع حُلي النساء. والأهم، أن هؤلاء الشبان بحاجة للتعلم على كيفية استخدام البندقية بصورة جيدة.
إنها مسيرة محفوفة بالمخاطر. لذلك كان التدريب يتم في الميدان مباشرة، لندرة الذخيرة، والسلاح. من هنا عمدوا إلى صناعة المتفجرات اليدوية، واستدراج قوات الاحتلال إلى مكان زرعها، لتحقيق الهدف منها. ورغم أن الانتفاضة شملت أرجاء الوطن، إلا أنه من الضروري الإشارة إلى أن الخليل في الانتفاضة تحولت جذريًا، عما كانت عليه قبل خمس وعشرين سنة، فغدت خليل الجهاد، والمقاومة، والاستشهاد.
رغم ذلك بدأت الأصوات تتعالى بوقف الانتفاضة. وهنا يُشير المؤلف، إلى أن الأزمة تمثلت في عدم وجود "مرجعية وطنية"، أو مرجعيات تنظيمية. لذلك فالقرارات كانت بأيدي مجموعات من الشبان المتحمسين في الغالب، دون أية رقابة من جهات عُليا مسؤولة، أو أية رقابة لها طابع قانوني، أو قضائي، أو حقوقي. وهذه ليست أزمة عابرة، أو طارئة للأسف، كونها ظاهرة لا تزال قائمة، ولأسباب متعددة، ولها خلفياتها، وأبعادها ومراميها. هل هذا يعني أن الإنتفاضة تُركت لعفوية الجماهير؟ وهل اتساع الإنتفاضة، وقوة تأثيرها كانت خارج أهداف محددة؟ عديدة جدًا التساؤلات حول هذه المسألة، لكن النتيجة كانت مؤلمة، مبدئيًا.
أوسلو والانتفاضة
جاء التفاوض بين ممثلي منظمة التحرير الفلسطينية و"إسرائيل"، في أوسلو، في خضم الانتفاضة الشعبية، فولدّت مسألة خلافية أساسية بين التيار الإسلامي، وحركة "فتح"، الأمر الذي ترك بصماته السلبية على الإنتفاضة، وعمّق مجالات الخلاف حولها. الاتجاه المؤيد للتفاوض مع "إسرائيل" يطمح لإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع. من هنا اعتبر، هذا الاتجاه، أن استمرار الإنتفاضة، لم يعد مُبررًا، لأن تصاعد عمليات المقاومة، والعمليات الاستشهادية داخل أراضي 1948، مُضر بالقضية الفلسطينية، ويُشّوه صورتها أمام الرأي العام العالمي متسائلًا عن هدف التيار الإسلامي من هذه الانتفاضة خاصة وأن موازين القوى غير متكافئة. لذلك كان التيار المؤيد لأوسلو، يعتقد بأن عمليات المقاومة، "تخريب لمسار السلام"، وضد مصالح الشعب العليا، وبأن العمليات الاستشهادية عمل "جنوني". من هنا شدّد هذا الاتجاه المؤيد للتفاوض على أن الاتفاق مرحلي، وغزة وأريحا البداية، وليس من مصلحة الشعب الفلسطيني أن يظهر وكأنه لا يلتزم، ولا يحترم الاتفاقات. خاصة وأن هناك شهود دوليين، ومن مصلحة الفلسطينيين كسب الاحترام والتعاطف الدولي.
بالمقابل، فإن الاتجاه المعارض كان على الطرف النقيض تمامًا. أي أن الاتجاهين كانا على خطين متناقضين، لا يوجد، للأسف، الحد الأدنى للتوافق عليه بينهما. حيث اعتبر الاتجاه المعارض، المفاوضات اعترافًا بـ"دولة إسرائيل"، وأن قيام الدولة الفلسطينية، المزعومة، هو تأكيد لهذا الاعتراف. وعليه، فإن فرض انسحاب "إسرائيل" من القطاع، والضفة الغربية، يكون من خلال استمرار العمليات العسكرية، وباستمرار الانتفاضة الشعبية يمكن إقامة دولة على أي شبر ينسحب منه الاحتلال. وخروج "إسرائيل" باتفاق يعني، التزام الفلسطينيين بالاعتراف بحق اليهود على أرضنا، أما خروجهم دون اتفاق، وتحت ضغط المقاومة، فيعني عدم الالتزام بأي تعهد، ومقدمة لاستمرار المقاومة. وعليه، فأوسلو "تفريط بالثوابت الوطنية"، وهو غير ملزم لمن لا يريد الالتزام به، خاصة وأنه لم يأتِ في سياق نقاش وطني، أو استفتاء وطني لذلك فالاتفاق يُلزم من وقع عليه، ومن لم يوقع لا يمكن إجباره أبدًأ، الأمر الذي يجعل المقاومة هي الحل، وهي الأساس.
انقسم الشارع الفلسطيني حول هذه المسألة، في المخيم في غزة، قامت مظاهرتان على رأسهما الأخوان (محمود المؤيد، وحسن المعارض) ممثلا هذين الاتجاهين. المؤيدون يهتفون: "غزة أريحا البداية... وفي القدس النهاية)، بينما المعارضون هتافهم: (أريحا فضيحة، طلعت الريحا). في مسارهما المتعاكسين، رشق المؤيدون دوريات الاحتلال بأغصان الزيتون، والمعارضون رشقوا الدوريات بالحجارة، وهتافهم (بالروح بالدم نفديك يا فلسطين)، فرد جنود الاحتلال بقنابل الغاز، والطلقات المطاطية، والبلاستيكية، وحدث بين المظاهرتين احتكاكات وصدامات خفيفة.
ساهمت عملية اجتياح الكويت في تقليص الإنتفاضة، لكن نتائج هذه الحرب، أعاد تفعيلها، وازدادت قناعة الناس بالاستمرار. لكن كان ينقصها السلاح والذخيرة، لذلك تحول الناشطون إلى السلاح الأبيض، من سكاكين، خناجر، بلطات، سيوف، إضافة إلى الهراوات.
في الحالات كافة، فإن غياب الحد الأدنى من التوافق بين المقاومين، باتجاهاتهم المتنوعة، قد يكون العامل الحاسم في تقليص الإنتفاضة. خاصة وأن بعض مفاعيل أوسلو السلبية، بدأت تتجسد من خلال استلام منظمة التحرير السلطة في القطاع والضفة. حيث اعتبر الاتجاه المؤيد لأوسلو أن هذه الخطوة نتيجة جهود المفاوض الفلسطيني، بينما المعارضون اعتبروها ثمرة لتصاعد العمليات الفدائية، مصرين على أن أوسلو هو المدخل الذي وفرته منظمة التحرير لـ"إسرائيل" للخروج من مأزقها، والسُلم الذي أنزلها عن الشجرة، التي كانت ستُلقي بنفسها عنها.
بالمقابل، فإن اغتيال إسحاق رابين، رئيس الوزراء "الإسرائيلي"، ترك تداعياته على مسار أوسلو. إضافة إلى أن فوز حزب "الليكود" في الانتخابات "الإسرائيلية"، ووصول نتنياهو لرئاسة الحكومة، جعل سلطة الاحتلال اليمينية، الرافضة في الأساس للاتفاق، ولفكرة الدولة الفلسطينية، جعل الالتفاف على الاتفاق، أسهل، وأسرع، بهدف ضربه وتفريغه من أي مضمون، وبدأ نتنياهو بافتعال التوتر مع السلطة الفلسطينية، ومحاصرتها، والقيام بأعمال استفزازية. وجاءت محاولته شق نفق تحت المسجد الأقصى، اللحظة التي ساهمت بتحسين ما للعلاقة بين السلطة الفلسطينية والمعارضين. لكن لم تُثمر هذه اللحظة عن نتائج، أو تؤسس لمسار إستراتيجي. فقد كان الاحتلال اكثر مقدرة على تنفيذ كل ما يريد، ونجح في تطويق الاتفاق والتهرب من تنفيذه.
السلطة بين المأزق والحل
استقبل الأهالي في قطاع غزة القادمين من الخارج بالترحاب، والفرح، وكانت لحظة لنسيان الخلافات السياسية والفكرية، ومن ليس له اقارب، تكفل الأهالي بتأمين حاجاتهم، مما جعل القادمين منبهرين لما يرونه من كرم، ومحبة، واحتضان. وقد كان مُفاجئًا أن من بين القادمين التوأمين " ماجد وخالد" أخوي يحيى. حيث وصل للعائلة قبل فترة، أن والدهم توفي في احداث أيلول في الأردن، وكان متزوجًا، ورزقه الله بولدين توأم، وبعد وفاة والدتهما، عادا مع القوات إلى غزة، وكانا في عِداد قوات السلطة.
بدأت السلطة تستلم زمام الأمور في القطاع. غير أن فرحة اللقاء، بالعائدين، لم تُعمّر طويلًا، الأمر الذي أحرج السلطة الفلسطينية، وهي لم تزل في بدايات عملها، وكان لسلطات الاحتلال الدور الأساس في تكبيل السلطة، وتشويه صورتها أمام ناسها. حيث رأى فيها المعارضون، وكأنها متممة لسلطة الاحتلال.
عمد الاحتلال إلى إطلاق سراح السجناء المُحتجزين من سنوات، بشكل محدود جدًا، وضمن سياسة التصنيف، للتفلت، والتهرب من اتفاق أوسلو، الأمر الذي أصاب الأهالي بخيبة أمل كبيرة، لأن من كل بيت فلسطيني، يوجد أسير، أو سجين. وجاء فوز نتنياهو ليُعرقل العملية السلمية مع منظمة التحرير، الأمر الذي عزّز مواقف المعارضين لاتفاق أوسلو، فتصاعدت حدة العمليات الفدائية، في إطار المواقف المعترضة في المبدأ على الاتفاق.
من هنا تم إعادة التذكير بالمخاوف من الاتفاق، خاصة لجهة الخشية من تحول السلطة إلى أداة لقمع المقاومة، وفرض القبول بالاتفاق. وهذا برأي المعارضون، نجاح لـ"إسرائيل" لجهة تفتيت الصف الفلسطيني بعد سنوات من الوحدة خلال الانتفاضة. إضافة إلى أن أوسلو قيّد السلطة بمسألة التعاون، والأمن، والتنسيق المشترك، والدوريات المشتركة، مع الاحتلال، ممّا سيفرض، برأي التيار المعارض، قواعد عمل ليست في مصلحة الفلسطينيين. لذلك، فإن المعارضين تساءلوا، لماذا الإصرار على مفاوضات "الحل الدائم" مع "إسرائيل"، وعدم التفاوض على تطبيق القرار (242). وهذا، برأيهم، يعني أن اليهود ضمنوا حدود "دولتهم" قبل 1967، والآن سيفاوضون على القدس الشريف. وبالتالي ضمنوا 75% من الأراضي التاريخية، وسيبدؤون "بمنازعتنا" على أراضي الضفة وقطاع غزة. وبالتالي، فإن "اليهود لا يمكن أن يعطونا شيئًا إلا وأحذيتنا على رقابهم، وبنادق المقاومة تحصدهم".
هذه الأجواء دفعت السلطة الفلسطينية إلى القيام بحملة اعتقالات واسعة جدًا، في صفوف المعارضة، وخاصة حركة "حماس"، فتوسعت حدة التوتر، الموجودة أصلًا، بين السلطة والمعارضة، وانعكست هذه الأجواء المتوترة على الأخوة في دار يحيى، لدرجة كادت الأمور تصل إلى حد العنف بينهم.
ضمن هذا المسار فُقدت الثقة بالسلطة الفلسطينية، وازدادت حركة الاحتجاج ضدها. وقد تكون هذه المسألة من أبرز الأسباب التي عززت موقع التيار الإسلامي، وخاصة حركة "حماس". أما على المستوى العالمي، فكانت الدول الداعمة لـ"إسرائيل" تستنكر عمليات المقاومة، وتُدافع عن "إسرائيل". وفي الحالات كافة كانت السلطة عاجزة، ولا تحمل من فلسطينيتها، إلا الاسم.
الخدمة في قوات الاحتلال
يستعرض الكتاب، وإن بشكل عابر، مسألة، كانت ولا زالت، مثيرة للجدل في البيئة الفلسطينية، تتثمل في خدمة غير اليهود، خاصة الدروز والبدو والشركس، في جيش الاحتلال. وكانت هذه المسألة في فترة الانتفاضة مطروحة على الفصائل الفلسطينية، كما أثارت في التيار الإسلامي نقاشات حول كيفية التعامل معها.
يلاحظ أن عددًا كبيرًا من الدروز التحقوا في جيش الاحتلال، من خلال حرس الحدود، أو الشرطة "الإسرائيلية"، أو مديرية السجون وكان بعض هؤلاء يقومون بأعمال عنفية، وتصرفات سيئة، سواء ضد المجاهدين، وخلال ممارساتهم لأعمال العسكرية، لدرجة تجاوز حدود الأدب مع النساء والصبايا، الأمر الذي ترك أجواء متوترة، وخلق نقمة، وولد مشاعر غضب تجاههم.
رغم ذلك، يُشير المؤلف، إلى أن المجاهدين، عمدوا إلى عدم استهدافهم بشكل مباشر، كونهم من الشعب العربي. أوجدت هذه الحالة ألمًا، وحسرة عند ابراهيم، كونهم من الدروز، واعتبرها دلالة على نجاح اليهود في تجنيد جزء من الشعب لحراستهم. بالمقابل، فإن الخدمة في جيش الاحتلال، لاقت موجة رفض، ومعارضة كبيرة في الوسط الدرزي. وتوسعت هذه الحملة الرافضة، باعتبارها معاكسة لتاريخهم، ولا يجوز العمل ضد أهل الأراضي المحتلة، التي هم جزء منها. النقاشات بين صفوف الفصائل الفلسطينية، حول هذه المسألة، في كيفية التعامل مع هؤلاء كان صعبًا جدًا. من هنا كان الاتجاه السائد، أن من يلبس زي جيش الاحتلال، ويحمل سلاحه، ويقوم بهمامه، لا يمكن أن يكون خارج الاستهداف.
وضعية البدو كانت أكثر تعقيدًا، لأن أئمة المساجد كانوا يرفضون الصلاة على جنود البدو القتلى في صفوف جيش الاحتلال، أو الدعاء لهم، أو تشييع جنازاتهم. والعديد من العائلات كانوا يرفضون لف التوابيت بـ"العلم الإسرائيلي"، أو إجراء جنازات عسكرية رسمية لهم.
في الحالات كافة، يبدو أن طرح هذه المسألة، جاء نتيجة لتمددها، ولما أنتجته في الوسط الفلسطيني من توتر. لكن بيئة هؤلاء الجنود، لم تكن، من حيث المبدأ، راضية، وهذا ما وسع مجالات الرفض لانخراط أبنائها في جيش الاحتلال.
ملاحظات أولية
إن المعطيات التي قدمها المؤلف، عن المرحلة التي أعقبت نكسة الخامس من حزيران 1967، تعكس الواقع بدقة متناهية. لذلك من الضروري جدًا، متابعة الكتاب من خلفيته السياسية، التاريخية، وليس من زاوية مدى الالتزام بأصول العمل الروائي ومستلزماته، ممّا يجعل المتابعة أكثر موضوعية، ودقة من جهة، ويُساعد بالمقابل على فهم، وتفسير ما تعرض له قطاع غزة لاحقًا في مسيرته النضالية من جهة ثانية.
انطلاقًا من هذا التصور، يمكن القول: إن اللحظة السياسية التي يعيشها أهالي قطاع غزة، اليوم بعد عملية طوفان الأقصى (7 تشرين الأول 2023)، وبطولات "كتائب عز الدين القسام"، و"الجهاد الإسلامي"، وفصائل المقاومة الأخرى، هي التعبير الواضح عن هذه المسيرة النضالية. من هنا نلاحظ، انطلاقًا من المعطيات التي يُقدمها الكتاب، إن البطولة الأسطورية التي نشاهد ملامحها اليوم، في القطاع، يصنعها من كانوا أطفالًا في المرحلة الماضية.
إن قوات الاحتلال، رغم كل الإجراءات الأمنية، والاعتداءات العسكرية، ومحاولات ضرب نسيج المجتمع، وتفكيكه، وقرارات منع التجول، وحملات الاعتقال، والمطاردة، والسجن، والتعذيب، وهدم البيوت، والقتل، الخ، لم تستطع أن تشل عزيمة الأهالي، أو تُضعف إرادة المقاومة، أو تُبعد الأهالي عن المقاومة الأمر الذي فرض على جيش الاحتلال الانسحاب من القطاع العام 2005. لكن بعد استلام حركة” حماس “السلطة عام 2007، فرض العدو حصارًا شاملًا على القطاع، وشن سلسلة من الحروب الوحشية، لعل من أبرزها، حرب العام 2008/2009، حرب 2014، حرب 2021، وصولًا إلى حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الجيش الصهيوني، ضد القطاع، بعد عملية طوفان الأقصى، بمساندة ودعم حلفائه "المتحضرين"، والمتخصصين في القتل والتدمير والتهجير والإبادة التي لا ترحم البشر ولا الحجر.
هذه الأجواء هي بالتأكيد أقسى وأعنف من المرحلة التي تحدث عنها يحيى السنوار، عندما كان طفلًا. لكنها تتقاطع معها لجهة، المواجهة والتصدي، وعدم الرضوخ ورفض الاستسلام، والتأكيد على الهوية الفلسطينية.
إن العدو الصهيوني وحلفاءه، قضوا على كل معنى للإنسانية، وكشفوا زيف الشعارات الرنانة التي تتشدق بها دول "العالم المتحضر"، المتحالفة مع الاحتلال. كما أن الجيش الصهيوني، وحلفاءه انتبهوا، جيدًا إلى ما يمكن أن يختزنه الأطفال، ولما يمكن أن يقوم به هؤلاء الأطفال لاحقًا، مثلما اختزن الطفل يحيى وزملاؤه فيما مضى، صور القهر والعذاب والإذلال والسجن، والقتل لهذا يعمد الجيش الصهيوني، وحلفاؤه "المتحضرين"، اليوم إلى إبادة الأطفال قصدًا، وبشكل مباشر، من خلال المجازر التي يشنها الطيران الصهيوني، وداعميه، متوهمين أن عمليات الإبادة يمكنها أن تمحو فلسطين من الذاكرة، أو تنزع المقاومة من نفوسهم.
بين الأمس الذي عاشه أطفال غزة، عندما كان يحيى السنوار طفلاً، وما يواجهه هؤلاء الأبطال اليوم بعد تخطي مرحلة الطفولة سيُبقي قضية فلسطين حية، ويجعل فكرة المقاومة أكثر رسوخًا في طريق التحرير والعودة. وبالتالي، إذا كانت سياسات العدو الصهيوني، وحلفائه، ضد فلسطين، أرضًا وشعبًا، مستمرة منذ ما قبل الاحتلال العام 1948، فإن الثابت والأكيد بالمقابل، أن أطفال فلسطين، ونموذجهم أطفال قطاع غزة اليوم، سيبقون، كما كانوا في المرحلة الماضية، أمل المستقبل وكُتّاب التاريخ.
وكما الأمس ما زال هناك اليوم من يوجه النقد للمقاومة، تحت ذرائع شتى، وكأن الأزمة بدأت في عملية ”طوفان الأقصى”، متعاميًا عن مسار قوات الاحتلال، والمجازر التي ارتكبها العدو الصهيوني وحلفائه وداعميه، في فلسطين، ولبنان قبل عملية” طوفان الأقصى”. ويبدو أن هؤلاء "الناقدين"، بغالبيتهم، أخطر من رواد ذلك المقهى في الخليل وأحاديثهم، عن عدم جدوى المقاومة، لأنهم، ببساطة متناهية، لا يريدوا أن يستوعبوا المستوى الذي وصلت إليه المقاومة في قطاع غزة، وجنوب لبنان، بشريًا، وتقنيًا، وعلميًا، وإداريًا، وتنظيميًا ولعلهم تفاجأوا، بأن ما عجزت عنه الجيوش العربية في الماضي، استطاعت المقاومة في قطاع غزة، وجنوب لبنان أن تحققه، سواء في المواجهة، أو الصمود، أو الرد، وأثبتت المقاومة أن الكيان الصهيوني، كان ولا زال، مرهونًا بحلفائه وداعميه. وبالتالي، فإن المقاومة فعل إيمان، لا يتزعزع، ولا يلين.