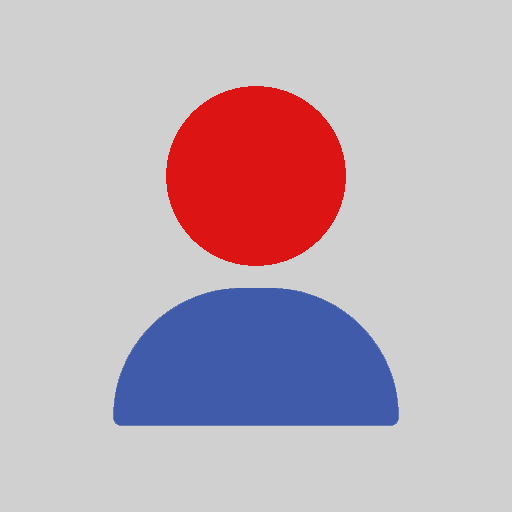مقالات

طلب أحد الأساتذة الجامعيين زيارة الشيخ نعيم قاسم في منزله المتواضع الكائن في بئر العبد في ثمانينيات القرن الماضي. لم تكن الزيارة بروتوكولية، ولا محفوفة بهالة موقع أو سلطة. تواصلتُ معه، فحدّد موعدًا بلا تكلّف، وتوجّهنا إليه كما يُقصد أهل العلم، لا أهل المناصب.
كان الأستاذ الجامعي يحمل سؤالًا دقيقًا حول واقعة تاريخية في جبل عامل، سؤالًا يُطرح عادةً على من يُظنّ أنّهم موسوعيون لا تفلت منهم التفاصيل. جلسنا، أصغى إلى السؤال باهتمام كامل، ثمّ جاء الجواب هادئًا ومباشرًا: لا أعرف. لم تُستدرَك الكلمة بتخمين، ولم تُخفَّف بتأويل، ولم يُملأ فراغها ببلاغة جاهزة. قيلت كما يقولها العلماء حين يضعون الحقيقة فوق الصورة.
عند خروجنا، عبّر الأستاذ الجامعي عن إعجابه بالرجل، لا لأنّه أجاب، بل لأنّه لم يدّعِ. في تلك اللحظة الصغيرة، انكشف الكثير: نحن أمام عقلٍ يرى في المعرفة أمانة، وفي الاعتراف بحدودها شجاعة، وفي الصمت حين يلزم قيمة لا نقصًا. من هذا المشهد البسيط يبدأ الحديث عن الشيخ نعيم قاسم، لا من موقعه، ولا من ألقابه، بل من صفته الأولى: رجل علم وأكاديمية وثقافة.
وكان الشيخ نعيم قاسم محلّ ثقة العلامة الراحل آية الله السيد محمد حسين فضل الله. ففي الفترات التي كان يغيب فيها السيد فضل الله عن المسجد، كان الشيخ نعيم قاسم يؤمّ المصلين، في مشهدٍ يعكس مكانته العلمية واحترامه في الوسط الديني والفكري آنذاك. ويُذكر أنّه في أحد تلك الأيام، حضر إلى المسجد محمد علي كلاي، بطل العالم في الملاكمة، وأدّى الصلاة خلف الشيخ نعيم.
ينتمي الشيخ نعيم قاسم إلى جيلٍ لم يتعامل مع الدين بوصفه خطاب تعبئة، بل باعتباره منظومة معرفة. تلقّى تكوينًا علميًا دقيقًا، وبدأ حياته المهنية أستاذًا لمادة الكيمياء، في دلالة نادرة على الجمع بين العقل العلمي الصارم والتكوين الديني والفكري. هذه الخلفية ليست تفصيلًا هامشيًا، بل مفتاح لفهم شخصيته وخطابه؛ فالعقل الذي تدرّب على المختبر، وعلى الدقّة والقياس والتحقّق، لا يميل إلى الانفعال ولا إلى القفز فوق المعطيات.
من هنا، لم تكن كتاباته لاحقًا ردود فعل على أحداث عابرة، بل نصوصًا تُبنى بمنهجية واضحة: تعريف، تأصيل، استدلال، ثمّ استنتاج. ولهذا، تجاوز عدد مؤلفاته ستةً وعشرين كتابًا توزّعت بين الفكر الديني، والفقه الاجتماعي، والسياسة، وقضايا المرأة، والمقاومة، والدولة. ليست كثرة الإنتاج هي اللافتة وحدها، بل طبيعته المرجعية؛ إذ تُقرأ كتبه خارج زمنها، وتبقى صالحة للنقاش حتّى مع من يختلفون معه جذريًا.
لم يأتِ الشيخ نعيم قاسم إلى العمل العام من باب الخطابة، بل من باب التعليم والتنظيم. انخرط في حركة أمل في مرحلة مفصلية من تاريخ العمل السياسي الشيعي في لبنان، وكان من كوادرها القيادية، واختبر السياسة من داخلها، لا من شرفاتها. هذا المسار، من القاعدة إلى القيادة، صقل نظرته الواقعية إلى العمل العام، وحرّره من الرومانسية السياسية التي تُغري كثيرين.
لاحقًا، كان من الجيل المؤسِّس لحزب الله، في لحظة تاريخية معقّدة، حيث لم تكن الأفكار مكتملة ولا البُنى جاهزة. شارك في بناء الفكرة قبل تثبيت التنظيم، وفي صياغة المنهج قبل تثبيت المواقع. وفي هذا السياق، أسّس جمعية التعليم الديني، التي خرّجت دفعاتٍ لم تتلقَّ معرفة فحسب، بل منهجًا في الفهم والمسؤولية، جامعًا بين الدين والعقل، وبين النص والواقع.
من هذا المسار التعليمي والفكري والتنظيمي، انتقل الشيخ نعيم قاسم إلى الموقع القيادي: نائبًا للأمين العام لسنوات طويلة، ثم أمينًا عامًا، في مرحلة يعرف الجميع ثقلها وتعقيدها. غير أنّ الانتقال إلى الموقع لم يكن قطيعة مع ما قبله، بل امتدادًا طبيعيًا له. بقيت لغته هي نفسها: هادئة، محسوبة، أقرب إلى قاعة درس منها إلى منصة مهرجان.
في حضوره الإعلامي، لا يبحث عن تصفيق، ولا يراهن على الإثارة. يشرح أكثر مما يهاجم، ويُقنع أكثر مما يستفز. وهذا تحديدًا ما يجعل حضوره ثقيلًا على من اعتاد السياسة كصوت مرتفع لا كمضمون. فالرجل لا يتكلّم عبثًا، ولا يطلق موقفًا قبل أن يخضعه لامتحان العقل.
في كتاباته عن المقاومة، لا تظهر بوصفها نزوة عنف أو حالة غضب، بل مشروع كرامة وسيادة مرتبط بالسياق والتاريخ والقدرة والمسؤولية. هي فعل دفاعي أخلاقي قبل أن تكون مواجهة عسكرية، وموقف سيادي قبل أن تكون أداة صراع. لذلك، ظلّ خطابه بعيدًا عن المبالغة، وعن تحويل المقاومة إلى أسطورة تُعفي أصحابها من النقد والمساءلة.
أما الدولة، فلا تحضر في نصوصه ككلمة مطلقة تُستدعى عند الحاجة، بل كبنية واجبات وحقوق، وكإطار ناظم لا يُبنى بالهتاف بل بالمحاسبة. يكتب عنها من موقع من يعرف تعقيداتها، لا من موقع من يستخدمها غطاءً أو خصمًا دائمًا. ولهذا، حافظ على فصل واضح بين نقد الأداء والطعن في الفكرة نفسها.
في ملف المرأة، قدّم الشيخ نعيم قاسم واحدة من أكثر قراءاته هدوءًا وجرأة في آن. لم يكتب بعقل الوصيّ، ولا بمنطق الدفاع الاعتذاري، بل بعقل الشريك. قدّم قراءة إسلامية تُعيد للمرأة إنسانيتها ودورها وحقها الكامل في المشاركة، بعيدًا عن الخطاب المتخشّب الذي يُسيء إلى النص باسم حمايته، ويُسيء إلى المجتمع باسم التقاليد.
هذه المقاربة ليست تفصيلًا ثانويًا، بل جزء من منهجه العام: ربط القيم بالواقع، من دون تفريغ القيم من معناها، ولا تحميل الواقع ما لا يحتمل.
في زمن المنصّات السريعة، قد يبدو هذا النمط من الحضور باهتًا. لكنّه في الحقيقة أحد أكثر أنماط التأثير عمقًا. فالرجل لا يراكم حضوره في لحظة، بل في الذاكرة. ولا يترك أثره في العناوين، بل في طريقة التفكير. لا يقيس نفسه بعدد المتابعين، ولا بعدد مرات الظهور، بل بمدى تماسك الفكرة حين تُختبر في أصعب اللحظات.
ولهذا، فإن محاولة اختزال الشيخ نعيم قاسم في سؤال “الكاريزما” ليست سوى هروب من الجوهر. بهذا المعنى، لا يمكن قراءة الشيخ نعيم قاسم خارج مساره التراكمي ولا خارج لحظته الأصعب. فهو من الجيل المؤسِّس لحزب الله، ومن رجال التعليم قبل أن يكون من رجال السياسة، ومن الذين صعدوا من القاعة الصفّية إلى قاعة القرار دون أن يبدّلوا منطقهم أو لغتهم. بدأ أستاذًا لمادة الكيمياء، وتدرّج في العمل العام من صفوف قادة حركة أمل، إلى حزب الله، وأسّس جمعية التعليم الديني وخرّج أجيالًا، ثمّ انتقل إلى الموقع القيادي نائبًا للأمين العام وصولًا إلى الأمانة العامة.
غير أنّ المعنى الأعمق لهذا المسار تجلّى في اللحظة التي كانت فيها الكلفة أعلى من أي وقت مضى. بعد استشهاد أمينين عامّين للحزب، وفي واحدة من أشدّ المراحل حراجة وصعوبة، راهن العدوّ على الفراغ والانكفاء والارتباك. لكنّ الشيخ نعيم قاسم لم ينكفئ، ولم يتردّد، بل تصدّى لأثقل مسؤولية في توقيت بالغ القسوة، وحمل الموقع بوصفه تكليفًا لا درعًا.
في تلك المرحلة، خاض معركة "أولي البأس" بعقل القائد لا بانفعال اللحظة، وأدار المواجهة مع العدو الصهيوني بثبات ووعي، جامعًا بين الصبر وحسن التقدير، إلى أن أُجبر العدوّ على طلب وقف إطلاق النار. هنا تجلت القيادة في القدرة على الصمود تحت النار، وعلى تحويل أخطر الظروف إلى نقطة ارتكاز لا إلى نقطة انهيار.
في كلّ هذه المراحل، بقي شيء واحد ثابتًا: الإيمان بأن المعرفة مسؤولية، وأن الموقع أمانة، وأن القيادة الحقيقية تُقاس بالثبات حين تضيق الخيارات. لذلك، لا يُفهم الشيخ نعيم قاسم إلا من خلال مسارٍ طويلٍ من التعلّم والبناء وتحمل الكلفة.
وفي زمنٍ تُكافئ فيه السياسة الضجيج، يصرّ هذا النموذج على السير بعكس التيار. لا لأنّه أضعف، بل لأنّه أكثر يقينًا. يقين من يعرف أنّ من يبقى في النهاية من يثبت أكثر، ويحمل الفكرة بوزنها الكامل في اللحظة التي كان فيها الوزن أثقل ما يكون.