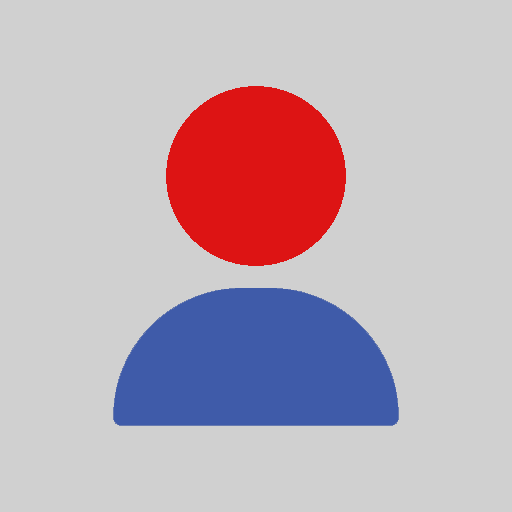خاص العهد

لم يكن خبر رحيل الفنان زياد الرحباني مجرّد حدث ثقافي أو فني، بل بدا كأنّ الوطن نفسه قد خسر أحد أصدق أنفاسه. صوتٌ طالما عبّر عن تناقضاتنا، وهمومنا، وسخريتنا الحزينة من واقعٍ لا يتغيّر. زياد، الذي لم يحمل يومًا بطاقة حزبية ولا شعارًا سياسيًا، حمل الوطن بصوته، بموسيقاه، بكلمته ووجعه.
كنت أعمل على مشروع تخرّجي في جامعة المعارف بعنوان: "مش سهل تكون لبناني". وكلّما حاولت اختصار هذا البلد بجملة، عجزت اللغة عن اللحاق بالمعنى. لم أجد تعبيرًا يليق إلا حين قررت اللجوء إلى صوت زياد. لم أطلب منه فكرة أو لحنًا، بل نبرة تشبهنا، تحكي مثلنا، وتوجع كما نتوجّع.
في أواخر نيسان/أبريل 2025، اتّصلت به، مكالمة قصيرة، أقل من دقيقة، قالها بوضوح: "هيدا إلك، دخّلو على كيفك بالبحث". أغلقت الخط بعد تلبيته لطلبي، وأنا أشعر أني سمعت البلد يتنهّد، أنفاسًا متعبة، حزينة لكنها صادقة.
ليس كل من وُلِد هنا صار لبنانيًّا
في هذه العبارة، تُختصر فلسفة زياد عن الهوية. فلبنان ليس جنسية مكتوبة في جواز سفر، ولا إقامة طويلة في حيّ شعبيّ أو برج فاخر. لبنان، بالنسبة لزياد، تجربة. هوية تُبنى في ظلّ الأزمات، في الصبر على التناقضات، في تحمّل العيش في بلد لا يشبه شيئًا، ومع ذلك لا نستطيع مغادرته بسلام.
اللبناني، كما رآه زياد، هو مَن عاش مرارة هذا الوطن دون أن يبيعه، هو من سكنه الوطن رغم الخذلان، هو من بكى على البلاد، ولكنه ضحك فيها أيضًا، رغم الألم.
الهوية بالتجربة لا بالتلقين
رفض زياد الرحباني أن تُختزل الهوية الوطنية في معايير جاهزة، ولم يُعجبه خطاب التنظير، ولا الشعارات الفارغة. فالهوية بالنسبة له ليست "منَحًا" تمنحها الدولة، بل هي "وجع" يُعاش على مراحل: من انقطاع الكهرباء إلى طوابير البنزين، من الطائفية الملبّسة بالدين، إلى النكتة التي نضحك فيها على أنفسنا.
اللبناني الحقيقي، عند زياد، هو من تأقلم مع العبث ولم يساوم عليه، من عاش الصدمة وبقي، من عرف أن هذا البلد يخذل أبناءه، لكنه أيضًا يمنحهم ما لا يمنحه أي وطن... شيء من الكرامة المغلّفة بالحسرة.
لم يكن زياد فنانًا من النوع العابر، بل كان ظاهرة، كان الوجه الآخر للحقيقة التي لا يُقال عنها "جميلة" ولا "بشعة"، بل "حقيقية"، وبهذه الحقيقة كتب، ولحّن، وسخر، وأحبّ، وعاتب، ثم صمت.. ومضى.