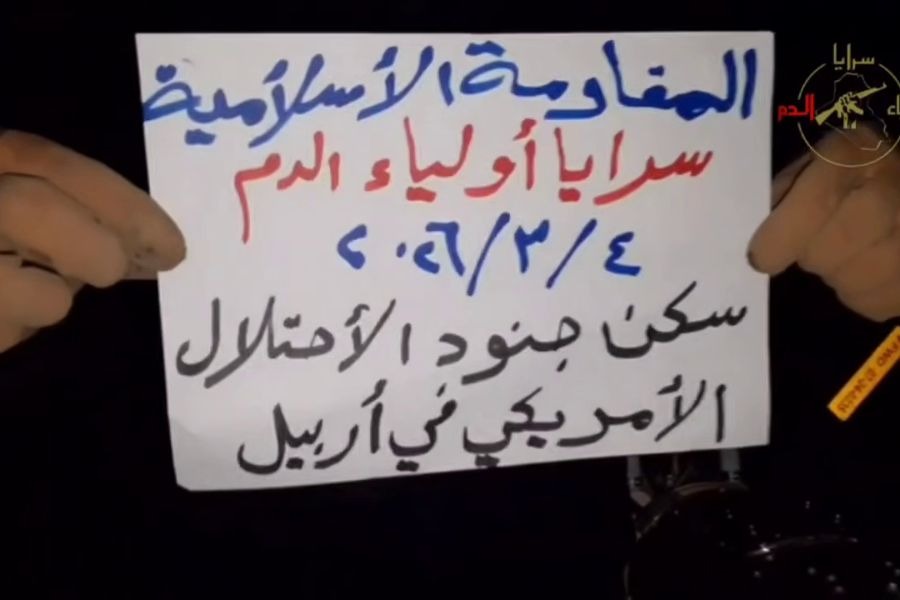مقالات

كاتب صحفي فلسطيني
بكالوريوس في الصحافة والإعلام
دكتوراه في الحقوق
منذ عقود، ذهبت أنظمة عربية ونخب متحالفة معها إلى خيار خطير: إعادة توصيف الصراع العربي ــ الصهيوني من كونه قضية وجودية بين الأمة العربية والكيان "الإسرائيلي"، إلى كونه نزاعاً جغرافياً محدوداً بين "إسرائيل" والشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة. وبدل أن يُنظر إلى المقاومة الفلسطينية كجدار دفاع عن الأمة، وُصفت بأنها "حالة عبثية" و"تطرف" يزعزع الاستقرار، ويعرقل الاستثمار مع الكيان "الإسرائيلي الديمقراطي المحب للسلام".
هذه النقلة لم تكن بريئة؛ كانت تحوّلاً كارثياً من مفهوم الأمة والجماعة إلى مفهوم القُطْر والحدود الاستعمارية لـ"سايكس بيكو". هي في جوهرها هروب من المسؤولية التاريخية والقومية والدينية، وإلقاء العبء على الفلسطيني الأعزل، وتبرئة الاحتلال من دماء أبنائه.
الإبادة كاشفة للحقيقة
لكن بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، سقطت الأقنعة. لم تعد المعركة "تقليدية"، ولا الحرب مجرد نزاع حدود. الاحتلال "الإسرائيلي" تجاوز كل المعايير الأخلاقية والقانونية، وأعلن نفسه مشروعاً مفتوحاً للتطهير العرقي والإبادة الجماعية.
تقارير صحيفة "الغارديان" ومجلة "972 الإسرائيلية"، المستندة إلى بيانات عسكرية سرية، كشفت أن 83% من ضحايا العدوان على غزة هم من المدنيين. أي أن الهدف ليس "حماس" ولا "المقاومة"، بل البشر أنفسهم. ومع المجازر المتواصلة، دخلت "إسرائيل" مرحلة أكثر توحشاً: تجويع ممنهج للأطفال والنساء، حتى باتت مئات المنظمات الدولية والأممية تطالب بوقف سياسة التجويع التي فاقت قدرة العقل على التصور.
هذا المشهد المروّع لم يكن ليحدث لولا أن "إسرائيل" أمِنت العقوبة. هي تسير مطمئنة في ظل غياب المحاسبة الدولية، وفي ظل الغطاء الأميركي الذي شلّ مجلس الأمن والقانون الدولي.
مشروع "إسرائيل الكبرى"… من الشعار إلى التنفيذ
منذ 1948، و"إسرائيل" قائمة على التهجير والتدمير: ثلثا الشعب الفلسطيني طُردوا من أرضهم، وأكثر من 500 قرية وبلدة دُمّرت. لكن اليوم، المشهد أخطر: لم يعد خطاب "إسرائيل الكبرى" شعاراً دينياً متطرفاً؛ بل صار مشروعاً سياسياً وعسكرياً معلناً.
بنيامين نتنياهو نفسه تحدث عن أنه موكَل بـ"مهمة روحية تاريخية لتأسيس إسرائيل الكبرى" الممتدة من النيل إلى الفرات. المشروع لا يتوقف عند فلسطين، بل يشمل اقتطاع أراضٍ من مصر (سيناء)، وكل الأردن، ونصف سورية وكل لبنان، ونصف السعودية، وربع العراق، وكل الكويت.
في غزة، تعمل "إسرائيل" على التهجير والإبادة. في الضفة، تُزرع المستوطنات وتُخلق بيئة طاردة للسكان. في لبنان، جرى إفراغ الجنوب وتدمير قرى ومنع إعادة الإعمار، مع التمركز في خمس نقاط عسكرية قد تتحول إلى احتلال كامل جنوب الليطاني. في سورية، هناك تمدد في القنيطرة وسفوح جبل الشيخ، وتدخل مباشر لإنشاء كيان درزي في السويداء كنقطة ارتكاز للسيطرة على جنوب سورية وصولاً إلى دمشق. أما في الأردن، فالأمر ليس بعيداً: تصريحات سموتريتش العلنية باعتبار الأردن "جزءاً من أرض إسرائيل"، والحديث عن جبل نيبو ومادبا، كلها إشارات إلى أطماع مباشرة.
فشل سياسة الاسترضاء والتطبيع
العرب أنفقوا عقوداً في سياسة "سحب الذرائع" من "إسرائيل": عدم استفزازها، السكوت على جرائمها، بل التطبيع معها والتعاون الأمني والاقتصادي. النتيجة: لم تُردع "إسرائيل"، بل ازداد جشعها.
ما نراه اليوم برهان قاطع: التطبيع لم يحمِ أحداً، بل شجع نتنياهو على المضي في مشروعه الاستعماري. "إسرائيل" تقرأ كل صمت عربي على أنه ضوء أخضر، وكل خطوة تطبيع على أنها إقرار بشرعية التوسع.
غزة جدار الأمة الأخير
رغم كل شيء، لا تزال هناك حقيقة دامغة: صمود الشعب الفلسطيني هو الذي كبّل شهوة "إسرائيل" التوسعية لعقود. غزة منعت الأطماع في سيناء، والضفة حالت دون التمدد في الأردن، وحزب الله أوقف الاحتلال جنوب لبنان. واليوم، حين تضيق "إسرائيل" الخناق على غزة والمقاومة، تنفتح شهيتها فوراً على التوسع في لبنان وسورية، بل على أبعد من ذلك.
من هنا، فإن دعم صمود غزة وتثبيت الفلسطينيين في أرضهم ليس شأناً إنسانياً فقط، بل هو ركيزة للأمن القومي العربي.
ماذا على العرب أن يفعلوا؟
التجارب كلها تؤكد أن التعويل على واشنطن أو مجلس الأمن عبث. الولايات المتحدة عرقلت محكمة العدل الدولية، وعاقبت المحكمة الجنائية الدولية؛ لأنها تجرأت على إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو. العالم متواطئ.
الحل: الاعتماد على الذات. الدول العربية تملك أوراق ضغط هائلة: سياسية واقتصادية وأمنية. تستطيع أن ترفع البطاقة الصفراء والحمراء في وجه "إسرائيل"، وأن تدفعها أثماناً بلغة المصالح التي تفهمها.
الصمت والهروب لن يحميا أحداً. الردع وحده يردع. المبادرة أفضل من انتظار الكارثة. وإلا، فإن المنطقة مقبلة على سيناريوهات مظلمة، حيث تُرسم خرائط الشرق الأوسط وفق معايير "إسرائيلية–أميركية–أيديولوجية"، والجسد العربي هو الضحية.