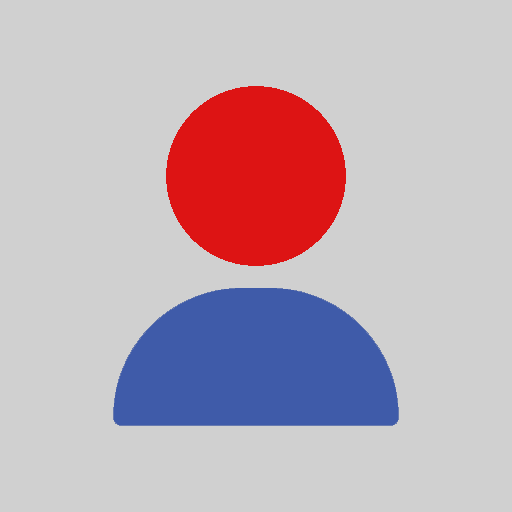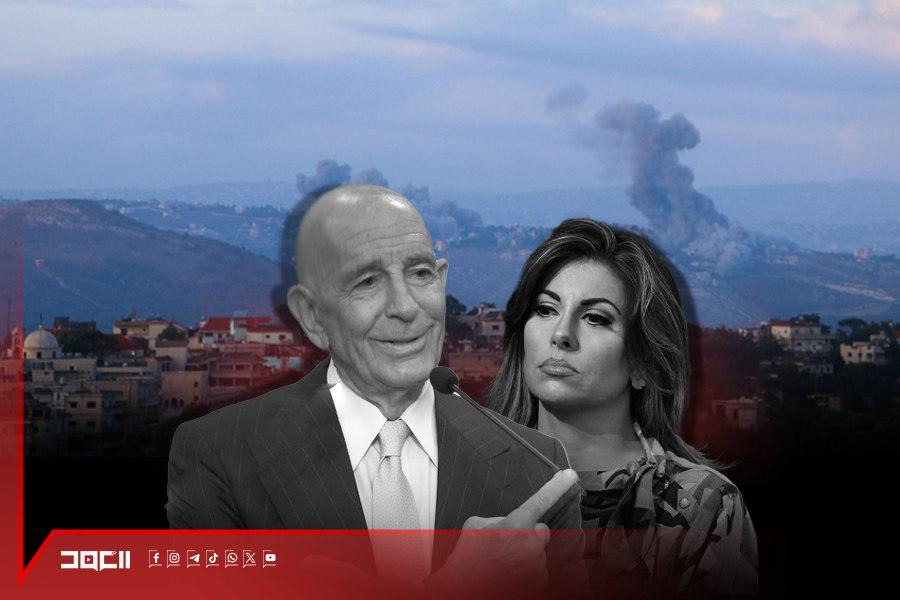نقاط على الحروف

كاتبة صحفية، عضو في الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين / ماجستر في العلاقات الدولية من جامعة LAU
يعدّ الخلاف القائم بين مصر وإثيوبيا واحدًا من أبرز وأخطر النزاعات الجيوسياسية في إفريقيا والعالم العربي خلال العقود الماضية. صحيح أن أزمة سد النهضة ظهرت إلى السطح مع بدء الربيع "العربي" في العام 2011، لكن التحضير لها تعود جذوره إلى خمسينيات القرن الماضي، مما يجعلنا نطرح أسئلة كثيرة حول الأصابع التي تلعب بأمن المنطقة المائي وبالتالي الأمن الغذائي والجيو - إستراتيجي. فالأمر لا يتعلق فقط بحصص مائية هي من حق مصر بموجب المعاهدات الموقعة، إنما هو إلهاء لمصر وجرها في نزاعات أكبر ينخرط بها الجيش المصري، الجيش العربي الوحيد الذي يرغب الكيان الصهيوني بمساعدة أميركا والغرب بإضعافه.
رأت القاهرة في إعلان مشروع سدّ النهضة الكبير عام 2011، تهديدًا وجوديًا لأمنها المائي، فالنيل شريان الحياة المصرية منذ آلاف السنين. صحيح أن أديس أبابا قدّمت المشروع كرمز للسيادة الوطنية والتنمية الاقتصادية المستقلة. غير أنّ القراءة التحليلية العميقة تُظهر أن الخلاف لم يكن تقنيًا أو قانونيًا وإنما يرتبط ارتباطًا وثيقًا بشبكة من التحالفات والمصالح الإقليمية والدولية التي تعمل على إعادة صياغة التوازنات. إنه تجلٍّ لصراعٍ جيوسياسي عميق يتعلّق بإعادة توزيع النفوذ والهيمنة في "الشرق الأوسط" وإفريقيا، يتجاوز حدود المياه والتنمية إلى رهانات الأمن الإقليمي وإستراتيجيات القوى الدولية.
عقيدة الأطراف وسد النهضة
منذ خمسينيات القرن العشرين، سعت "تل أبيب" إلى بناء تحالفات مع دول منابع النيل، خاصة إثيوبيا، لتطويق مصر من الخاصرة المائية، وقدّمت لإثيوبيا دعمًا تقنيًا واستشاريًا في مجالات السدود والريّ والطاقة، في إطار رؤية تجعل المياه أداة نفوذ وضغط سياسي على الدول العربية. بهذا المعنى، لم يعد سدّ النهضة مشروعًا إثيوبيًا خالصًا، بل ورقة إقليمية تتقاطع فيها مصالح "تل أبيب" وواشنطن مع طموحات أديس أبابا، لإعادة هندسة موازين القوّة في المنطقة، وتحويل النيل إلى أداة "جيوسياسية" تعكس تطوّر الصراع من السيطرة على الأرض إلى التحكّم بمصادر الحياة نفسها، بحيث يصبح الماء وسيلة لإعادة تعريف الحدود والسيادة، فيوظَّف الخلاف المصري - الإثيوبي ضمن مشروعٍ أوسع يهدف إلى إعادة رسم الخريطة المائية والسياسية لـ"الشرق الأوسط" بما يخدم "إسرائيل الكبرى". فهو ركيزة "جيوسياسية" في منظومة أوسع من المشاريع "الإسرائيلية" - الأميركية التي تسعى إلى إعادة هندسة الخريطة المائية والطاقوية في "الشرق الأوسط" وإفريقيا، بما يخدم مصالح القوى الصاعدة في النظام الإقليمي الجديد.
عقيدة الأطراف
تبنت النخب الصهيونية والأميركية التصور "الجيوسياسي" القائم على فرضية أنّ أمن "إسرائيل" لا يتحقق داخل حدودها الضيقة، بل عبر امتداد نفوذها الاقتصادي والأمني إلى محيطها العربي والإفريقي، لا سيما إلى منابع المياه في إفريقيا والبحر الأحمر. وسعت "تل أبيب"، عبر تحالفاتها مع إثيوبيا وكينيا وأوغندا، إلى خلق طوق إستراتيجي حول مصر والسودان، يُمكّنها من التأثير في توازنات نهر النيل، وبالتالي بالقرار المائي والسياسي العربي. وقد جاء ذلك ضمن ما سمي بـ "عقيدة الأطراف، أو "نظرية الأطراف" لـ"بن غوريون"، أول رئيس وزراء للكيان، وقالها في عدة اجتماعات لـ"الكنيست" إن: " أمن "إسرائيل" لا يمكن أن يتحقق ضمن حدودها الجغرافية الضيقة، بل يجب أن يمتد نحو تحالفات مع دول غير عربية محيطة بالعالم العربي مثل تركيا، إيران (قبل الثورة)، وإثيوبيا، لتطويق الدول العربية من الخارج". وكتب في مذكراته "سياسة "إسرائيل" الخارجية: البحث عن الأمن": "لا يمكن لأمن "إسرائيل" أن يعتمد على قوتها الداخلية أو حدودها فقط؛ بقاؤنا يعتمد على تحالفات تتجاوزه"، وهو الأساس النظري لفكرة "الأمن خارج الحدود".
الدور الأميركي
المشروع ابتدأ بين العامين 1956 - 1964، إذ أجرت الولايات المتحدة عبر "مكتب استصلاح الأراضي الأميركي"، دراسات حول إمكانية بناء سدود على النيل الأزرق في إثيوبيا، أحد أهم روافد النيل. تم ذلك خلال فترة الحرب الباردة، والهدف إضعاف النفوذ المصري الناصري المتحالف مع الاتحاد السوفياتي. وقد كتب المؤرخ الصهيوني، حغّاي ايرليخ، في العام 2002، في كتابه " الصليب والنهر: إثيوبيا، مصر، والنيل": "أن الدراسات الأميركية جاءت في سياق إستراتيجي يهدف إلى الحد من نفوذ مصر الناصري في إفريقيا، وأن واشنطن استخدمت إثيوبيا كحليف مائي - إقليمي لموازنة الدور المصري المتصاعد".
تجذر العلاقة بين إثيوبيا والكيان
شبك الكيان العلاقة مع إثيوبيا في عهد الإمبرطور هيلا سيلاسي، الذي حكم حتّى أطاح به الجيش في العام 1974. "هيلا سيلاسي"، تعنى "قوة الثالوث المقدس"، ولقب أيضًا بملك الملوك وأسد قبيلة يهوذا والمختار من الله. وهي القاب لها علاقة وثيقة بالعهد القديم! أسس لإثيوبيا الحديثة ومن مؤسسي منظمة الوحدة الإفريقية. ومن أهم أدواره أنه حافظ على علاقة متوازنة مع الولايات المتحدة والكيان، ودعم الأخير منذ العام 1948، وسمح له باستخدام الأراضي الإثيوبية لأغراض استخباراتية وعسكرية في البحر الأحمر والقرن الإفريقي من أجل ترسيخ نفوذ إثيوبيا في حوض النيل، ضمن إستراتيجية "الهضبة العليا"، فبنى مع الكيان علاقات وثيقة في مجال الزراعة والأمن والمخابرات، ومهد للسياسات المائية اللاحقة وأهمها سد النهضة، وسمح بهجرة الآلاف من اليهود الفلاشا الإثيوبيين، إلى فلسطين المحتلة، أي العلاقة متجذرة مع الكيان.
لاحقًا، باتت هذه الإستراتيجية المرجع الفكري والسياسي لكل الحكومات الإثيوبية، من منغستو هيلا مريام إلى ميلس زيناوي. أحياها الأخير عبر مشروع "إحياء الأمة الإثيوبية"، من خلال إطلاق بناء سد النهضة عام 2011، مستغلًا ضعف مصر السياسي خلال "سني ربيعها". وترتكز الإستراتيجية على المياه والجبال وموقع إثيوبيا الجغرافي التي يمكن أن تكون أدوات قوة إقليمية وليست مجرد موارد طبيعية عبر تحويل الهضبة الإثيوبية إلى مركز تحكم في منابع النيل والقرن الإفريقي ونقل الثقل المائي من شمال النيل إلى إثيوبيا. فالقضية ليست فتح سد النهضة وإغراق السودان ومصر كما حدث في 30 من الشهر الماضي حين حدث الفيضان الكبير، أو تخزين كميات كبيرة من الماء على الرغم من شح المياه. ما تريده أديس ابابا هو إعلان سيطرتها من جديد. وهكذا نجح الكيان بالفعل في تطويق الماء العربي.
في الحقيقة، أن يتحقق التحكم في موارد المياه في مصر والسودان هو عنصر أساسي إستراتيجي في مفهوم "الأمن الصهيوني الشامل"، والأمر لا يقف عند هذا الحد، فإن لجوء مصر للتهديد العسكري في حال استمرت إثيوبيا بحبس مياه النيل مصدر الحياة، ودخول الجيش المصري في حرب مع إثيوبيا هو تبديد لقوته في المواجهة مع الصهاينة، وهو الجيش العربي الوحيد الذي تخشاه "إسرائيل". واليوم الجميع وللأسف يحاصر مصر، خاصة وأن المستثمرين في السد هم من مختلف الدول العربية الخليجية وإن كان في الاستثمارات الزراعية، وإثيوبيا تريد إنهاء اتفاقيات المياه 1929 و1939، وتريد استعادة موقعها كإمبراطورية، لقد كانت 2011، فعليًا بداية تشرذم القوّة العربية ونهايتها.