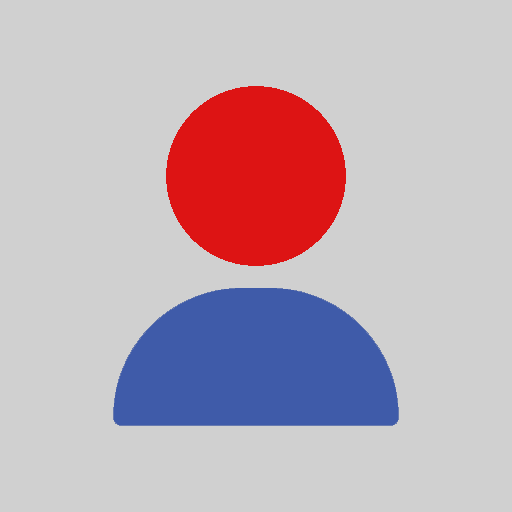مقالات

لم يكن العرض العسكري الذي شهدته بكين في الثالث من أيلول/سبتمبر، في الذكرى الثمانين لهزيمة اليابان، حدثًا احتفاليًا عابرًا. لقد بدا بمثابة بيان إستراتيجي للدول الحليفة مكتوب بلغة القوة، حيث يعكس عمق التركيبة الدولية وصراعاتها البنيوية بين قوى مهيمنة وقوى صاعدة. فعرض أحدث المنظومات الصينية، من الصواريخ الفرط صوتية والعابرة للقارات إلى القاذفات والمنصات البحرية، أمام نخبة مدعوّة بعناية يتقدمها فلاديمير بوتين وكيم جونغ أون ومسعود بزشكيان، لم يكن بريئًا ولا بروتوكوليًا، خاصةً أنها أتت منسقةً بعد قمة تيانجين التي استقبلت أعمال منظمة شنغهاي لتجمع بين القوة والاقتصاد، وهو ما أظهر أن التعددية القطبية لم تعد أطروحة نظرية، بل هي ممارسة تحاول بكين رسم أطرها وحدودها.
وجود الرئيس الصيني بين بوتين وكيم وإلى جانبهم الرئيس الإيراني، حمل دلالة رمزية لتقاطع مصالح أربع قوى تلتقي في أمرين أساسيين في هذا العرض وهو التضرر من الهيمنة الأميركية والسعي لمواجهتها كل بحسبه. هذا الالتقاء لم يعد مجرّد صورة عابرة، بل أصبح متجسدًا في تعاون آخذ في التوسّع: أمن سيبراني، تكنولوجيات مزدوجة الاستخدام، شراكات الطاقة، وتنسيق في سرديات حرب المعلومات، وهذا ما يتحدث عنه خبراء في الصحف الأميركية ويتخوف منه صقور الإدارة. لذلك لم يكن مفاجئًا أن تقرأ واشنطن العرض باعتباره موجّهًا ضدها؛ إذ علّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعبارات مباشرة يتّهم فيها بكين وموسكو وبيونغ يانغ بالتآمر على الولايات المتحدة، في إشارة إلى تآكل تدريجي في هامش التفوّق العسكري الأميركي وتنامي قدرة الخصوم على فرض كلفة ردعية معتبرة.
يمكن أن نقرأ أكثر ما تريده الصين من عرضها العسكري من خلال نظرية الردع كما صاغها توماس شيلينغ، حيث الردع ليس قدرة على التدمير فحسب، بل قدرة على الإقناع بأن الكلفة تفوق العائد. وما يعتبره أنه القدرة على استخدام القوة التهديدية أو القسرية كأداة تفاوضية لمنع خصم ما من القيام بفعل معين، من خلال التهديد بالعقاب أو الضرر إذا ما أقدم على هذا الفعل (Arms and Influence, THOMAS C. SCHELLING).
صحيح أن هذه النظرية جسدت في الحرب الباردة ذلك في التدمير المتبادل الذي صنع استقرارًا قلقًا إلى حين تفوق طرف على آخر. لكن الصين اليوم لا تعرض استعدادًا لحرب كبرى، بل تسعى إلى هندسة مسافة آمنة حول مصالحها الجوهرية كتايوان وخطوط الإمداد، وذلك عبر رفع كلفة التدخل الأميركي. وهذا ما أرادت أن تعكسه من خلال إظهار منصات قادرة على الوصول إلى قواعد أميركية أو إلى الأساطيل الأميركية في غرب الهادئ، ما يمكن أن يفهم بأن الردع لم يعد محصورًا بملف تايوان، بل بات ممتدًا إلى حدود جغرافية أوسع تطال الأمن الاقتصادي العالمي نفسه.
ولا يخفى أن هذا المسار في تحديد موازين القوى وهندسة المواجهة مع الولايات المتحدة الأميركية، بدأ بين الصين وموسكو تحديدًا من خلال وثيقة مبادئ للعلاقات الدولية أو ما عرف بـ"الإعلان المشترك بخصوص دخول العلاقات الدولية عهدًا جديدًا والتنمية المستدامة" في نيسان 2022، والتي تقوم على أربع ركائز: السيادة وعدم التدخل، رفض التحالفات الموجّهة ضد طرف ثالث، تعددية الأقطاب عبر توازن القوى، وتعميق التعاون الاقتصادي-التكنولوجي. هذه ليست نقاطًا خطابية فحسب، بل محاولة لصياغة إجماع على قواعد بديلة بالمعنى الذي طرحه هيدلي بول، نظام دولي يقوم على تفاهم الحد الأدنى بين القوى الكبرى بدلًا من هيمنة معيارية لطرف واحد. والهدف منه تقويض الشرعية الليبرالية التي تسمح بالتدخل باسم القيم، واستبدالها بشرعية سيادية، وذلك يكون عبر استقرار العلاقات الدولية من خلال اتفاقات تُشكل الحد الأدنى من القواعد والمبادئ التي تلتزم بها القوى الكبرى في سياستها الخارجية، مما يسمح بوجود نطاق من التنوع والاختلاف بدلًا من فرض معايير موحدة من قبل قوة واحدة.
وقد فهمت الرسائل القائمة على القوة والاقتصاد من خلال اجتماعات منظمة شنغهاي للتعاون التي عقدت قمتها في تيانجين عشية العرض العسكري، بحضور واسع من قوى الجنوب العالمي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والذي فهم أنه تلاقٍ صيني هندي في مواجهة اقتصادية مع واشنطن، بعد أن واجهت الهند رسومًا أميركية مرتفعة، يفتح هذا مسارًا براغماتيًا للتموضع بين واشنطن وبكين وموسكو بدلًا من الارتهان لقطب واحد. وهنا يمكن القول إن التعددية القطبية الناشئة لا تُقاس بالعتاد العسكري وحده، بل ببنية الاقتصاد السياسي وإعادة تموضع سلاسل التوريد، تسعير الطاقة خارج أطر الدولار، بروز بنوك إقليمية، وتنافس على معايير التقنية.
لقد تلقف الأميركيون الرسالة الصينية، وفهموا جيدًا أن هناك تحديات سوف يواجهونها، وقد قال ترامب تعليقًا على الحدث: "لقد فهمت سبب قيامهم بذلك، وكانوا يأملون أن أشاهد، وكنت أشاهد بالفعل". وفي السياق، علقت صحيفة وول ستريت جورنال أنه "إذا لم يتصرّف السيد ترامب بجدية، فإنه يضع الولايات المتحدة في موقف يمكن أن تخسر فيه حربًا نارية أمام تحالف يضم شي وبوتين وكيم". الفايننشال تايمز سلطت الضوء على رؤية لـ"نظام عالمي متعدد الأقطاب" مدفوعة بسيادة الدول وعدم تدخل الغرب، لكنها عبّرت عن التحفظ بأن هذا التصور قد يكون غطاءً لمحاولة الصين بناء نفوذ إقليمي بدلًا من نظام عالمي متجانس.
ولا شك أنّ تعزيز الردع من طرف يُستقبل كتهديد وجودي من الطرف الآخر، وهنا تبرز معضلة الأمن في أوضح صورها، حيث إن كل تعزيز صيني يُقابَل بتحديث وتسليح أميركي، فينشأ تسلّح متبادل تغذّيه المخاوف وسوء الفهم بقدر ما تغذّيه المصالح، ما سيؤدي إلى إعادة بناء شبكة تحالفات آسيوية وأطلسية.
الواقعية الهجومية عند جون ميرشايمر تفسّر التوتر الراهن بصفته صراعًا بنيويًا بين قوة مهيمنة وأخرى صاعدة تسعى لمنع اقتراب الخصم من محيطها الحيوي، حيث إن بكين تراهن على ردع متدرّج، وواشنطن على تطويق تحالفي-تكنولوجي، وبين الرهانين تكمن احتمالات سوء تقدير قد يحوّل حادثة تكتيكية إلى تصعيد غير مقصود. هنا يحضر ما يقوله غراهام أليسون في كتابه "حتمية الحرب"، بأن التحولات الكبرى في موازين القوى غالبًا ما انتهت بحروب، إلا إذا وُجدت ترتيبات انتقالية تُرضي الطرفين.
وبناءً على ذلك، يمكن القول إن ما جرى في بكين لا يُختزل بين نظريتين: إما الحرب أو السلم بين هذه القوى، بل يمكن أن يمثل تفاوضًا على المستقبل وشكل النظام الدولي. ويأتي في سياق ذلك استخدام القوة الصلبة عبر العروض العسكرية و"سباق التسلح" وبناء "التحالفات" كلغة لإيصال رسائل سياسية، حيث الرسالة التي كانت من هذا العرض أن الصين تعتبر أن عصر ما بعد الأحادية قد حلّ، فيما تراهن الولايات المتحدة على أن تفوّقها التكنولوجي والتحالفي لعرقلة أو احتواء الصعود الصيني، وعليه فإن بين هذين الموقفين من المتوقع أن لا تنزلق هذه القوى إلى تقدير خاطئ للعلاقة بينهما، وبالتالي العمل على صون ردع متبادل يولد الاستقرار دون السقوط في الهاوية. وهنا يبقى السؤال: هل ينجح النظام الدولي في بناء ترتيبات انتقالية تقلّل من مخاطر المواجهة؟ أم أن التحولات المتسارعة والشكوك المتبادلة ستدفع القوى الكبرى إلى اختبار القوة على نحو يخرج عن السيطرة؟